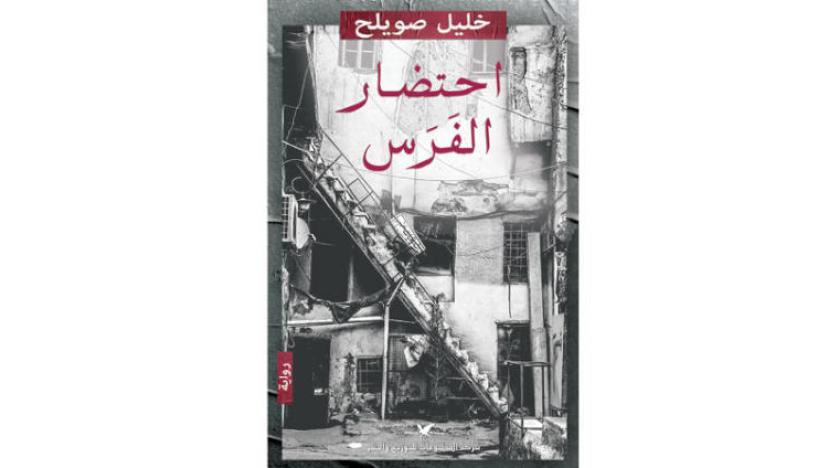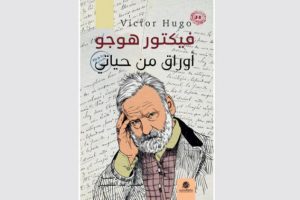عن «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر»، صدرت رواية «احتضار الفرس» للروائي السوري خليل صويلح. وهي رواية، كما كتب الناشر، «تقع ما بين بين؛ ما بين الموت والحياة، ما بين الواقع والحلم، ما بين أمس واليوم، ما بين العمران والخراب، ما بين شواهد القبور وقبور الشواهد، ما بين اليتم والحنين، ما بين جنازة الأم وجنازة الأمة، ما بين عزلة الـ(كوفيد) وعزلة الحرب… في مشاهد احتضارية لفرسٍ تحتضر بفعل مهندسي الجحيم.
الرواية سوداوية؛ ليست تلك السوداوية الكافكاوية؛ بل السوداوية الواقعية في الجحيم السوري الذي تخطى الخيال بمراحل، مبنية على لسان راوٍ واحد؛ راوٍ هش وهامشي يراقب الأحداث التي دمرته ودمرت بلاده من دون أن يشارك في ألعاب الحرب التي أفرزت أصناف كائنات جديدة وعاشت في إمبراطوريات مستحدثة من الملح، تذوب كل يوم لتأتي شبيهاتها مكانها.
وفي لعبته الروائية لم يكتف صويلح بالاحتضار؛ بل تعداه للاستحضار، فاستحضر كتاباً وشعراء من الوطن وعبر الحدود، حاور بعضهم واستنطق بعضهم، واقتبس نصوص بعضهم الآخر، فتراه يستحضر خوان رولفو من المكسيك ويرافقه في رحلة الباص إلى قريته، يجري حواراً مع أبي العلاء، مشيراً إلى قطع رأس تمثاله، يحلل جدارية محمود درويش، ويتناقش مع جورج أورويل ويرافق إحدى شخصياته الروائية، ويستعرض حيوات أخرى كحياة الشاعرة دعد حداد.
غاب نيتشه عن النص، لكن العود الأبدي حضر بقوة في استعادة الخطابات الكثيرة للانقلابات العسكرية المتتالية التي عصفت بسوريا والتي تتشابه كلماتها بل نتائجها!
نصٌ رفيع؛ مؤذٍ ومؤلم، صور (هشاشة الكائن الهامشيٍ في احتضاره واحتضار بلده)».
وكتب بدديع صبيح
كي ينال جميع الموتى نصيبهم العادل من الحداد
طمأنينة الراوي لم تتحقق بوصوله إلى دمشق، فبعد مشاهداته المديدة لهول الفاجعة التي حلَّت بالبلاد، عاوده سأم العزلة بأقصى درجات، خاصةً مع تفشي وباء كورونا.
يتتبع الروائي السوري خليل صويلح في روايته “احتضار الفرس” ذاكرة الموت والعزلة واللعنات، ليس على طريقة أعماله السابقة “جنة البرابرة” و”اختبار الندم” و”عزلة الحلزون”، إذ يتكئ هذه المرة على تسجيلية من نوع خاص، ترسم خرائط البلاد، وتضع يدها على جُرْح الأمكنة، في رحلة الآلام على مسار القبور المفتوحة، والجراح المنكوءة للبشر، وذلك ابتداءً من دمشق مكان إقامته، إلى مسقط رأسه في قرية الشمسانية بالحسكة، حيث قبر والدته التي ماتت من دون أن يراها منذ تسع سنوات، بسبب الحرب التي اشتعلت في البلاد مُمَزِّقة الخرائط، ومُبعثرةً التضاريس وأرواح البشر.
ورغم أنه يذكر في روايته هذه (الصادرة عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر- بيروت 2022) أنه “يشهق بصمت لفقدان أُمَّين لا أم واحدة”، والدته وسوريا، إلا أن شهقته الروائية كانت مُدوّيّة إلى حدٍّ بعيدٍ، إذ امتزج فيها أنينه الذاتي، كإنسان يعيش مرارة الغياب بأكثف أشكاله وأبلغِها، وكصحافي يكتب في عموده الأسبوعي عن عبثية الموت، وخراب البلاد، وتشظّي الهوية، ثم كروائي يجمع طبقات السرد والأصوات المكلومة ويجدلها بِرَوِيَّةٍ، مُحاولاً تفسير ما ينتاب الكائن الأعزل من ألم ورعب مَدِيدَيْن، وذلك بأسلوبية أشبه بـ”ضربة بلطة شاقولية تزعزع طمأنينة الراوي من جهة، ويقين الحكاية ومسالكها لتشقّ مجرى آخر للواقع، من جهة ثانية”.
سريالية الألم
تبدأ الرواية برسالة وصلت إلى بريده الإلكتروني على أمل نشرها في الصحيفة، ورغم نسيانه لها، إلا أنها ظلَّت تُلحّ عليه، لهول ما تحويه من مُخادَعة وخذلان، فكيف يمكن أن تصل جثة جندي برأس مقطوع ويدين يُسرتَين مبتورتين والمطلوب دفنها بتكتُّم شديد؟ شيءٌ من سريالية الألم بمَذاقٍ غير مفهوم، تتكثف شيئاً فشيئاً مع رحلة آلام الراوي إلى مسقط رأسه بطائرة “اليوشن” متهالكة، مُحمَّلة بجنودٍ ومرضى وحقائب وتوابيت، ثم زيارته لقبر والدته التي لا يحتفظ بصورة فوتوغرافية لها، إلا ما خزَّنته ذاكرته الخصبة منذ فطامه المُبكِّر، وحتى آخر اتصال له معها، وكأنه في سردياته عن شقائها وتفاصيل علاقته معها، يعيد وصل حبله السري بها إلى الأبد.
وبالطريقة ذاتها فإنه خلال عودته بالحافلة من الحسكة مروراً بتل تمر وتل أبيض وعين عيسى في ريف الرقة، ثم عين عرب ومنبج على الشريط الحدودي السوري التركي، عبوراً بمدينة حلب نحو دمشق، كان يوثِّق ذاكرة الألم للمناطق المدمَّرة التي مرَّ بها، ابتداءً من مخيم الهول شرق الحسكة الذي فرّت إليه نساء تنظيم داعش من الموصل والرقة والأنباء، إلى مقبرة الهوتة في أقصى ريف الرقة الشمالي، ثم عفرين التي استولى عليها الأتراك وهجروا سكانها من الأكراد لمصلحة غرباء احتلوا بيوت أهلها وشجر زيتونها، وحطموا التماثيل البازلتية والمنحوتات النادرة التي تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد، في مواقع النبي هورى، وبرج عبدالو، وتل جنديرس، ومعبد عيد دارة.
ثم منبج الواقعة بين شرقي الفرات وغربه، ما وضعها في مهب حرب شرسة بين كتائب متناحرة، وأيضاً معرة النعمان التي استفاقت في 12 شباط / فبريار 2013 على جريمة حز رأس الفيلسوف الأعمى باستعمال آلة قص حجارة، لتستعيد ذاكرة الراوي ما حل بتدمر بعدما غزاها الإرهابيون مضيفين “ش” الشام إلى اسم دولتهم، وكيف تم التنكيل بجثة عالم الآثار خالد الأسعد لأنه رفض تسليمهم مفاتيح الكنوز القديمة، وأيضاً ما تعرضت له معلولا عام 2013 من إضرام النيران في البيوت والكنائس والساحات، وخطف راهبات، وتهجير عائلات بأكملها، ثم القذائف التي كانت تُوجّه نحو مدينة صيدنايا المجاورة، من دون أن تتوقع أجراس الكنائس والأديرة عن قرع أجراسها تنبيهاً لخطر وشيك.
تصحيح خطأ الموت
تلك الاستعادة للمجازر والدمار والموت المجاني وازته استعارة “صويلح” لأصواتٍ مُساندة، يُدوْزِن انفعالاتها، جاعلاً منها جوقة تدعمه فيما أسمته دعد حداد “تصحيح خطأ الموت”، إذ يعود إلى جدارية محمود درويش، مُستلهِماً منها “كونشيرتو الأصوات” في مجابهة الموت الذي هزمَه في الحركة الرابعة، ويستعين بفاتح المدرس الذي حمل أشجار الزيتون من قريته كفر جنة في جبال عفرين إلى مرسمه في دمشق، وهناك كتب قبل مجيء البرابرة بأعوام “مرّ هولاكو من هنا، تبسّم ثم ولّى الأدبار”.
ويستند الراوي في ضيقه أيضاً على قصاصة ورق وُجِدَت في قميص فواز الساجر بعد وفاته كتب فيها: “تفكيرنا ضيق، مصيرنا ضيق، موتنا ضيق، قبرنا ضيق، افتحوا الأبواب والنوافذ، سيقتلنا الضيق، افتحوا الأرض والسماء سيقتلنا الضيق، افتحوا الكون، الضيق، الضيق، الضيق”. وبالتوازي يُقرؤنا ما قاله سان جون بيرس “ضيقة هي المراكب، ضيق سريرنا”، وإلى جانب ذلك يستذكر “صويلح” الشاعر حامد بدرخان صاحب “الزيتون يركض حافياً”، ورياض الصالح الحسين الذي كتب “نحن أبناؤك الطيبون الذين أكلنا خبزك وزيتونك وسياطك …. ولن نتركك تضيعين يا سورية”، ليكون الحضور الأبرز لخوان رولفو وروايته “بيدرو بارامو” التي يعود فيها إلى قريته “كومالا” تنفيذاً لوصية أمه بضرورة أن يسأل عن أبيه الذي لا يعرفه بمجرد موتها، ليكتشف بأنه يجول في قرية أشباح، وهو ما تطابق مع عودة الراوي إلى قريته الشمسانية.
طمأنينة الراوي لم تتحقق بوصوله إلى دمشق، فبعد مشاهداته المديدة لهول الفاجعة التي حلَّت بالبلاد، واستذكاراته الأدبية التي استدعتها لعنات الأيادي المبتورة، والرؤوس المقطوعة، والتَّمزُّق في كل شيء، عاوده سأم العزلة بأقصى درجات، خاصةً مع تفشي وباء كوفيد-19، ليبدأ صويلح بترويض عزلته بأصوات جديدة وصور مُغايرة، فها هي صديقته الفنانة التشكيلية “س” تهديه لوحة لبومة زرقاء مع لطخة سوداء على عينيها، ليكتشف بعد حين أنها تماهت مع ما كتبه الإيراني “صادق هدايت” في قصته “البومة العمياء” وانتحرت.
كافكا محليّ
ثم نتعرف على “دلال شاكر” بِطَرْقَاتها الخاصة على باب بيته، ومزهريتها الخزفية بياسمينها الذي يعبق في روح الراوي وذاكرته كلما مرّ طيفها، وهناك أيضاً المُصوِّر والمراسل الحربي جابر عرابي، جار الراوي الذي يتحدث عن حنينه للصور المغمورة بمحاليل التحميض، وعن ارتكاسات فن التصوير الضوئي، وعن ذاكرته الملعونة التي أتعبته، خاصةً عندما يتذكر كيف وثَّق إعدام 17 ضباطاً بتهمة التمرد على عقيدة الجيش وخروجهم عن مبادئ ثورة آذار/ مارس 1963، وبعد نكسة حزيران / يونيو 1967 كيف صوَّر إعدام ضابطين كان أحدهما من كلَّفه بالمهمة الأولى، وغير ذلك الكثير، ليموت “عرابي” وحيداً فيتحول الأستوديو الخاص به إلى بيت بغاء، تديره الأرملة “بينيلوب” المكلومة بزوجٍ مختطف اقتنعت بأنه لن يعود، فاضطرت إلى الغطس في “بانيو الرغبة والشهوات” بالشراكة مع جنرالات الحرب الجدد، ومعاركهم التي لا تنتهي.
وفي خضم هذه العشوائية تتناهب عزلة الراوي شخصيات أدبية أخرى من مثل جلجامش وأنكيدو، والشاعر المكسيكي أوكتافيو باث، والبرتغالي فرناندو بيسوا، والزير سالم، وجورج أورويل في روايته “”، فضلاً عن بيانات الانقلابات العسكرية في سوريا بين عامي 1949 و1966 التي كان يبثها الراديو، ليكتشف الراوي أن “هذا الحطام العمومي في الأجساد والأرواح، يحتاج إلى كافكا محليّ في تفسير عمق الهاوية” ليضيف: “ولكن ماذا سيفعل كافكا هنا، بصرف النظر عن هويته؟ سينصرف، على الأرجح، إلى كوابيسه المخترعة، إلى نفقه، إلى جحره، إلى قفصه، أمام الأهوال التي تصنعها مطحنة الموت، هذه المفرمة المفزعة التي لا تتوقف عن العمل ليلاً نهاراً بنوع من الفكاهة السوداء، على الأرجح، ستبدو سوداوية كافكا، مجرد تمرينات أولية في توثيق الكوابيس مقارنةً مع الوقائع المستجدة التي ابتكرها الموت في هذه الجغرافيا الملعونة”.
ولا يكتفِ “صويلح” بتصويره لجدارية الجحيم ومتحف الأنقاض، ولا توثيقه لوليمة الموت المتنقلة التي لم تتوقف يوماً عن تسديد الطعنات للجميع في هذه البلاد، بِطَيْشٍ غير مسبوق، بل إنه يضع كل ذلك على ظهر سرديات أشبه بِفَرَسِ، يعرف “كل الأسماء”، كما في رواية ساراماغو، ويسعى ما استطاع لأن يكون نزيهاً “حتى ينال كل الموتى نصيبهم العادل من الحداد”، وكأن صويلح في عمله الروائي هذا يُكرِّر ما قاله ت. س. إليوت من قصيدة “أربعاء الرماد”: “لأنني لا آمل في العودة ثانيةً/ دَعْ هذه الكلمات تَتَحمَّل/ تَبِعَةَ ما صُنِعَ، حتى لا يُصنَع ثانيةً/ وليكن حُكم القضاء غير شديدٍ علينا”.
وكتبت بديعة زيدان:
“كان أقصى ما حلم به الأب، ظهيرة ذلك اليوم من أيلول 2020، أن يصل جثمان ابنه كاملاً من إحدى جبهات القتال، وأن يدفنه على عجل. فمنذ يومين تبلّغ الخبر المؤسف بمكالمة هاتفية مشوشة، تمنّى ألا تخصه، وأن يكون الأمر مجرد تشابك خطوط. لكن توقعاته لم تُصِبْ على الإطلاق، فما أن انحدرت عربة الإسعاف نحو منزله أسفل تلة من أشجار الزيتون، حتى أدرك أن حادثة موت ابنه حقيقة دامغة.. أنزل جنديان التابوت من العربة، فيما تكفّل ضابط بتسوية الفجيعة عن طريق عبارات مشجعة، ثم استبدل بها تعليمات صارمة تقتضي منع فتح التابوت، تحت طائلة المسؤولية، وضرورة دفن جثمان الابن على الفور، فهو يعلم جيّداً أن كومة الأعضاء، التي جُمعت كيفما اتفق داخل التابوت، لا تحمل أي علامة تُرشد إلى سيارة عن كثب بأنه المجند حسن علي دياب، من سلاح المشاة، عدا الوثائق المرفقة التي وقّع عليها الأب بأصابع مرتجفة بأنه استلم جثمان ابنه وفق الأصول”.
يوهمنا الروائي السوري خليل صويلح في مدخل روايته “احتضار الفرس” هذا، بأن ما سبق هو محور حكايتها، إلا أنّ القارئ، وبعد صفحات عدّة، يدرك أنها محض قصة قصيرة أرسلها كاتبها للصحافي، الذي هو محور الرواية، ولا يحمل اسماً بعينه، على أمل نشرها في الجريدة.
ولكن الحدث المحوري في الرواية لا يخرج عن إطار القصة المرسلة، فالصحافي يتلقى رسالة من شقيقه في القرية بموت والدتهما، التي لم يرها منذ سنوات تسع، أي منذ “الزلزال السوري” في العام 2011، حيث يعيش في دمشق، بينما تعيش أسرته شرق البلاد.
وفي رحلته الداخلية ذهاباً بالطائرة من دمشق إلى القامشلي، ومنها إلى الحسكة فقريته “الشمسانية”، وإياباً برّاً في الحافلة، يتحدث عن سورية التي كانت ولم تعد، من خلال رصده لحكايات العابرين في رحلتَيه.. أولئك المكتوون بنار الحرب التي لا تزال مستعرة في البلاد، وحكايات الجغرافيات التي تستمر في الأنين منذ سنوات، كما الأماكن التي كانت فيما سبق على قيد الكثير من الحياة، في رصد لمآسي الحرب السورية، وكأنها سلسلة تقارير صحافية حكيت بأسلوب سردي، لم يخلُ من تماهٍ مع روايات عالمية بحكايات كتّابها وشخوصها، شكلت جزءاً من تكوينه الشخصي، وإسقاطاً رآه منطقياً على الواقع المُعاش غير المُعاش، علاوة على استحضاره أحداثاً وشخوصاً، بعضهم وثقهم التاريخ، وآخرون صنعهم الصحافي أو الروائي، الذي يبدو أنهما واحد، أو ربما.
تحدث في رحلة الذهاب عن السائق الكردي الذي تنسّم أخيراً “هواء الحريّة بالاستماع إلى الأغاني الكردية علناً، من دون أن يخشى اعتقاله والتنكيل به”، وعن “القرى الطينية المتناثرة، والتلال المحيطة بها، والكنائس المدمرة؛ إثر هجوم كتائب التنظيمات التكفيرية على القرى الأشورية وتحويلها إلى أنقاض”، هناك في المتعرج باتجاه “الحسكة”، وغيرها الكثير.
وأفردت الرواية مساحة للحديث عن مخيم “الهول” الذي “تدفق إليه آلاف اللاجئين من الرقة والموصل والأنبار”، خصوصاً نساء وأطفال قادة ومقاتلي “داعش”.. هؤلاء بلا “قيد نفوس”، أي بلا شهادات ميلاد أو وثائق تدلّ على هوياتهم.. هم القادمون من مختلف أنحاء العالم، ويقيمون في جغرافيا تعج بالعنف اليومي، وحالات الاختفاء، وسيادة “الرشاوى” كوسيلة للخروج من جحيمه، عبر إبرام عقود زواج وهمية، ففي المخيم “جهاديّون عالقون، ومطلوبون في بلادهم، ويخضعون لحراسة مشددة، وأطفال يتدربون على حمل السلاح في معسكرات سرية، وعقوبات صارمة لمن تجرّأ من النساء على خلع الزي الشرعي، أو حتى التفكير بوضع نظارة شمسية أثناء هبوب عواصف العُجاج”.
ويرصد الصحافي في “الشمسانية” أوضاع قريته بعد تسع سنوات على غيابه عنها، والتغيّرات التي لحقت بها جرّاء الحرب، خاصة أنها من القرى التي خضعت لسيطرة “داعش” في وقت سابق، عبر حكايات العابرين غير العابرين، ومنها أنه حين توجه لزيارة قبر والدته فور وصوله للقرية، شاهد أسرة تدفن ابنها مشوّه الجثة، فتذكر القصة التي وصلته عبر البريد الإلكتروني، بحيث كان جثمان الابن في القصة “دون رأس وبذراعين متطابقتين”، في إشارة إلى أن الحروب لا تساوي بين الجميع أو الغالبية العظمى في فرص الموت فحسب، بل تخلط حتى أعضاءهم، أو ما تبقى منها، في عودة لحالة التماهي آنفة الذكر، ومنها حكاية حلاق القرية، الذي عوقب بخمسين جلدة بعد أن حلق ذقن أحد سكان القرية، في وقت كانت فيه “دولة الخلافة” تمنع حلق اللحى، و”مطر الجدوع” والذي فقد ذاكرته؛ إثر فقدانه لـ”ثلاثة من أبنائه في يوم واحد بقصف للطيران الأميركي أثناء عملهم في حفر الخنادق بمحيط مركز الناحية، كما هجرته زوجته الثانية، بعد هروبها مع سائق شاحنة يعمل في شركة النفط، كان يتردد إلى القرية خارج ورديّات عمله”.
وفي رحلة العودة، يمر الصحافي على مدينة “تدمر”، حيث المدرج الأثري، ومعبد “بل”، وأعمدة الشارع الطويل وأقواسه، ووادي القبور والمدافن الملكية، مشيراً إلى أنه في العام 2015، تحديداً في 13 أيار، اقتحم رتل من عربات الدفع الرباعي تحمل رايات “تنظيم الدولة الإسلامية” ساحة المدرج الأثري، التي تحولت إلى مساحة لـ”إقامة الحدّ على الكفرة بقطع الرؤوس والأطراف”، متحدثاً عن عالم الآثار الثمانيني “خالد الأسعد”، وكان مديراً لمتاحف تدمر في الفترة ما بين 1963 و2003، ويعرف بحارس المدينة القديمة الذي رفض مغادرتها، ونجح في إنقاذ 400 تمثال وقطعة أثرية بعد سقوط المدينة، إلا أنهم اعتقلوا العالم الثمانيني وقطعوا رأسه، بعد أن رفض إخبارهم بمكان الكنوز الثمينة في المدينة، وهي قصة حدثت بالفعل، كما حادثة إعدام خمسة وعشرين جندياً في هذه الساحة.
في الحافلة المتجهة إلى دمشق الكثير من الحكايات، وفي المحطات التي تمّر بها حكايات أخرى، كما في “معلولة” التاريخية وحكاية سائق الحافلة الذي مهّد الطريق أمام “الجهاديّين” للسيطرة عليها، وما فعلوه بها وبأغلبية سكانها المسيحيّين، في رحلة الرصد المتواصلة من الحافلة خارجها وداخلها، التي فقدت قبل أن تصل إلى محطتها المفترضة في دمشق، ثلاثة من ركّابها، أحدهم اعتقل على حاجز عسكري، إضافة إلى الزوج الذي قرر الهبوط عند أول حاجز قادم برفقة زوجته أو جثمانها، لكونه لم يصدق أن مرضها أنهى حياتها في المقعد الأخير حيث كانا، وقبل وصولهما إلى المشفى.
وتحط الحافلة في دمشق، فيما لم يغادر الموت الجغرافيات ومن يعيشون مآسي الحرب السورية فيها، كما لم يغادره شبحه وهو يهمّ بكتابة عموده الأسبوعي، فيلجأ إلى ملحمة جلجامش كحائط يستند إليه، في حين كان اتكأ في سرده على حكايات لشعراء سوريين وعرب من بينهم محمود درويش و”جداريته” التي تلامس الموت أيضاً.
“في جداريته التي كانت بروفة أولى للغياب”، سيبني درويش “كونشيرتو، أصواتاً، محاوراً أوركسترا الموت في أربع حركات أساسية، تنتهي بهزيمة الموت في الحركة الأخيرة على وقع ناي وكمنجة”.. “كما سيحاور طرفة بن العبد، والمعرّي، ورينيه شار، في إيقاعات متفاوتة في العلو والهبوط، وفي الصخب والصمت”.
“من يدوزن الإيقاع اليوم، في غياب صاحبه؟ أقول لنفسي: هناك من عبث في مسودّات النوتة! ثم سأدعه وحيداً قبل موعده مع إدوارد سعيد في فترة الظهيرة من كل يوم، ليلعبا النرد معاً. انصتوا إلى عبارته الأخيرة: العزلة مصفاة لا مرآة”.. و”أنا أفكر برمية نرد بلاغية تغلق القوس على مقام الكارثة”.
الرواية الصادرة عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر في بيروت، حديثاً، تختصر حكاية سورية ووجعها المنثور في كل زاوية من خاصرتها الممتدة، عبر ومضات سردية تجعل من “سورية” عنواناً رديفاً لعنوانها “احتضار الفرس”، المفتوح على تأويلات عدّة، لا تخرج بمجملها من قبضة الموت الذي لا يزال ينثر غباره الأسود على بلاد كانت جغرافيّاتها عناوين للخضرة والماء والوجوه الحسنة.
احتضار فرس صويلح؛
ورّاق الحب ينعى زمان الحلم الأخضر…
في روايته الأحدث “احتضار الفرس” الصادرة عن دار المطبوعات في بيروت، يطلّ علينا الكاتب السوري القدير خليل صويلح بوجه منهك، وملامح مغايرة لما ألفته عيون القراء، علاوة على نبرات صوت بحّت في إثر وداعات لا تنتهي.
باختصار؛ لقد قرأت للتوّ أوراقًا مخضبة بدموع كاتبها، واستمعت إلى أنينه الذي لم يعد بالإمكان كتمانه.
ولا يمكن أن أستهل قراءتي الانطباعية عن هذا النص بما هو أفضل من قول الشاعر:
أرحل بعيداً في متاهات فكري… نشوانًا من السُكرِ
أتمايل يمينًا وشمالاً… أُمطر دموعًا… تتحول إلى أناشيد..
.
تتميز أعمال صويلح في العموم بتتبع مسارات ومصائر الأحلام المبتورة، والحكايات غير المكتملة، والشخوص الذين تسربت سنواتهم إبان ملاحقتهم للسراب؛ السراب بشتى أطيافه. لكن هذا النص يحمل نكهة خاصة، كأن ورّاق الحب قد استبدل الهوى بالأسى، وتحول من تأطير الأحلام وتطريز النهايات المبتورة فوق هوامش صفحاته، إلى تدوين سجلٍّ موازٍ لكل ما سقط من شرفات الأمل خلال السنوات الماضية، وكل ما تشوهت ملامحه في مرآة الذاكرة؛ شخوص، وأمكنة، وأفكار، وأوبئة، وحملات تأديب، وتواريخ، وشعارات.
لذلك -ربما- أميل إلى القول بأن رواية “احتضار الفرس” تعد بمثابة نقطة الذروة في أدب خليل صويلح.
الحكاية الظاهرة
تدور الحبكة الرئيسة للرواية حول رحلة الراوي إلى مسقط رأسه بغية وداع أمٍ فارقت الحياة قبل أن تمنحه الأقدار فرصة لقياها، يُعلن الراوي منذ البداية -وهو صحافيٌّ مهتم بالأدب ويكتب المقالات بغية تأمين قوت يومه- أن رحلته هذه تتناص مع أكثر من نصٍ عالميّ، يأتي في مقدمتها الغريب لألبير كامو، بيد أن النص الأكثر حضورًا وتأثيرًا على مخيلته في أثناء الرحلة من قبر مفتوح كدمشق، إلى قبر صغير يحوي ما تبقى من أمه (وأعني هنا مخيّلة الراوي وليس الكاتب)، كان “بيدرو بارامو” لخوان رولفو، وما حوته دفتيه من ثيمات العودة إلى الأصل، والحنين الجنيني إلى الأم/الأرض، وتمييز الخيط الشفّاف بين الحياة والموت.
في رحلته إلى مسقط رأسه، بينما يطير ذهابًا ويعود برًّا، تتشابه المشاهد وتتوحد الموجودات؛ جنود ومرضى وحقائب وتوابيت ومخيمات، تمثال المعرّي مبتور الرأس، تزاحمه في مخيّلة الراوي الرأس المبتورة لـ “خالد الأسعد” حارس آثار تدمر، التي لم تجتمع بجسده حتى اليوم. الكاتب يكشف منذ السطور الأولى عن هاجس دائم يؤرقه، ألا وهو الأجساد التي تبحث عن أشلائها المفقودة، والأشلاء التي تتطاير في رحلة بحث يائسة عن قبر يجمعها بجسدها المفقود، مع التركيز على غياب الأذرع عن أجسادها كقاسم مشترك بين أكثر من حكاية، ربما كدلالة على العجز عن حمل السلاح، أو عن الفعل، أو عن تدوين التاريخ.
معاينة الضحية لمسرح الجريمة
يبدو راوي صويلح كمن يسعى -لا شعوريًّا- إلى ترميم النسيج الممزق للجسد السوري، فهو يستمع إلى الأغاني الكردية والأشورية والعتابا البدوية خلال رحلته، ويستنكر انشطار الهويات من السوريّة الجامعة لكل العناصر إلى حفنات من الفينيقيين والأمويين والبابليين ودعاة الخلافة، حتى أنه يستدعي أبياتًا للشاعر حامد بدرخان (1924-1996)، الذي شاهد “الزيتون يركض حافيًا” – وهو بالمناسبة صاحب الأبيات التي ذكرتها في مستهل هذه القراءة- ليكون لاختياره هذا دلالة أخرى على الرغبة الجامحة في استعادة الهوية الجامعة لكل الأطياف المتخاصمة، فالشاعر هنا سوريُّ كتب الشعر بأربع لغات.
تتخلل مشاهدات الراوي إبان ارتحاله من دمشق إلى مسقط رأسه والعكس، مداخلات لشخوص وطيوف وأفكار ووجوه ما انفكت تتزاحم في ردهات عقله العامر بصخب الحرب وأنين الهزيمة، فبينما شبح خوان رولفو يجلس في المقعد المجاور له في الحافلة، تبرق كلمات رياض الصالح الحسين ومحمود درويش أمام عينيه، وتتشابك مع صور لمدينة باتت -حسب تعبيره- أشبه بجدارية للجحيم، أو بمتحف للأنقاض. تسيطر إذن فكرة إعادة تدوير الموت في أرض الأنبياء (من رأس يوحنا المعمدان إلى رأس الحسين حسب روايات بعض المؤرخين) على مخيّلة الراوي، وتتدلى منها مئات علامات الاستفهام حول الجدوى، والدافع، والمصير.
وفي آونة يقظته المجدولة بنوبات شروده، يتعرف الراوي إلى عدة شخوص في طريق عودته إلى دمشق، فهذا معجل السراج؛ تاجر الصقور النادرة الذي يسقط في أسر الميليشيات المتمركزة عند أحد الحواجز، وتلك امرأة لم يمهلها المرض رفاهية الموت في فراشها فقضت نحبها في الحافلة، وإلى جوارها زوج يلعن الموت والأقدار ولا يملك كلفة الدفن، لتتجلى من جديد إشكالية تنهش وجدان الراوي، وهي ببساطة: حق الموت والدفن، ورفاهية حيازة قبر تلتم فيه أجزاء الجسد جميعها.
ما وراء الحكاية: فرس يحتضر…
“أحس بيده اليسرى تهوي ميتة على ركبته عندما حاول رفعها، ولكنه لم يحفل بذلك. لقد تعود رؤية عضو من أعضائه يموت كل يوم”
مقولة أخرى لخوان رولفو تؤطر الحالة الوجدانية للراوي، ينبجس في إثرها طوفان من الكلمات التي تتطوّف فوق رأسه المنشغل بمعاينة الخسارات، يعلو صوت محمود درويش: “يا موت، يا ظلي الذي سيقودني، يا ثالث الاثنين، يا لون التردد في الزمرد والزبرجد، اجلس على الكرسي، ضع أدوات صيدك تحت نافذتي”، فتقاطعه دعد حداد (١٩٣٧-١٩٩١) مصححة خطأ الموت: “لا أحد يستطيع أن يسكن قبري، أنا من تحمل الزهور إلى قبرها، أغمضوا أعينكم، سأمر سريعة كرمح”، لينتصب شكسبير صارخًا: “اللعنة على من يحرك عظامي”.
ماتت الأم فانقطع الحبل السرّي بين الراوي وثنائية المكان والزمان. كان الزمان المشغول على ستائر الذاكرة حقيقيًّا لأن ثمّة أمٍ دمغته بوجودها، وبقي المكان حاضرًا فوق خرائط العمر طالما بقيت أمٌ تحرس الذكريات، وفي رحيل الأم حكم أبدي بالاغتراب، وبداية لانسراب لا نهائي لكل الصور والحقائق والتواريخ التي شكّلت الملامح ونقشت الحكايات خلف جفون الصغار.
جعل الفرس يحتضر، غاب عن ناظريه آخر خط يوضح حدود المضمار، والفارس ترجل عن صهوته منذ زمن، راح يبحث عن نبتة الخلود بين صفحات جلجامش، فسقط في مقبرة بئر يوسف، وعاد مترنحًا يبحث عن سيفه بعدما تسرّب من حوله الرفاق وانفض المتلونون، وبقي وحده يحارب جيوش السراب، حاول الفارس العودة إلى الفرس، لكنه حين وجد سيفه ملتصقًا بذراعه المبتورة، تذكر أن رأسه قد قطعت مع سقوط أول قذيفة في أزقة دمشق.
النظرات الأخيرة لفرس مهزوم
يعاين الراوي بلاء الزمن وزمن الوباء، يمنحه كوفيد مبرّرًا جديدا للانعزال، فيبدو أن خليل صويلح نفسه لم يتخلص بعد من عزلة الحلزون، ولم يجتز اختبار الندم بنجاح يؤهل أبطاله للقفز فوق الواقع المقبض في حيواتهم المقبلة. في عزلة راويه، غير المرفوضة، يصوّب صويلح عدسته المكبرة في مواطئ التشوه التي لا ينكرها إلا مستفيد أو أحمق، ليرصد تحولات المثقفين وتلونهم الحربائي النزعة، وتفشي ظاهرة النضال الصوتي عبر مواقع التواصل.
تطارده في عزلته طيوف عدة، البومة الزرقاء التي نحتتها صديقته الفنانة لن تجد الطريق إلى خالقتها حتى لو أدارت رأسه بزاوية ٢٧٠، فالفنانة سأمت انتظار نصيبها من القذائف فانتحرت، بينما ظلت البومة ساكنة لتستدعي طيف صادق هدايت. وهكذا تتناوب على عزلة الراوي وجوه الشاعر البرتغالي فرناندو بيسوا، وكافكا، والشاعر المكسيكي أوكتافيو باث، وعدي ابن ربيعة (الزير سالم)، علاوة على مطاردات وينستون سميث بطل رواية ١٩٨٤ لجورج أورويل.
وفي مقطع سردي مبهر، يستحضر الراوي ذاكرة الراديو القديم، ليتلو عليه الراديو بيانات الانقلابات السورية التي تصدرت مشهدها السياسي في الفترة بين عامي ١٩٤٩ و١٩٦٦. يسترجع الراوي أكاذيب الجنرالات المنقلبين بعضهم على بعض، ويضيف إلى قائمتهم من وحي الربيع العربي جنرالات آخرين، مازجًا ذلك بمداخلة لماركيز وجنراله الحائر في متاهته…
هكذا راح فرس صويلح يحاكم أفكاره ويستجوب شهوده ويستعرض إبان لحظات السقوط شذرات من تاريخ وطنٍ قطع حبله السرّي وتفرقت أشلاؤه بين قبور من دون شواهد…
تحميض أخير لنيجاتيف الحياة
نتعرف في الثلث الأخير من الرواية إلى جابر عرابي، القاطن في نفس بناية الراوي، وهو المصور والمراسل الحربي الذي جاب الأرض من مشرقها إلى مغربها، يتحدث جابر عن حنينه إلى محلول تحميض الصور الذي تسرب من كاميرات الهواتف النقالة وغاص في رحم النسيان، ولكن جابر يموت وحيدًا، لتتحول غرفته والستوديو الخاص به إلى وكر بغاء تهرس فيها أجساد عاهرات ماركيز، أولئك الحزينات اللاتي يتصورهن الراوي سابحات في حوض كبير مملوء بالمواد الكيماوية لتحميض الصور. كأن كل هذا الأجساد ليست سوى نيجاتيف قديم لحياة ما عادت تشبه الواقع، في بلاد لا تعرف أية انقطاعات للموت كما ادّعى ساراماجو.
على الجانب الآخر، يبدع صويلح في رسم شخصية بديعة خيزران: الأرملة التي يختار لها الراوي اسم بينيلوب، لكن “بينيلوب” صويلح تختار ممارسة البغاء، بعدما تيقنت أن عوليسها لن يعود، وأن وعود هوميروس مثلها كوعود جنرالات الحرب بوقف العنف ولم الشمل.
أما الصورة الوحيدة التي لم تجد طريقها إلى نيجاتيف الراوي، فبقيت مهتزة شبحية تراوغ الواقع بالخيال، وتراود الوهم كما تغوي الحقيقة، فهي دلال شاكر، المرأة التي لا تغيب زهريتها ولا يعبق الهواء بالياسمين إلا بذكرها، لكنها هنا تظل عصيّة على الظهور، طيف أم واقع؟ ماضٍ أم حاضر؟ لا نعرف، وربما لا يهم أن نعرف.
تلخيص الوجع
قبل الختام، أود أن أدرج هنا مقولة جاءت على لسان المصور جابر عرابي خلال محاورة جمعته بالراوي، إذ يقول: “هل تتذكر دفتر ورق السجائر؟ هناك ورقة حمراء في آخر الدفتر يضعونها إشارة إلى نهاية الرحلة. بالنسبة إليّ فقد استهلكت الدفتر تمامًا، ولم يبق إلا مذاق التبغ في فمي”
ختام
رواية مهمة، تحمل شهادة صادقة عن زمن الخراب، عن تشويه المكان وتهميش الإنسان وطمس الهوية، تنطلق من موت الأم لتنتهي بجنازة وضع فيها نعش الوطن على ظهر الفرس.
ليست هذه رواية ميلودرامية أخرى عن الحرب، ولا يمكن أن أكتفي بوصفها بالسوداوية بمعايير كافكا، فخليل صويلح لم يكن بحاجة إلى مسخ شخوصه وإشراع نوافذ الخيال والفانتازيا، فالواقع الذي يعيشه أبشع وأقسى وأكثر تشوّها من كل المسوخ، لذلك فإن سوداوية هذا النص ربما تكمن في واقعيته…
في النهاية؛ كان من الحتمي أن يموت الفرس!
فماذا يبقى للفرس إذا غاب الفوارس، وحُرقت الحقول، وموّهت شواهد القبور، وتخفى الذئب في صوف الحمل، وتسربل الجند في زي الرعاة، وانشغلوا بتوزيع أنصبتهم من الموت والأشلاء والهزائم؟
شكرًا خليل صويلح، كُن بخير…