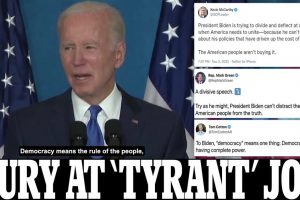منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وإعلان قيام إسرائيل أصبحت الولايات المتحدة القوة المهيمنة في الشرق الأوسط، ولتواجدها العسكري والسياسي هدفان؛ ضمان أمن إسرائيل والحصول على نفط المنطقة بأقل الأسعار، والسؤال الآن هل تغيرت الأهداف بتغير المعطيات على الأرض؟
القضية تناولتها مجلة Foreign Affairs الأمريكية في تحليل بعنوان: “كيف للولايات المتحدة تحقيق الكثير بقليل من التدخُّل في الشرق الأوسط”، ألقى الضوء على المعادلة شبه المستحيلة التي تسعى واشنطن لتحقيقها في المنطقة، وهي الحصول على أكبر قدر من المكاسب بأقل تكلفة ممكنة.
كيف غيّر كورونا والنفط من المعادلة؟
اتضح لبعض الوقت أن الولايات المتّحدة عليها رفع يدها قليلاً عن الشرق الأوسط، رغم ما يصاحب تلك الخطوة من مخاطر وتكلفة، وقد طرحت مجلة Foreign Affairs هذه القضية على صفحاتها في العام الماضي، وحينها رحّب البعض بمثل هذا الإجراء، إلا أن التطوّرات الدراماتيكية التي طرأت خلال الأشهر الأخيرة قد أكَّدت على الحاجة إلى انصراف تركيز الولايات المتّحدة عن المنطقة، مُسلِّطةً الضوء على تكلفة الفرص البديلة للبقاء في شَرَك المنطقة والمخاطر غير المسبوقة الناجمة عن نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحتى قبل أن تتمخَّض أزمتا جائحة فيروس كورونا وما أعقبها من انهيار أسعار النفط عن موجة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط، كان النهج الأمريكي الجديد مُنتظراً منذ زمن بعيد. وفي منطقة لطالما سادتها الولايات المتّحدة كقوّة مهيمنة يتعذّر قبول العديد من صنَّاع السياسة والمحللين الأمريكيين لواقع تضاؤل المصالح وتقلُّص النفوذ، لكن مع انحسار الجائحة ستبدو المنطقة بحُلّةٍ مختلفة -وفي هذا المشهد الذي اعتراه التغيير ثمة فرص سانحة أمام الولايات المتّحدة- ومخاطر أيضاً.
ويتمثَّل التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية في حماية مصالحها الباقية التي لا تزال مهمّة في عصر التقّشف والمنافسة، دون المراوغة بالنُّهج الفاشلة التي سلكتها في الماضي. ولا تزال الولايات المتحدة تحظى بفرص المضي قدماً نحو منطقة أكثر استقراراً، لا تتطلَّب التزاماتٍ باهظة التكلفة أو طويلة الأمد. وينبغي أن يُمكِّن التركيز على كبح المنافسة الجيوسياسية داخل المنطقة، ومواجهة السلوك الإيراني على نحو أكثر فاعلية، وحل النزاعات بالوكالة حيثما تسنَّى حلُّها- واشنطن من الحفاظ على نفوذها المهيمن في المنطقة، وتقليل بذلها في الشرق الأوسط، ولكن دون العزوف عن جهودها هناك كافة.
ردع إيران
لقد تمخَّضت جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط عن دفع بلدان الخليج الغربي إلى مواجهة انخفاض كبير في ثرواتها، ولطالما كان المال هو الأداة السياسية في يد دول الخليج العربي إبان المنافسة الجيوسياسية الإقليمية. والآن، بينما يتبدّل حال اقتصاد دول الخليج، ها هي تواجه مقايضات اقتصادية عسيرة؛ إذ سيتعيَّن عليها البتُّ في قدر ما يمكنهم بذله لأجل الحلفاء المتعثِّرين؛ مثل مصر والأردن، وكم يمكنهم أن ينفقوا لصد النفوذ الإيراني في العراق ولبنان، وكيف يمكنهم حماية مصالحهم الأساسية بين مساعي المطالبة بالسلام في اليمن.
ورغم أن التمويل الخليجي قد عمل أحياناً ضد المصالح الأمريكية، فإن واشنطن كثيراً ما اعتمدت عليه لدعم شركائها الأضعف وتوطيد الدبلوماسية الأمريكية، ومن ثم فإن خسارة ثقل الخليج ستقوّض الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي واقع الأمر ربما يكون وضع إيران أفضل من نظيره في الخليج في أعقاب الجائحة. فرغم ما لحق بالجمهورية الإسلامية من دمار إثر الجائحة، وتلك العقوبات الساحقة التي تواجهها، فإنها قد تعلَّمت منذ زمن بعيد كيف تحيا دون دخل نفطي كبير، فضلاً عن ممارستها المخضرمة لنفوذها الإقليمي بتكلفة زهيدة، حتّى إنه من المرجَّح أن ينمو نفوذ إيران النسبي في أماكن مثل العراق ولبنان وسوريا -في أعقاب انقضاء الأزمة- تزامناً مع تراجع نفوذ دول الخليج العربية.
إن هذا التحوُّل يوجِب مراجعة نهج ترامب العقيم حيال إيران؛ إذ صَعّد ترامب مستويات الضغط العسكري والاقتصادي إلى مستويات ترقى للعقاب، دون أن يصرِّح قَط بمطالب واقعية أو يوضح ما يحمل صفة الأولوية، كما وضع اغتيال قاسم سليماني الولايات المتحدة على أعتاب حرب مع إيران. وكانت النتيجة الأساسية التي أسفرت عنها حملة ترامب هي عزلة الولايات المتحدة أمام مواجهة طموح إيران النووي، والضغوط الجديدة داخل الحكومة العراقية لطرد القوات الأمريكية، وسط حملة قائمة لمواجهة تنظيم داعش، والتحديات المستمرة الجاثمة أمام الأمن البحري والبنية التحتية للطاقة في الخليج.
منح السلام فرصة
تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية كذلك إلى إخماد النزاعات الإقليمية الأخرى التي تتيح لمثيري الاضطرابات -لا سيَّما إيران وروسيا- فرصة لتوسيع نطاق نفوذهم في الشرق الأوسط، ومن هذا المنطلق، ربما يولد من رحم أزمات اليوم بصيص أمل يتمثّل في تقلص نزوع دول الخليج إلى المغامرات الإقليمية.
منذ عام 2011، ظلَّت الحكومات الخليجية تقدِّم الدعم المالي، والمادي، والسياسي، للأطراف المسلحة في ليبيا، وسوريا، واليمن.

وبالتزامن، أتاحت سياسات ترامب المُنتهجة حيال تلك النزاعات الأهلية الثلاثة المدمرة للاعبين الإقليميين (فضلاً عن روسيا وتركيا) متابعة أهدافهم دون أي تقيّد بخطوط حمراء أمريكية، أمّا الآن، فقد تدفع الظروف دول الخليج إلى منح السلام فرصة. وقد يتيح -إلى حدٍّ ما- واقع تقلُّص موارد بعض الجهات الفاعلة القوية والتزامها نحو الأزمة نفوذاً إضافياً للولايات المتحدة، تضغط بموجبه لأجل كبح التصعيد دون حاجةٍ إلى التزامٍ جديد باهظ التكلفة أو تحفُّه المخاطر التي تهدِّد الموارد الأمريكية.
حان الوقت للمراجعة
يجب أن تدفع الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة رَكْبَ أولوياتها العسكرية في المنطقة، وقد حدد جيمس أندرسون، المسؤول البارز في البنتاغون، هذه الأهداف أمام الكونغرس في وقت سابق من هذا العام، وكان مفادها: “ضمان أن المنطقة ليست ملاذاً آمناً للإرهابيين، وألَّا تهيمن عليها أي قوة معادية للولايات المتحدة، وأن يسهم الشرق الأوسط في استقرار سوق الطاقة العالمي”، لكن المعضلة تكمن في كيفية تحقيق هذه الأهداف بفاعلية. فقد يساعد الجهد الدبلوماسي القوي الرامي إلى استدعاء الجهات الفاعلة المحلية إلى طاولة حوار أمني إقليمي على تحقيق تلك الأهداف، ولكن ربما يكون من المفيد أيضاً الشروع في مراجعة التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة.

من المرجح أن يزداد الضغط من أجل تخفيضات ميزانية الدفاع مع بلوغ العجز في الميزانية الفيدرالية 1.5 تريليون دولار، إن الإبقاء على مجموعتين هجوميتين في الشرق الأوسط هو أمر غير مستدام (حيث تأكد تفشي كوفيد-19 على متن حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت، وتجلت على إثر التواجد في الشرق الأوسط الفجوة التي تعتري الوجود الأمريكي في آسيا)، فضلاً عما لدى المنطقة من مقدّرات بحرية وجوية أمريكية. لذا فإن لم تتمخّض المراجعة الشاملة الجارية لوزارة الدفاع عن مزيج مختلف أصغر قواماً من المقدرات ومن تواجد الأفراد والمقار العسكرية في الشرق الأوسط، فستفشل المراجعة في تحقيق المواءمة على نحو ذي مغزى بين الجيش الأمريكي وأولويات الولايات المتحدة.
يحتاج البنتاغون أيضاً إلى طريقة أكثر رسمية لقياس تأثير موقفه الإقليمي على الردع؛ إذ لا ينبغي لواشنطن اتخاذ قرارات بشأن وضعها العسكري في المنطقة كرد فعل على الأزمات أو كوسيلة لتهدئة الشركاء غير الآمنين، بل يجب أن تخصص مقدّراته بما يتماشى مع أهدافه الاستراتيجية.
إما أصدقاء وإما أعداء
يجب على الولايات المتحدة أيضاً إعادة تقييم شراكاتها في الشرق الأوسط؛ إذ يشير الانفتاح الدبلوماسي بين الإمارات وإسرائيل إلى استعداد أصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة للتكاتف ضد التهديد الإيراني. وبينما تستند الولايات المتحدة إلى هذا الأساس، يتعيّن عليها أيضاً ضمان عدم انتهاج حلفائها الإقليميين سبلاً تنتهك المصالح أو القيم الأمريكية، مثلاً من خلال تعزيز قدرات الحكومات الاستبدادية لمراقبة مواطنيها أو قمع المعارضة، بل يجب على واشنطن الحرص على ألا تفسح الأسلحة الجديدة التي تشاركها مع أصدقائها المجال للانغماس في مغامرات قد تزعزع استقرار المنطقة.

ويتصدر قائمة الأولويات تحول علاقة الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية، إذ يتعيَّن على الأولى تشديد موقفها تجاه تطاول السعودية في الداخل والخارج، وملاحقتها بعواقب انتهاكها للأعراف الدولية، لاسيَّما القتل الفاضح للصحفي جمال خاشقجي، وزرع جواسيس في الشركات الأمريكية، ومحاولة اختطاف السعوديين في الولايات المتحدة، ومساعدة السعوديين على الفرار من المحاكم الأمريكية. إنها أفعال لا تصدر عن مجرّد شريك، ناهيكم عن الأصدقاء. ويتعيَّن على الإدارة الأمريكية الجديدة توضيح أن الزيارات رفيعة المستوى ومبيعات الأسلحة والمزايا الأخرى ستعكس التغييرات في سلوك السعودية وسياستها.
الطريق إلى الأمام
بينما تركِّز الولايات المتحدة مشاركتها الإقليمية الأكثر اعتدالاً في الساحات التي يمكنها التأثير فيها، يجب عليها أيضاً تجنُّب إثارة الأزمات التي من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي واحتياج مشاركة الولايات المتحدة لتخفيف وطأتها. حتى لو نحّت إسرائيل جانباً خططها لضم الأراضي في الضفة الغربية في الوقت الحالي، يظل وضع العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية مهيناً. ويجب على الولايات المتحدة العمل على تجنب تأجيج الصراع واستئناف العمل المضني لوضع شروط للمفاوضات. لقد صدّ ترامب أي أمل في حل النزاع بالموافقة على خطط الضم الإسرائيلية، وعزل القيادة الفلسطينية، وخفض المساعدات الضرورية لصحة الفلسطينيين ورفاههم واستقرارهم. ويتعيَّن على الولايات المتحدة إعادة فتح نوافذ العلاقات مع الفلسطينيين والوقوف بقوة ضد أي ضم إسرائيلي للأراضي في الضفة الغربية.
ويجب ألا تنسحب واشنطن من سوريا ولبنان، على الرغم من أن كليهما يعاني من خلل وظيفي عميق، فإنه ما زال بمقدور مشاركة الولايات المتحدة خلق تأثير محدود. وقد يوفر الحفاظ على الوجود المحدود للقوات الأمريكية على الحدود السورية العراقية واستمرار العقوبات المفروضة على كل من سوريا وإيران، في الأشهر المقبلة، المزيد من النفوذ لتشكيل النتائج الأمنية والسياسية. وفي لبنان، تسبب انفجار بيروت المدمر في أزمة لا ينبغي لواشنطن أن تضيعها. ومن خلال العمل مع فرنسا وغيرها، يجب على الولايات المتحدة حشد الدعم الاقتصادي المشروط بإصلاح سياسي واقتصادي ذي مغزى، ودعم المجتمع المدني اللبناني، ومواصلة الاستثمار في جهود الجيش اللبناني ضد التهديدات المشتركة، مثل داعش.
يجب على واشنطن كذلك تجنب النظر إلى دورها في الشرق الأوسط فقط من خلال عدسة منافستها الجيوسياسية مع الصين وروسيا، إذ لا يوجد ما يدعو فعلياً للاعتقاد بأن الحكومات الإقليمية يجب أن تنحاز إلى أحد الجانبين.

باختصار، لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بفرص تؤهّلها لتشكيل منطقة أكثر استقراراً على نحو لا يتطلب التزامات باهظة الثمن أو طويلة الأمد. إن التركيز على تقييد المنافسة الجيوسياسية داخل المنطقة، ومواجهة السلوك الإيراني بشكل أكثر فاعلية، وحل النزاعات بالوكالة حيثما أمكن حلّها، من شأنه تمكين واشنطن من بذل القليل من الجهد دون تهديد هيمنتها الإقليمية. لا تزال المخاطر التي تهدد المصالح الأمريكية قائمة؛ إذ تعد الجائحة وما صاحبها من أزمات اقتصادية تذكيراً بهشاشة الحوكمة والخدمات الاجتماعية في أجزاء كثيرة جداً من هذه المنطقة، ما يشكل تحدياً طويل الأجل أمام الاستقرار والأمن. حتى لو نجحت الولايات المتحدة في سلك طريق ينأى بها عن هذا الصراع، فليس من الواضح بعد أين سينتهي هذا الطريق.
لماذا ألقت وفاة قاضية في المحكمة العليا مزيداً من الوقود على حرائق أمريكا الانتخابية؟
جاءت وفاة إحدى قاضيات المحكمة العليا في الولايات المتحدة لتسكب مزيداً من البنزين على السباق الانتخابي المشتعل؛ فترامب انتهز الفرصة ويريد تعيين بديل للقاضية الليبرالية فوراً، بينما بايدن يريد الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية، فما قصة روث بادر غينسبورج، ولماذا يعد تعيين بديل لها بهذه الأهمية؟
ما علاقة المحكمة العليا بالانتخابات من الأساس؟
تعتبر المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، رغم أنها لا تملك الاختصاص الأصلي إلا في مجموعة صغيرة من الحالات التي تشهد خلافاً قضائياً، وتتكون هئية المحكمة من 9 قضاة، أحدهم رئيس والثمانية أعضاء، وحالياً يرأس المحكمة القاضي جون روبرتس، الذي عيّنه الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن قبل أكثر من 14 عاماً.
ويتم التعيين في المحكمة العليا من جانب الرئيس الأمريكي، الذي يقدم مرشحاً لمنصب قاض في المحكمة حال خلو المنصب، ولا يخلو المنصب إلا بالوفاة أو الاستقالة أو التقاعد أو الإدانة القضائية النهائية، حيث يظل قضاة المحكمة العليا في منصبهم مدى الحياة، ولا يمكن للرئيس أو غيره إقالتهم تحت أي ظرف من الظروف.

وفي العادة يمثل تعيين قضاة المحكمة العليا شداً وجذباً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بسبب المواقف المختلفة التي يتبناها كل حزب من القضايا الاجتماعية الكبرى كالإجهاض على سبيل المثال، فالجمهوريون محافظون بينما الديمقراطيون يتبنون المواقف الأكثر ليبرالية، لكن منذ انتخابات عام 2000 التي شهدت حسم النتيجة من خلال المحكمة العليا بفوز الجمهوري جورج بوش الأب، على حساب الديمقراطي آل جور، أصبح تعيين قضاة المحكمة العليا أكثر سخونة بين الجانبين.
وفي ظل الاستقطاب غير المسبوق الذي تشهده الولايات المتحدة في السنوات الأربع الأخيرة، ليس سياسياً فقط، وإنما اجتماعياً أيضاً، تأتي وفاة القاضية غينسبورج قبل أقل من ستة أسابيع على موعد الانتخابات ليسكب مزيداً من الوقود على السباق المشتعل بين الحزبين، وليس فقط على منصب الرئيس الذي يتنافس عليه دونالد ترامب وجو بايدن.
معركة تعيين بديل لغينسبورج
تمثل غينسبورج الصوت التقدمي الليبرالي الأبرز بين قضاة المحكمة، وتعتبر أيقونة حقوق المرأة، وكانت ثاني امرأة يتم تعيينها في المنصب، وذلك قبل أكثر من 27 عاماً، والذي رشحها للمنصب كان الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون، وبالتالي فإن توقيت وفاتها عن عمر يناهز 87 عاماً قد أثار على الفور اشتباكات بين الحزبين بشأن تعيين بديل لها.
غينسبورج فارقت الحياة مساء الجمعة 18 سبتمبر/أيلول، وكشف ترامب السبت أنه يعتزم التحرّك سريعاً في تسمية بديل لها في المحكمة العليا، مبرراً في تغريدة أنّ تسمية قضاة لهذه المحكمة هو “القرار الأهم” الذي ينتخب من أجله رئيس، وقال إن تسمية قاض (بديل لغينسبورج) “واجب، علينا (المضي به) دون تأخير”.
لكن الرد من جانب الديمقراطيين لم يتأخر، حيث وجه الرئيس السابق باراك أوباما وبايدن تحذيراً لترامب، حيث قال بايدن في تصريح صحفي “يجب على الناخبين اختيار الرئيس، وعلى الرئيس اختيار قاضٍ لينظر فيه مجلس الشيوخ”.
بينما دعا أوباما خلفه إلى الامتناع عن ذلك في الوقت الذي بدأت فيه “عمليات اقتراع” في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث إن المحكمة العليا تملك كلمة الفصل في كل القضايا الاجتماعية الكبرى التي ينقسم عليها الأمريكيون مثل الإجهاض وحق الأقليات وحيازة السلاح وعقوبة الإعدام وغيرها، كما أن لهذه المحكمة أيضاً الكلمة الفصل في النزاعات الانتخابية، على غرار ما حصل في انتخابات عام 2000 التي انتهت بفوز جورج بوش الابن.
وانتقد أوباما بشدة موقف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي أعلن أنه سيجري عملية تصويت لاختيار بديل للقاضية الراحلة، بالرغم من أن ماكونيل نفسه رفض عام 2016 تنظيم جلسة استماع إلى قاض اختاره باراك أوباما لهذا المنصب، بحجة أنه كان عاماً انتخابياً.
مأزق للجمهوريين أيضاً
وتناولت صحيفة الغارديان البريطانية القصة في تقرير بعنوان “كيف تؤثر وفاة غينسبورج في صراع ترامب وبايدن”، تناول أيضاً تأثير الوفاة على السباق الانتخابي في مجلس الشيوخ، حيث تشهد الانتخابات يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل معركة حامية في الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ أيضاً.

ويخشى الجمهوريون من فقدان أغلبيتهم الحالية في مجلس الشيوخ، حيث يمتلكون 53 مقعداً مقابل 47 لمنافسيهم، بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب برئاسة نانسي بيلوسي.
وتواجه سوزان كولينز، عضو مجلس الشيوخ الجمهورية، منافسة شرسة في دائرتها الانتخابية في ولاية مين، والسبب مواقفها المحافظة في قضية الحق في الإجهاض، حيث تظهر استطلاعات الرأي هناك تقدم منافستها الديمقراطية ساره جيدون بأكثر من 12 نقطة، ومن ثم فإن تصويت كولينز لصالح مرشح ترامب لشغل منصب القاضية غينسبورج ربما يزيد من تضاؤل فرص كولينز في الاحتفاظ بمقعدها في مجلس الشيوخ.
وقد انعكس الموقف الصعب الذي تواجهه كولينز في تصريحاتها، عصر السبت، تعليقاً على وفاة القاضية الليبرالية ومعركة تعيين بديل لها التي اشتعلت مباشرة، حيث قالت إنه على الرغم من أن ترامب “يمتلك السلطة الدستورية لترشيح البديل فوراً”، وأنها (كولينز) لا تعترض على أن تبدأ اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ عملية التدقيق للمرشحين، فإن القرار “يجب أن يتخذه الرئيس الذي سيتم انتخابه يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني”.
أما بالنسبة للديمقراطيين فإن القصة تتعلق بوجود 3 قضاة فقط يميلون لليسار في أفكارهم، حكموا على الرؤساء الذين قاموا بتعيينهم، وهم حالياً ستيفن براير (عيّنه بيل كلينتون)، وسونيا سوتوماير، وإيلينا كاغان (عينهما باراك أوباما)، مقابل 5 قضاة عيّنهم رؤساء جمهوريون، أبرزهم رئيس القضاة جون روبرتس، لكن بشكل عام يشعر الديمقراطيون بخطر ميل المحكمة العليا أكثر ناحية اليمين حال تمكن ترامب من تعيين بديل للقاضية الراحلة.
ففي قضية تقييد حق اللجوء، على سبيل المثال، أقرت المحكمة ما أراده ترامب من فرض قيود على حق اللجوء، عندما وافقت على الرفض التلقائي لجميع طلبات اللجوء التي يقدمها مهاجرون لم يتقدموا بطلب للحصول على صفة لاجئ في المكسيك أو في بلدان ثالثة، عبروها للوصول إلى الولايات المتحدة، وهو القرار الذي عارضته غينسبورج وسوتومايور فقط.