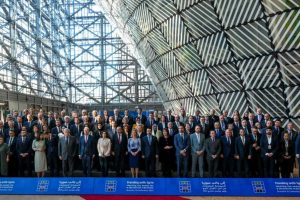في خطوة مفاجئة شرعت الدنمارك في سحب وإلغاء تصاريح الإقامة من بعض السوريين اللاجئين إلى البلاد وحثهم على العودة إلى بلادهم بحجة أن مناطقهم باتت آمنة لا سيما هؤلاء الذين ينحدرون من العاصمة دمشق.
كانت غالية العسة وهي لاجئة سورية قد بدأت لتوها بدراسة الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية في الجامعة التقنية بالدنمارك، عندما استدعتها خدمات الهجرة بالدنمارك لإجراء مقابلة معها.
طوال خمس ساعات، سألها موظفو الهجرة عن كفاءتها في اللغة الدنماركية التي تتحدثها بطلاقة. واستفسروا عن مدى اندماجها في الدنمارك، حيث تعيش مع أسرتها منذ فرارها من سوريا عام 2015.
تشتت العائلات
تروي غالية في مقابلة هاتفية أجرتها مع صحيفة The New York Times الأمريكية، أنه في فبراير/شباط، قال الضباط لغالية إن الوضع الأمني في مسقط رأسها بدمشق قد تحسن، وأنه صار من الآمن لها أن تعود إلى موطنها، سوريا.
وهذا يعني أن غالية العسة، 27 سنة، ستفقد حقها في العيش في الدنمارك، حتى مع بقاء إخوتها الأربعة ووالديها هناك، ولم يكن لديها مكان آخر لتذهب إليه.
ومنذ صرحت خدمات الهجرة الدنماركية في عام 2019 أنها تعتبر دمشق والمناطق المحيطة بها آمنة، فإنها قد راجعت تصاريح الإقامة لـ1250 سورياً -ومنهم غالية- ممن غادروا بلادهم خلال الحرب الأهلية. وقد ألغت السلطات أو لم تمدد تصاريح الإقامة لأكثر من 250 منهم.

وبذلك، أصبحت الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم اللاجئين السوريين من وضع لجوئهم، حتى مع استمرار حالة الانهيار في سوريا. وتصف الأمم المتحدة معظم المناطق في سوريا بأنها غير مستقرة بما يكفي لاعتبارها آمنة للعائدين.
وكان من بين الذين طُلب منهم المغادرة طلاب المدارس الثانوية والجامعات، وسائقو الشاحنات، وموظفو المصانع، وأصحاب المتاجر، والمتطوعون في المنظمات غير الحكومية. جميعهم معرضون لخطر تهجيرهم من بلد بنوا فيه حياة جديدة.
وقالت أسماء الناطور، 50 عاماً، في إشارة إلى الرئيس السوري، “كأن خدمات الهجرة الدنماركية قصفت حلمي، مثلما قصف بشار الأسد منازلنا. الفرق أن هذه المرة القصف نفسي”.
الجيل الثاني مرحب به!
كانت أسماء تتحدث من بلدة رينغستيد، على بعد 30 ميلاً جنوب غرب كوبنهاغن، حيث تعيش هي وزوجها. في فبراير/شباط، قيل للزوجين إن تصاريح إقامتهما لن تُجدد، بينما يمكن لابنيهما، اللذين يبلغان من العمر 20 و22 عاماً، تجديد الإقامة. مُنح الابنان حق اللجوء على أساس تعرضهما لخطر الاضطهاد في سوريا.
معظم السوريين البالغ عددهم 34 ألفاً، ممن حصلوا على تصاريح إقامة في الدنمارك منذ بدء الحرب، في بلادهم عام 2011 لم تُراجع إقامتهم. ومع ذلك، فإن هذا القرار بتجريد المئات من وضعهم القانوني هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الدنمارك، التي تقول جماعات حقوقية إنها استهدفت المهاجرين والأقليات.
فرضت السلطات تعليمات إلزامية بخصوص “القيم الدنماركية” للأطفال في الأحياء ذات الدخل المنخفض، والأحياء ذات الأغلبية المسلمة، التي وصفتها الحكومة بأنها “غيتو” أو مناطق أقليات، وضاعفت العقوبات على جرائم معينة في هذه المناطق.
وعدلوا أيضاً الشروط القانونية في البلاد بشأن الهجرة، فتحوَّل من الاندماج، إلى العودة السريعة للاجئين إلى بلدانهم الأصلية. هذا وقد خسر مئات اللاجئين الصوماليين تصاريح إقامتهم بعد أن اعتبرت الدنمارك أن الصومال آمن للعودة إليه.
الصراع الانتخابي له دور
قال بير موريتسين، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية بجامعة آرهوس، إن الحكومة شددت موقفها بشأن الهجرة في السنوات الأخيرة لتجنب خسارة الأصوات لصالح اليمين، وهي معضلة واجهها العديد من أحزاب يسار الوسط في جميع أنحاء أوروبا.
وأضاف موريسن أن “الطريقة الوحيدة للتغلب على اليمين في الدنمارك، هي أن تبيع روحك للشيطان وأن تكون صارماً فيما يتعلق بالهجرة، للحصول على دعم لسياسات الرعاية الاجتماعية مقابل ذلك”.

في العام الماضي، تجاوز عدد اللاجئين الذين غادروا الدنمارك عدد الوافدين إليها. وتعهدت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن بالمضي قدماً، قائلة إن الدنمارك ستهدف إلى “عدم وجود أي طالب لجوء”.
أوضح وزير الهجرة ماتياس تسفاي، في شرحه للقرارات التي لها تأثير في وضع السوريين بالبلاد، أن الدنمارك كانت “صادقة منذ اليوم الأول” معهم.
قال تسفاي في شباط/فبراير: “لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة”.
وبالنسبة للراغبين في العودة إلى سوريا، قال تسفاي إن الدنمارك ستقدم “حقيبة ضخمة من أموال السفر”. وتقول السلطات إن المئات قرروا العودة طواعية.
حصلت غالية العسة، التي تعد آخر فرد في عائلتها يغادر سوريا في أواخر عام 2015، على تصريح إقامتها بعد شهور من وصول والديها وإخوتها إلى الدنمارك. ولأنها لم تكن قاصراً، لم تستطع طلب اللجوء من خلال لم شمل الأسرة وكان عليها أن تقدم طلباً بمفردها.
وبينما يتعرض أشقاؤها لخطر التجنيد في الجيش السوري، كانت غالية هي الوحيدة التي استُدعيت لمقابلة مع خدمات الهجرة الدنماركية.
العودة إلى بلد محطم!
قالت غالية: “أبذل قصارى جهدي للاندماج مع المجتمع الدنماركي والمشاركة فيه، فأثقف نفسي وأدفع الضرائب”. وأضافت أن عائلتها لم يبقَ لها شيء في سوريا وأنها لا ترى مستقبلها إلا في الدنمارك. لكنها استدركت أن “وصمة العار التي تحيط باللاجئين، ولا سيما المسلمين، مؤلمة للغاية”.
سوريا بلد محطَّم اقتصاده منهار، ونزح نصف سكانه قبل الحرب. استعاد الأسد السيطرة على ثلثي أراضيه، بما في ذلك منطقة دمشق. ودعا السوريين إلى العودة، لكن الكثيرين يقولون إنهم لن يعودوا لسبب واحد: وجود الأسد نفسه.
قال حسام الخولي، الطالب في المرحلة الثانوية والبالغ من العمر 20 عاماً، وهو عامل مستودع يعيش في كولدينغ بغربي الدنمارك، “ما دام الوضع ليس سلمياً والرئيس لا يزال هناك، فإننا لا نريد العودة”.
علم الخولي، وهو من منطقة دمشق، في فبراير/شباط، أن تصريح إقامته في الدنمارك لن يُجدَّد مع والديه وشقيقتيه.

أفادت مجموعات حقوقية عن تهديدات مختلفة ضد اللاجئين العائدين، بما في ذلك التجنيد الإجباري للرجال، والاعتقال على خلفية الاشتباه في أن أي شخص أيد “المتمردين” الذين حاولوا الإطاحة بالأسد هو خائن.
واختفى المئات من العائدين، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وحذرت هيئة لجوء الاتحاد الأوروبي من أن العائدين طوعاً يتعرضون لخطر الاعتقال والتعذيب والموت.
وقالت سلينتي من المجلس الدنماركي للاجئين: “إن عدم وجود الاقتتال في بعض المناطق لا يعني أن الناس يمكنهم العودة بأمان”.
فيما قالت غالية، طالبة الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية، إنها حاولت التركيز على دراستها منذ أن علمت أن تصريح إقامتها قيد الإلغاء. ومع ذلك، ذكرت أن فكرة البدء من جديد أرعبتها.
تقول غالية: “أنا لست خطراً. أنا لست مجرمة. فقط أريد أن أعيش هنا”.
بعد 10 سنوات من الحرب.. لماذا قد لا يعود ملايين السوريين من المنفى للعيش في وطنهم مجدداً؟

نشرت صحيفة The Times البريطانية تقريراً موسعاً عن أحوال وظروف ملايين اللاجئين السوريين الذين انتشروا في جميع القارات حول العالم، وذلك بعد 10 سنوات من اندلاع الثورة ضد نظام بشار الأسد، وتناول احتمالات عدم عودتهم لبلادهم من منفاهم.
تقول الصحيفة إن نزوح السوريين خلال الحرب في البلاد، التي بدأت قبل عشر سنوات، كان من أكبر هجرات الناس بعيداً عن ديارهم في التاريخ الحديث. من بين سكَّان سوريا البالغ عددهم في الأصل 23 مليون نسمة، يُعتَقَد أن ما لا يقل عن سبعة ملايين هم الآن في الخارج، حصلوا على اللجوء أو الإقامة في دولٍ مختلفة؛ من كندا إلى أستراليا، مروراً بجميع الدول بينهما. ويقول العديد من أولئك الذين عادوا إنهم “نادمون” على ذلك، بحسب الصحيفة.
وتُقسَّم سوريا الآن إلى أربعة أجزاء، يعيش حوالي 15 مليون شخص في مناطق لا تزال تحت سيطرة نظام بشَّار الأسد. وثلاثة إلى أربعة ملايين آخرين يعيشون في المناطق الشمالية الغربية التي تسيطر عليها قوات المعارضة المدعومة من تركيا وهيئة تحرير الشام. هذا علاوة على مليونين إلى ثلاثة ملايين آخرين في شرقيّ سوريا، الذي تديره قواتٌ يقودها الأكراد المسلحون المدعومون من الولايات المتحدة. وربما يكون ستة ملايين طفل قد وُلِدوا خلال السنوات العشر الماضية لم يشهدوا سوى الحرب.
هل تقبّل السوريّون حياة المنفى بشكل دائم؟
تقول الصحيفة البريطانية، إنه بالنسبة للكثيرين، لن تكون المناطق التي يسيطر عليها النظام آمنة ما دام الأسد في السلطة. ويستمر القتال في العديد من المناطق، ولكن حتى في المناطق الآمنة من الحرب يشتد الانهيار الاقتصادي إلى درجة أنه ما مِن ضمانٍ لكسب العيش. ويعاني نصف مليون طفل سوري دون الخامسة من التقزُّم بسبب سوء التغذية، وفقاً لليونيسيف.
وعلى أولئك الذين فرّوا من سوريا أن يقرِّروا ما إذا كانوا سيقبلون حياة المنفى بشكلٍ دائم. ويقع مصيرهم في كثيرٍ من الأحيان في يد الحكومات غير المتعاطفة والمسؤولة أمام الرأي العام في بلادها.
اتَّخَذَت أنجيلا ميركل قراراً أحادياً في العام 2015 بالسماح لمئات الآلاف من المهاجرين الذين يسيرون عبر أوروبا الشرقية بالبقاء في ألمانيا، لكن الدول الأخرى لم تكن بهذا السخاء. وأصبحت الدنمارك أول دولة غربية تحكم رسمياً بأن أجزاءً من سوريا آمنةٌ للعودة إليها، مِمَّا أدَّى إلى سحب حقوق الإقامة لـ94 لاجئاً، فيما أدانت جماعات حقوق الإنسان هذا القرار.
ويقول نشطاءٌ سابقون إنه من المستحيل معرفة ما إذا كانت أسماؤهم مُدرجةً في قوائم أولئك الذين سيُعتَقَلون إذا عادوا. وفي أوطانهم الجديدة، يتواصل السوريون مع بعضهم البعض في جميع أنحاء العالم من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ويُعتَبَر تطبيق “كلاب هاوس” على سبيل المثال وسيلةً شائعةً بشكلٍ خاص للتحدُّث عبر الإنترنت.
مُخرج سينمائي في كندا
قبل الثورة، كان “مو”، 36 عاماً، ابناً متميِّزاً في دمشق. درس في الخارج وكان بإمكانه السفر بحرية، على عكس الغالبية العظمى من السوريين. وحين بدأت الحرب تضع أوزارها كان جواز سفره الثاني، من كندا، تذكرة خروج، وهو يعيش الآن في تورنتو.
في البداية، كان يعتقد أن الأسد سيصلح النظام. درس الرئيس الشاب في المملكة المتحدة، وكانت زوجته امرأةً بريطانية ساحرة. كان هذا هو الوجه الذي أراده السوريون مثل مو لبلدهم؛ نظام يعتقدون أنه قادرٌ على التغيير، على عكس الديكتاتوريات البالية الأخرى التي أسقطتها انتفاضات الربيع العربي.
في المقابل، قمع الأسد المظاهرات مُتَّهِماً المتظاهرين بالعمل لصالح قوى أجنبية. وَجَدَ مو نفسه يقف إلى جانب المتظاهرين. اختلف معه العديد من الأصدقاء في دمشق. يقول مو: “كنت دائماً منفتحاً للمحادثة، إذ كنت أرغب في رؤية الجانب الآخر”. وأضاف: “لكن معظم الناس كان لديهم موقف مفاده أنه إذا كنت تتحدَّث لغتي فأنت معي.. لقد فقدت الكثير من الأصدقاء”.
حين بدأت الانشقاقات في الجيش، بدأ مو يشعر بعدم الارتياح بشأن ما ينتظره في المستقبل. بدأ الجيش بمهاجمة الأحياء التي تركَّزَت فيها الاحتجاجات. وفي أواخر عام 2012، غادَرَ مو البلاد، أولاً إلى لبنان ثم إلى دبي، لم يشعر بالسعادة في أيِّ مكان، وبحلول ذلك الوقت كان الكثير من السوريين قد أصبحوا لاجئين.
وحتى في كندا، التي تعجُّ بالمهاجرين، فإن ردَّ الفعل الأول حين يعرف الناس من أن هذا المهاجر أو ذاك قد أتى من سوريا، فهذا يعني بالنسبة لهم أنه فقير. غالباً ما يشعر مو بالذهول من ذلك، إذ إن وضع عائلته مختلفٌ تماماً عن وضع معظم السوريين الآخرين الذين يعيشون في الخارج. ومع ذلك فإن القاسم المشترك بينهم جميعاً هو أنهم لا يستطيعون العودة.
منشق عن الجيش الأسد في الولايات المتحدة
يراود هائل العشاوي، 35 عاماً، كابوساً متكرِّراً يكون فيه على متن طائرةٍ تهبط في دمشق. مرَّت تسع سنوات على آخر زيارة له إلى المدينة، لكنه يعرف ما ينتظره عند وصوله. قال: “أشعر بالرعب في أحلامي، أعلم أنني سأُعتَقَل وأختفي، وأعرف ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص يراودهم هذا الكابوس”.
كان العشاوي يؤدِّي خدمته العسكرية حين اندلعت الاحتجاجات، كان المُجنَّدون محصورين في القاعدة. أخبرهم قادتهم أولاً أن كلَّ شيءٍ تحت السيطرة، ثم قالوا إن المتظاهرين كانوا يسلخون الناس أحياءً ويتلقون شحناتٍ من الأسلحة من أوروبا. قال العشاوي: “كان الجميع يعرف ما كان يحدث، لكن كان هناك إنكارٌ كبير. منذ اليوم الأول قال النظام الشيء نفسه الذي لا يزال يقوله الآن؛ إن المتظاهرين كانوا إرهابيين”.
أدَّت تكتيكات الخوف إلى تقسيم الوحدة التي انتمى لها العشاوي بنفس التقسيم الذي أدَّى في النهاية إلى بعث الفوضى في البلاد. قال: “كنَّا مجموعةً متفقةً تماماً على كلِّ شيء”. وأضاف: “أكره التحدُّث عن الأمر بهذه الطريقة، لكننا كنَّا جميعاً من السُنَّة. وبدأ العلويون أيضاً في التجمُّع معاً، وكان لديهم خوف الأقليات”. وتابَعَ: “ثم بدأ موقف القادة يتغيَّر. أخذوا منَّا بنادقنا. اعتقدت أنهم ربما أخذوهم من الجميع، ثم اكتشفت أنهم تركوهم مع جميع الرقباء العلويين، وحينها شعرت بالخطر”.
ومع وشوك خدمته العسكرية على الانتهاء، علم أن ابن عمه قُتِلَ خلال مظاهرةٍ في مسقط رأسه في مدينة دير الزور. وقد انشقَّ في العام 2012، حين كان الجيش يفرض حصاراً على حي بابا عمرو في حمص، حيث قُتِلَت الصحفية ماري كولفين، بصحيفة Sunday Times البريطانية، بقصف النظام.
يعيش العشاوي الآن في شيكاغو، وهو مُتزوِّج من أمريكية ولديه ابنة صغيرة، وعلى وشك أن يصبح مواطناً أمريكياً. ولا يزال على القوائم السوداء للنظام، وليس لديه أملٌ في العودة طالما يظلُّ الأسد في السلطة.
مُتطوِّعةٌ في الصليب الأحمر في بلجيكا
مثل العديد من المراهقين السوريين المتعلِّمين في دمشق، أمضت عائلة عائشة، 29 عاماً، وقت فراغها في التطوُّع. لكن عملها في “الصليب الأحمر الدنماركي”، وزيارة دور الأيتام وكبار السن، تغيَّر بأكمله حين كانت في التاسعة عشرة من عمرها.
حين بدأ النظام في إطلاق النار على المتظاهرين، ثم قَصَفَ ضواحي معاقل المعارضة، غيَّرَ رئيسها جهود المجموعة. قالت: “بدأ في إنشاء عياداتنا الميدانية في أماكن استراتيجية، ليس فقط في وسط المناطق الساخنة، ولكن بالقرب منها”. وأضافت: “في بعض الأيام كنَّا نقوم بأشياءٍ روتينية. وبعد ذلك، في بعض الأيام، كان هناك قصفٌ على مقربةٍ منَّا، وكان الناس يحملون الجرحى جالبين إياهم لنا وتفوح منهم رائحة دماء كثيرة”.
كانت عائشة، التي تلقَّت تدريباً طبياً أساسياً، تساعد في العمليات الجراحية. في إحدى المرات كانت تحمل مصباحاً فوق مريضٍ بينما كان الطبيب يستخرج رصاصةٍ من بطنه، وعندما اقترب القصف بشدة شعرت بالقلق من احتمال تعرَّضها للإصابة. ولكن بعد ذلك يصل تدفُّقٌ جديدٌ من الجراحة، ولا يسعها الوقت لتشعر بالخوف.
تقول: “لا أستطيع حقاً التعامل مع الدماء والعنف حين أشاهده على التلفاز، لكن عندما كان أمامي مباشرةً لم أفكِّر بهذه الطريقة. عندما كنت أصغر سناً، تكون أشجع وأكثر إقداماً. أما الآن، حين أفكِّر في المخاطرة هكذا مرةً أخرى، أقول ربما لا”.
لم تفكِّر عائشة كثيراً في النظام الذي تعيش في ظلِّه. كانت تعلم أن الكثير من الأشخاص في السجن، لكنها نشأت في عائلةٍ لم تتحدَّث قط عن السياسة. المرة الأولى التي تحدَّثَت فيها عن السياسة كانت مع أصدقائها خلال الشهر الأول من الاحتجاجات، وجميعهم عارضوا الانتفاضة. ثم بدأوا يسمعون ما يحدث في درعا، المدينة الجنوبية الواقعة على الحدود الأردنية، حيث كان الشباب يتعرَّضون للتعذيب والقنص من قِبَلِ رجال أمن النظام.
دعمت عائشة ووالدها المتظاهرين، فيما دعمت والدتها وشقيقتها الأسد -على الأقل حتى بدء القمع الحقيقية. وسرعان ما بدأت عائشة تسمع عن اعتقال أصدقائها. سيطر العنف الذي يمارسه النظام على عملها في الصليب الأحمر. قالت: “الكثير من التفاصيل التي لم أخبر بها عائلتي، لكنهم لا يزالون غير سعداء”.
غادرت الأسرة إلى الأردن في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وانتقلت في العام التالي إلى تركيا. وهناك، بدأت عائشة العمل في منظمةٍ إغاثية، وفي عام 2016 فازت بمنحةٍ دراسية للحصول على درجة الماجستير في بلجيكا. عادت عائلتها إلى دمشق، لكن آخر زيارة لعائشة كانت عام 2016.
ربة منزل في تركيا
أولاً كانت الاحتجاجات على شاشة التلفزيون، ثم وصلت إلى الحي الذي كانت أم أحمد تسكن فيه في حلب، وفي غضون أشهر أصبحت مدينتها ساحة معركة. فرَّت أم أحمد مع زوجها، أولاً إلى بلدة أعزاز القريبة من الحدود، ثم في عام 2013 إلى مدينة غازي عنتاب التركية. ولم يعودا قط إلى سوريا.
قالت أم أحمد، 35 عاماً: “أتمنَّى ألا يحدث شيءٌ على الإطلاق. كنَّا نعيش في بيوتنا في سوريا. لم تكن حياةً مثالية، لكننا على الأقل كنَّا بأمان في الماضي”. حين وصلت العائلة إلى تركيا، كان عدد السوريين الذين وصلوا عبر الحدود يبلغ مئات الآلاف. يوجد اليوم ما لا يقل عن أربعة ملايين منهم، معظمهم -مثل أم أحمد- لديهم أمل ضئيل في التمكُّن من العودة قريباً.
تقول أم أحمد: “الحياة في تركيا آمنة، ولكنها ليست سهلة”. ليس لديهم تصاريح عمل، ويضطرون إلى العمل في وظائف منخفضة الدخل وغير منتظمة. يعمل زوج أم أحمد في بقالةٍ ويكسب 500 ليرة تركية (70 دولاراً) في الأسبوع. وكانت أم أحمد تنظِّف المنازل قبل اندلاع جائحة كوفيد-19. الأقارب في الوطن مُبَعثرون بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة. ولا يزال والدا أم أحمد وإخوتها في دمشق، ولم ترهم منذ 2011.
مقاتل معارض في لبنان يعيش على مساعدات الأمم المتحدة
قال سامر عامر، 36 عاماً، في 2011 إن سوريا كانت تعيش في “فساد وظلم”، وإنه لا يطيق الانتظار لفعل شيءٍ حيال ذلك. وقال: “عندما بدأ التونسيون الاحتجاج، كنت شاباً مدفوعاً بالحماس والفخر. كنت أسأل متى سيحين دورنا. لم أطق الانتظار لأكون جزءاً من ثورة”.
في ذلك الوقت، كان سامر يعمل حلَّاقاً في مسقط رأسه، مدينة القُصَير، على الحدود اللبنانية. بدأ في المشاركة في الاحتجاجات في حمص، المدينة المجاورة، وعندما بدأ النظام في إطلاق النار على المتظاهرين، نظَّمَ احتجاجاتٍ في مدينته.
اعتقل النظام القادة المنظِّمين للاحتجاجات، ما أشعل احتجاجاتٍ أطلق عليها النظام النار، ما كان يعني المزيد من الجنازات، وبالتالي المزيد من الاحتجاجات، وهكذا. سرعان ما بدأ الطرفان في القتال. قال سامر: “بمجرد إراقة الدماء، لم يكن لدينا خيارٌ سوى الدفاع عن أطفالنا وعائلاتنا”. وأضاف: “اعتقلوا أخي وعذَّبوه بشكلٍ وحشي وكاد أن يموت. وحين أطلقوا سراحه، كان أول شيءٍ فعله هو الحصول على سلاحٍ والانضمام إلى قوات المعارضة”.
قُتِلَ شقيق سامر، لكنه نجا بنفسه، رغم إطلاق القنَّاصة النار عليه وإصابته في ساقه. فرَّ في النهاية في هجومٍ أخير في مايو/أيَّار 2013، ويعيش الآن في مخيَّمٍ بالقرب من الحدود، ليس لديه وظيفةٌ ويعتمد على مساعدات الأمم المتحدة.
عامل إغاثة في أستراليا
قال رامي، 33 عاماً، إن الهدف الأصلي كان تغيير الحكومة، وليس بالضرورة تغيير النظام. كانت سرعة الاستجابة وعنفها هي التي غيَّرَت كلَّ شيء. كانت ليبيا مصدر إلهامه. بلدانٌ مثل مصر وتونس، رغم الديكتاتورية، فقد سمحت ببعض المساحة للمعارضة، لكن ليبيا كانت مثل سوريا، حيث لا يُسمَح بأيِّ شكلٍ من أشكال مخالفة الرأي. ومشهد الشعب الليبي وهو ينقلب على العقيد القذافي جَعَلَ السوريين يشعرون أنه بإمكانهم فعل الشيء نفسه، وكانوا يعرفون أيضاً أنه سيكون صعباً. قال رامي: “لم نعتقد على الإطلاق أن النظام قد يسلِّم السلطة سلمياً”.
كان رامي ينهي دراسته في القانون، وحصل على وظيفةٍ في إحدى وكالات الإغاثة. ولأنه ملتزمٌ باللاعنف، فقد رفض حمل السلاح. غادَرَ رامي البلاد بعد أن شهد إجلاء الثوار وعائلات المعارضة من مدينته حمص، وأدرك أن الموت كان قاب قوسين أو أدنى “من الاعتقال، أو من الرصاص الطائش، أو من الاستهداف”. لقد رأى عدداً من أصدقائه تبتلعهم زنازين النظام ولا يعودون أبداً.
يعمل رامي الآن في مؤسَّسةٍ خيرية في أستراليا، ويكافح الإحساس الدائم بالذنب على الناجين داخل سوريا بسبب اضطراره للهروب من الموت في البلاد، ويتساءل هو وأصدقاؤه كيف يمكن أن تتحوَّل الأمور بشكلٍ مختلف.