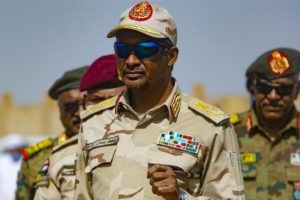سوريا التي غادرها رفعت الأسد عندما كان نائباً للرئيس حافظ الأسد قبل عقود ليست ذاتها التي وجدها عندما سمح له ابن شقيقه، الرئيس بشار الأسد، بالعودة إليها «مواطناً»؛ هي بلاد تغيرت بتحالفاتها الخارجية ودورها في الإقليم، واختلفت بتركيبتها و«إقامة» خمسة جيوش فيها.
قد تكون مشاهداته الأولى مع زوجاته وأبنائه وأحفاده في اليومين الماضيين لدمشق، في شوارعها وحواجزها وبيوتها ومسؤوليها ومكان إقامته القديم – الجديد في حي المزة، أيقظت ذاكرته وذاكرة مريديه عندما كان في قوته، ولوح من إحدى تلالها بـ«انقلاب» على شقيقه، وحاصر بوابتها، في منتصف الثمانينات.
دمشق التي أصدرت قبل 21 سنة إلى النقاط الحدودية تعميماً باعتقاله، في حال عاد من المنفى، «ترفعت» واستقبلته الآن كي يتفادى تنفيذ حكم محكمة فرنسية بالسجن 5 سنوات. والأيام وحدها ستفك «شفرة» العبارة التي سطرتها صحيفة «الوطن» أول من أمس، من أن رفعت عاد «دون أي دور سياسي واجتماعي»، ومدى «صرامة» هذا «التعميم» في الشوارع بين دمشق واللاذقية.

حافظ الأسد وشقيقه رفعت وعائلتهما
– «الشقيقان»… و«الأخوان»
رفعت (84 سنة) كان منذ صغره تحت تأثير شقيقه الأكبر الأقوى الذي يكبره بسبع سنوات. وفي 1952، وبعد 5 سنوات، سار على آيديولوجية شقيقه، وانضم إلى حزب «البعث». وأيضاً سار على دربه بالانضمام إلى الخدمة الإلزامية، ثم إلى وزارة الداخلية بعد الانفصال عن مصر عام 1961.
وفي مارس (آذار) 1963، سيطرت اللجنة العسكرية لـ«البعث» الذي كان شقيقه عضواً فيه على الحكم، فالتحق رفعت بالكلية العسكرية في حمص، وخدم بعد تخرجه إلى جانب شقيقه الذي كان آنذاك قائداً لسلاح الجو.
أولى «جولاته» العسكرية كانت مع سليم حاطوم في اقتحام مقر الرئيس أمين الحافظ في فبراير (شباط) 1966 لإسقاط أول حكومة «بعثية». وفي ظل الرئيس نور الدين الأتاسي الذي خلفه لثلاث سنوات، كُلف رفعت بقيادة وحدة خاصة أنشأتها اللجنة العسكرية لـ«الدفاع عن النظام»، بإمرة وزير الدفاع محمد عمران.
يقول مؤرخون إنه في نهاية الستينات، كان هناك مستويان للصراع: بين حافظ ورفعت من جهة، وبين صلاح جديد ومدير مخابراته عبد الكريم الجندي من جهة ثانية. وبين 25 و28 فبراير (شباط) 1969، نفذ «الأخوان الأسد» حركة عسكرية في دمشق، وتوغلت الدبابات في المدينة ضد أنصار الجندي وجديد. وشكل انتحار الأول في 2 مارس (آذار) 1969 لتجنب الاعتقال انتصاراً لرفعت. وفي 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 1970، قام الأسد بـ«حركة شاملة»، واعتقل الرئيس الأتاسي وصلاح جديد، وكُلف رفعت الأسد بمسؤولية تأمين دمشق.
أصبح رفعت قائداً لـ«سرايا الدفاع»، وهي قوة نخبوية من 40 ألف جندي، كانت بمثابة «جيش مستقل» لا يرتبط بأي شكل بالجيش. وترقى رفعت إلى قيادة الحزب، ووسع نشاطاته بين الطلاب والشباب والفتيات والإعلام، كما أسس «الرابطة العليا للخريجين» لتوحيد حملة الشهادات الجامعية، لتصبح ذراعاً طلابية موازية تابعة له.
وفي عام 1979، اندلع صراع بين النظام و«الإخوان المسلمين». وفي ديسمبر (كانون الأول) 1979، قال رفعت في مؤتمر «البعث» إن الوقت قد حان لـ«الرد بقوة»، ودعا الجميع إلى تقديم الولاء المطلق. ونُقل عنه قوله: «ضحّى ستالين بعشرة ملايين شخص للحفاظ على الثورة البلشفية، وعلى سوريا أن تفعل الشيء نفسه أيضاً للحفاظ على الثورة البعثية». وهدد رفعت بـ«خوض مائة حرب، وهدم مليون حصن، والتضحية بمليون قتيل» للحفاظ على النظام – الدولة، وأُطلق العنان في قمع الانتفاضة بين 1979 و1982 التي بلغت ذروتها في قصف حماة في فبراير (شباط) 1982. وفي عام 1983، أرسل «مظلياته» إلى دمشق بأوامر لنزع الحجاب عن النساء في الشوارع؛ الأمر الذي قوبل بانتقادات حادة دفعت شقيقه إلى إدانة ذلك علناً.
 \
\
رفعت الأسد يتحدث الى أنصاره (الشرق الأوسط)
– حافة الخطر
وعندما مرض حافظ الأسد، في نوفمبر (تشرين الثاني) 1983، بدا الأمر كأن لحظة رفعت المنتظرة قد حانت، وبدأ في العمل بصفته «وريثاً شرعياً»، فرأى أنه الخليفة الوحيد، وبدأ في حشد تأييد جنرالاته، ما أثار استياءً شديداً لدى الرئيس.
وحسب أوراق نائب الرئيس عبد الحليم خدام، التي اطلعت عليها {الشرق الأوسط}, في مارس (آذار) عام 1978، فإنه اجتمع بالأسد، وسط حملة شديدة على رفعت بين أوساط السوريين، وخلال «حديثنا عن الوضع، قلت له: الحملة كبيرة على رفعت، وهذه الحملة تضعف النظام، لذلك لا بد من معالجة وضع رفعت، فأجابني: رفعت مخرز في عيون الرجعية، فأجبته: سنرى في المستقبل سيكون مخرزاً في قلب من».
وبالفعل، كان رفعت يتدخل بشؤون الدولة، ويعطي توجيهات لرئيس الوزراء محمد علي حلبي الذي لم يكن يتجرأ على ردعه. ويضيف: «كان توجه الرئيس إلى توريث شقيقه، غير أن رفعت ارتكب خطيئة كبيرة عندما حاول الانقلاب على شقيقه خلال مرضه في نوفمبر (تشرين الثاني) 1983».
وخلال لقاء خدام بالأسد في منزله لمناقشة المشاركة في مؤتمر القمة في عمان نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 1980، قال الأسد: «أفكر في تعيين نائب للرئيس من أجل الاستمرارية، إذ إنه لا يعرف الإنسان متى يأتي الأجل».
وقدّر خدام (أبو جمال)، الذي كان وزيراً للخارجية وقتذاك، أنه يقصد رفعت بـ«الاستمرارية». غير أن محاولة رفعت الاستيلاء على السلطة خلال مرض أخيه «أسقطته من القائمة»، حيث يروي خدام أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1983، مرض الرئيس، و«جاءني مساء ذلك اليوم قائد الحرس الجمهوري عدنان مخلوف، وأبلغني أن الرئيس يريدني وهو في المستشفى. اعتقدت أنه تعرض لمحاولة اغتيال، فسألته: هل أصيب بالرصاص أو بقنبلة، فأجابني: أصابته أزمة قلبية، فذهبت فوراً إلى المستشفى، ودخلت غرفة الإنعاش، وكانت زوجته حاضرة. وسألته عن أزمته القلبية، فأجابني: تعبنا يا أبا جمال».
وفي اليوم التالي، كان من المفروض أن يزور سوريا الرئيس اللبناني أمين الجميل، فـطلب الأسد من خدام تأجيل الزيارة لـ«انشغاله في أمور داخلية». وعندما خرج من غرفة العناية المشددة، اتصل خدام برئيس الأركان في الجيش العماد حكمت الشهابي، وطلب منه المجيء إلى المستشفى، و«اتفقنا على اتخاذ إجراءات بمنع أي محاولة لتفجير الوضع في سوريا لأني كنت أخشى من رفعت».
يقول خدام: «في هذه الأثناء، دخل علينا رفعت، وكنت أتحدث بالهاتف مع سفيرنا في لندن الذي طلبت منه إرسال طبيب قلب فوراً، على أن يكون من أكفأ الأطباء، كما اتصلت بسفيرنا في واشنطن، وطلبت منه الطلب نفسه. وبعدما أنهيت كلامي، قال رفعت: «لماذا إحضار الأطباء من الخارج، هناك أطباء في سوريا؟ هل من الضرورة كلما مرض أي شخص أن نأتي بأطباء من الخارج؟، فأجبته: أخوك اسمه حافظ الأسد، وليس حافظ خدام، ومسؤوليتي أن أوفر كل الظروف لشفائه، لأني أعرف الفوضى التي ستنشأ (في حال غيابه)».
ويضيف أنه وقتذاك «جاءني السفير الأميركي، وأبلغني أن مبعوثاً أميركياً قادم إلى دمشق للاجتماع برفعت الأسد، فأجبته: لن نسمح له بالمجيء؛ في سوريا دولة، وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تتصل، يتم الاتصال مع الدولة التي أمثلها أنا بصفتي وزيراً للخارجية».
وبالفعل، في اليوم التالي، قامت كتائب من «سرايا الدفاع» بجولة في شوارع دمشق، كأن رفعت أراد أن يقول للناس: «أنا قادم»؛ يضيف خدام: «اجتمعنا في الأركان، أنا والعماد حكمت الشهابي و(وزير الدفاع) العماد مصطفى طلاس، واتفقنا على استدعاء فرقتين من خارج دمشق طوقتا دمشق، وتوترت الأجواء، لكن عندما عرف رفعت بالإجراءات، كما عرف بعض الضباط الكبار الذين بايعوا رفعت أن الرئيس حافظ تجاوز الخطر، تخلوا عنه، وأصبح معزولاً».

حافظ الأسد ووزير الدفاع مصطفى طلاس ورفعت الأسد (الشرق الأوسط)
– دبابة على الكتف
في تلك المرحلة، عقدت القيادة القطرية اجتماعاً، وفوجئ الجميع بأعداد كبيرة من «سرايا الدفاع» في الساحة الداخلية للقيادة، ثم جاء رفعت وطلب الحديث، فأعطاه الأمين القطري المساعد محمد زهير مشارقة الدور، فقال: «على القيادة الآن أن تطرد من الحزب كلاً من علي دوبا (مدير المخابرات العسكرية) وإبراهيم صافي (قائد القوات السورية في لبنان) وعلي حيدر (قائد الوحدات الخاصة) ومحمد خولي (مدير المخابرات الجوية) لأنهم يشتمونني؛ أنا شقيق الرئيس، ويجب أن أعامل كالرئيس. وإذا لم تتخذوا القرار، فإن قواتي ستنزل فوراً لتحتل دمشق».
تردد بعض أعضاء القيادة، وأخذ العماد مصطفى يخاطب رفعت ويقول له: «هؤلاء إخوانك، والمشكلة لها حل؛ تجتمعوا معاً». وهنا تدخل خدام، وخاطب رفعت: «تريد أن تعمل انقلاباً؟ تفضل. إذا كان كل ضابط لديه دبابات وعسكر يريد أن يركب على أكتافنا، فهذا الأمر خطير، والدبابات الموجودة عندك وتهدد بها ليست ملكاً لأبيك، تفضل تحرك». فازداد وجه رفعت غضباً، وقال: «أنا لم أقل هذا الكلام»، فأجبته: «الحديث مسجل».
وبعد الاجتماع، اتصل خدام هاتفياً بالرئيس، وأبلغه بما جرى، فقال: «سأدقق مع زهير مشارقة» الذي كان أميناً قطرياً مساعداً للحزب، وأضاف: «بعد دقائق، اتصل بي، وقال: زهير أعطاني صورة أخرى، وإن رفعت لم يتحدث بشيء يسيء أو يهدد»، فقلت له: «اسأل وزير الدفاع ورئيس الأركان؛ زهير من موالي رفعت. وبالفعل، بعد نحو ربع ساعة، اتصل بي، وقال لي: كلامك كله صحيح، وزهير إنسان لا يفهم وجبان وقد كذب علي».

الرئيس حافظ الأسد وشقيقه رفعت في يناير 1984 (أ.ف.ب)
– «أنا النظام»
وفي فبراير (شباط) 1984، بدأ حافظ الأسد بالرد، فأمر بالقبض على أحد أتباع رفعت، وهو مساعده الأمني العقيد سليم بركات، وبعث برسالة إلى رفعت عبر أخيه الآخر جميل، يقول فيها: «أنا أخوك الأكبر الذي عليك حق طاعته، ولا تنسَ أنني أنا الذي صنعتك».
وفي مارس (آذار) 1984، عين حافظ الأسد رفعت نائباً لرئيس الجمهورية، من دون أي مهام رسمية. وفي واقع الأمر، لم تكن هذه ترقية، وإنما كان يهدف إلى كبح صلاحيات رفعت عبر منصب سياسي بحت، حتى يكون تحت عين الرئيس طوال الوقت. وقد أُحيلت مهامه الأمنية، بصفته قائداً لـ«سرايا الدفاع»، إلى العقيد محمد غانم.
ويروي خدام أن الأسد «دعا القيادة القطرية إلى اجتماع في مطلع مارس (آذار) 1984، وأبلغ القيادة بأنه قرر تعيين 3 نواب للرئيس، وسيصدر القرار لأنه من صلاحياته، وليس من صلاحيات القيادة القطرية، وأعلن أسماء الذين سيعينهم نواباً له على النحو التالي: رفعت الأسد، وزهير مشارقة، وعبد الحليم خدام. فقلت له فوراً: لا أريد أن أكون نائباً للرئيس، ولا في أي موقع حكومي أو حزبي».
ويضيف: «أنهى الاجتماع، ودعاني إلى مكتبه، وسألني: لماذا اعترضت؟ فأجبته: كيف تضع رفعت وزهير أمامي؟ رفعت كان يجب أن يكون في السجن، وليس نائباً أولاً للرئيس، وزهير عندما كنت قيادياً في حزب البعث كان في الصف الخامس الابتدائي؛ لقد عملت كل جهدي لخدمة بلادي، ولن أمارس أي عمل في الدولة أو في الحزب، فأجاب: تعالَ وتولى منصب الأمين القطري، وهو الأمين القطري المساعد، فأجبته: لم يعد في ذهني أي عمل، وودعته وذهبت إلى المنزل».
ويستطرد: «وبعد نحو ساعة، تحدث معي، وطلب مني أن أعود، فعدت إليه، حيث استقبلني ضاحكاً بعبارة: أنت عنيد، وأبلغني أنه أصدر مرسوماً بوضعي أولاً، ورفعت ثانياً، وزهير ثالثاً. فسألته: ماذا سيعمل نائب الرئيس؟، فأجابني: ستكون مسؤولاً عن السياسة الخارجية، وبالفعل أصدر المرسوم، وقبلت».
وفي 30 مارس (آذار) 1984، رد رفعت على هذه الخطوة، وأمر جنوده بالدخول إلى دمشق، مع أوامر واضحة بالاستيلاء على السلطة، وقد تمركزوا في نقاط استراتيجية في جميع أنحاء دمشق ومحيطها، وهي نقاط يسهل منها قصف المدينة. وقد واجهت قوات رفعت الأنصار الموالين للرئيس، وهم رجال مثل علي حيدر من القوات الخاصة، وعدنان مخلوف من الحرس الجمهوري.
وكتب باتريك سيل، مؤلف سيرة الأسد، بعنوان: «الأسد: النضال من أجل الشرق الأوسط»: «لو أن الجانبين وجها ضربات في العاصمة، لكان الدمار عظيماً جداً، ولشوهت صورة النظام على نحو لا يمكن إصلاحه، هذا إذا نجت دمشق على الإطلاق». وأضاف: «لقد ترك (حافظ) الحبل لرفعت بما يكفي لشنق نفسه».
كان حافظ يرتدي البزة العسكرية الكاملة، يرافقه نجله الأكبر باسل الذي سيصبح اليد اليمنى لوالده إلى حين وفاته بحادث سيارة بداية 1994. وقد قاد سيارته من دون حراس في العاصمة لمواجهة رفعت في مقر قيادته العسكرية. ويروى وزير الدفاع مصطفى طلاس، في منشور «ثلاثة أشهر هزت سوريا»: «اتصل العميد عدنان مخلوف قائد الحرس الجمهوري، وقال إن السيد الرئيس قد توجه بمفرده إلى مقر شقيقه رفعت الأسد (في ضواحي المزة)، وأعطاه (أي عدنان مخلوف) التوجيه التالي: إذا لم أعد بعد ساعة من الآن، قل للعماد طلاس أن ينفذ الخطة (بمواجهة قوات رفعت)».
«هل تريد إسقاط النظام؟» سأله حافظ، واستطرد: «ها أنا ذا؛ أنا النظام!». تجادلا، ثم عرض الرئيس على شقيقه مخرجاً، متعهداً باحترام كرامته ودعم مصالحه، والخروج الآمن إلى منفى يختاره، ولن يُقبض عليه.
وفي أواخر أبريل (نيسان) من عام 1984 «بدأ العميد رفعت يشعر بأن ميزان القوى قد مال لصالح شقيقه الرئيس لدرجة لم تعد تسمح له بالحركة إطلاقاً، فاتصل بشقيقه جميل الأسد، ليمهد له المصالحة مع أخيه، وأنه جاهز لأي عمل يرتئيه. وكان الرئيس الأسد ينتظر بفارغ الصبر انهيار رفعت ورضوخه للسلطة، وقد نجح في لعبة عض الأصابع. ومن هذا المنطلق، أعلم شقيقه جميل بالموافقة على طلب قائد سرايا الدفاع… وبدأت المفاوضات الصعبة».
وتم الاتفاق على أن تعود «سرايا الدفاع» لتوضع بتصرف هيئة العمليات في القوات المسلحة، وأن يبقى العميد رفعت نائباً لرئيس الجمهورية مسؤولاً (نظرياً) عن شؤون الأمن. كما تم الاتفاق على أن يسافر معه إلى موسكو ضباط كبار.
وفي 28 مايو (أيار) 1984، توجهت طائرة إلى موسكو مليئة بأكبر ضباطه (بمن فيهم رفعت) لفترة تهدئة، ثم تم استدعاؤهم واحداً تلو الآخر إلى سوريا، وترك رفعت وحيداً في المنفى.

رفعت الأسد في اجتماع حزبي في دمشق (الشرق الأوسط)
– «أخي لا يحبني»
وقبل مغادرته سوريا، نظم رفعت مأدبة كبيرة لأصدقائه، وقال: «يبدو أن أخي لم يعد يحبني؛ عندما يراني يعبس، لكني لست عميلاً أميركياً، ولم أتآمر ضد بلدي… لو كنت أحمق، لدمرت المدينة بأكملها، لكني أحب هذا المكان. رجالي هنا منذ ثمانية عشر عاماً، والناس معتادون علينا؛ إنهم يحبوننا، والآن يريد هؤلاء المغاوير طردنا».

حافظ الأسد ونجله باسل وشقيقه رفعت (الشرق الأوسط)
وقد عاد رفعت إلى سوريا عام 1992، بناء على رغبة والدته التي توفيت في ذلك العام. وفي عام 1994، عزى شقيقه حافظ عندما توفي نجله باسل، لكنه سُرح في وقت لاحق من العام نفسه من منصبه في الجيش، واستمر في شغل منصب نائب الرئيس، قبل أن يعفى لاحقاً.
وفي عام 1999، شارك أنصاره في معركة بالأسلحة النارية ضد القوات الحكومية في اللاذقية. وقد أنشأ محطة فضائية في لندن، في سبتمبر (أيلول) 1997، كما أسس حزبه الخاص في أوروبا، برئاسة نجله سومر الأسد، داعياً إلى التغيير السياسي، الأمر الذي قوبل بنقد من معارضين وموالين.
وعندما توفي الرئيس حافظ، في 10 يونيو (حزيران) 2000، أصدر بياناً حداداً عليه، وادعى أنه الوريث للرئاسة، غير أن نداءاته لم تلقَ آذاناً صاغية، وأمر نائب الرئيس خدام باعتقال رفعت، إذا حاول حضور جنازة الرئيس في 13 يونيو (حزيران).

رفعت الأسد ونجله دريد في دمشق بعد عودته إليها يوم الخميس (فيسبوك)
وبعد اندلاع الاحتجاجات في ربيع 2011، اتخذ رفعت موقفاً ضد النظام، وتولى ابنه رئبال نشاطات سياسية علنية، لكن حضوره تراجع، إلى أن ظهر رفعت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في القنصلية في باريس لانتخاب الرئيس، ثم بعث برقية تهنئة للأسد بـ«إعادة انتخابكم»… إلى أن عاد يوم الخميس.
نستهل جولتنا في الصحف البريطانية من مجلة الإيكونوميست التي نشرت تقريرا حول إثيوبيا بعنوان “أبي أحمد يتحدى العالم”و “يتمادى في سياسات تعزل إثيوبيا وتفقدها أصدقاءً ونفوذا دوليين”.
ولفتت المجلة إلى أن الأشهر الأولى من عهد رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي كانت قد شهدت إصلاح العلاقات مع المعارضة وتوقيع اتفاق سلام مع إريتريا عام 2018، ما رشحه لجائزة نوبل للسلام 2019.
لكن سرعان ما ضربت إثيوبيا اضطرابات عرقية، وتراجع اقتصاد البلاد، واندلعت نيران حرب أهلية مدمرة بإقليم تيغراي في الشمال.
ورصدت الإيكونوميست احتفالية “باذخة” نُظّمت يوم الرابع من الشهر الجاري في قلب العاصمة أديس أبابا، حيث أدى أبي أحمد اليمين الدستورية لولاية جديدة مدتها خمس سنوات عقب انتخابات أجريت في يوليو/تموز الماضي.
ورأت المجلة في الاحتفالية “ردًا” من جانب أبي أحمد على المتسائلين عن شرعيته، وعلى رأسهم جبهة تحرير شعب تيغراي المنخرطة في حرب ضد الحكومة المركزية.
ولكن صدى هذا “الردّ”، بحسب الإيكونوميست “خالطتْه أصواتٌ معارضة تمثلت في مقاطعة انتخابية حالت دون إجراء التصويت في نحو خُمس الدوائر الانتخابية في إثيوبيا”.
وتضيف أنه “لا عجب في ظل ذلك أن يحرز حزب الازدهار الذي يتزعمه أبي أحمد 90 في المئة من المقاعد”.
الاحتفالية أيضا قصدت توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي؛ حيث العلاقات بين إثيوبيا وعدد من الدول الغربية في أدنى مستوى لها منذ عقود، بحسب المجلة.
وأشارت الإيكونوميست إلى تهديد واشنطن الشهر الماضي بفرض عقوبات على مسؤولين إثيوبيين ضالعين في الحرب في منطقة تيغراي ما لم تشرع الأطراف المتقاتلة في تسوية أو تسمح بمرور المساعدات الغذائية إلى ملايين تحاصرهم القوات الحكومية.
ورصدت المجلة تحذيرا أطلقته الأمم المتحدة مؤخرا من مغبّة موت مئات الآلاف جوعا. فما كان من أبي أحمد إلا أن طرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، بدعوى التدخل في شؤون بلاده الداخلية.
وقالت الإيكونوميست إنه “لا يكاد يمضي أسبوع دون أن تندد أديس أبابا بما تزعم أنه تدخل أجنبي”. ورصدت المجلة “سيلاً من نظريات المؤامرة يتدفق عبر وسائل الإعلام الحكومية الإثيوبية مفاده مثلاً أن أمريكا تدعم جبهة تحرير شعب تيغراي”، أو أن “وكالات الأمم المتحدة تهرّب إليها الأسلحة”، وما إلى ذلك من اتهامات طالت حتى منظمات مثل أطباء بلا حدود.
وقارنت المجلة بين خطاب “براغماتي” كانت تتحدث به إثيوبيا في الماضي وكان يكسبها أصدقاء ونفوذًا دوليين، وخطاب “شائك” تتحدث به أديس أبابا حاليا تبدلت معه الصورة تماما.
ورأت الإيكونوميست أن قرارات اتخذها أبي أحمد على صعيد السياسة الخارجية “أدت إلى تدهور علاقات أديس أبابا مع منظمة إيقاد الأفريقية، وإلى تردّي العلاقات مع السودان على نحو قاد إلى مصادمات حدودية، فضلا عن تراجع العلاقات مع الغرب”.
لا تلوموا نيوكاسل
وفي صحيفة الصنداي تايمز، نطالع مقالا للكاتب رود ليدِل بعنوان: “لا تلوموا نيوكاسل؛ فاللعبة كلها مبنية على الأموال المشبوهة والملطخة بالدماء”.
ورصد الكاتب حشودا من جماهير نيوكاسل يونايتد الإنجليزي “تحتفل باستحواذ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على النادي”.
وقال رود ليدِل إن “كل مشجعي كرة القدم، وهو من بينهم، مضلَّلون. على أنه من الإنصاف القول إن مشجعي نادي نيوكاسل أكثر ضلالا من غيرهم؛ فلم يرِد عليهم أي مالك أو مدير للنادي جيد بما يكفي”.
وأضاف الكاتب أن مشجعي نيوكاسل “فرحون بمغادرة مالك النادي السابق مايك آشلي، الذي كانوا يبغضونه رغم أنه حافظ على بقاء النادي، لكن ذلك غير كاف … وأغلب الظن أن المدير الفني ستيف بروس -وهو رجل مهذب ومدرب جيد- سيغادر أيضا رغم أنه دافع عن بقاء النادي في الدرجة الأولى، لكن ذلك أيضا لا يكفي هؤلاء المشجعين”.
وتابع رود ليدِل بالقول إن “فرحة المشجعين لم تتأثر بحقيقة أن الأمير السعودي الذي استحوذ على النادي هو طاغية يشبه حكام العصور الوسطى، ويشرف على قتل وتعذيب واضطهاد معارضيه”.
ورأى الكاتب أنه من “دواعي الإنصاف القول إن الوصف نفسه ينطبق على رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليغ، والتي اعتمدت، والسعادة تغمرها” هذا الاستحواذ رغم شكاوى من زعيم حزب العمال كير ستارمر ومن خطيبة جمال خاشقجي الذي “قضى عليه ولي العهد بوحشية”، على حد تعبير صاحب المقال.
وأشار ليدل إلى أن “سلطات كرة القدم الإنجليزية تجري فحوصا ‘مناسبة’ للمتقدمين للحصول على ملكية النوادي. لكن كلمة ‘مناسبة’ تعني من وجهة نظر تلك السلطات أن هؤلاء المتقدمين للحصول على الملكية لديهم أرصدة كبيرة من الأموال في البنوك”.
ومضى الكاتب قائلا: “وفي ضوء هذه الترجمة لعبارة ‘فحوص مناسبة’، يعتبر كل من آل كابوني، و بينيتو موسوليني، وكيم جونغ-أون مؤهلين جميعا لامتلاك نيوكاسل”.
وتابع بالقول: “من أجل ذلك أتعاطف مع هؤلاء المشجعين المحتفلين؛ فالكثير من نوادينا البارزة يديرها مجرمون، وطغاة من العالم الثالث، وشركاء لهؤلاء الطغاة، فلماذا إذن يجب أن يختلف الأمر مع نيوكاسل؟”
وأضاف ليدل: “كانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز سعيدة جدا بالسماح لرئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا بامتلاك مانشستر سيتي؛ وقد أدين شيناواترا بعد ذلك في تُهم فساد، ثم ما لبثت ملكية النادي أن انتقلت إلى الشيخ منصور، وهو مستبد آخر قادم من الصحراء – هذه المرة من الإمارات العربية المتحدة”.
ورأى الكاتب أن “سلطات كرة القدم الإنجليزية لم تجد مشكلة في تملّك الإيطالي ماسيمو سيلينو نادي ليدز يونايتد، رغم إدانته في جريمة ووصْف محكمة له بأنه رجل “ذو ميول إجرامية واضحة … ولديه مقدرة على التوسّل بكل أنواع الخداع لبلوغ غاياته”.
ونوّه ليدل إلى أن “رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي متهم بغسيل الأموال. وكارسون يونغ الذي كان مالكًا لبرمنغهام سيتي مدان في تهم ذات صلة بعصابات صينية”.
وخلص الكاتب إلى القول بأنه “لا الجهات المسؤولة ولا المشجعين يكترثون بمصادر أموال المتقدمين لملكية النوادي، وذلك لأن من يرغبون بشكل أساسي في شراء نوادي كرة القدم يكونون على هذه الشاكلة، فضلاً عما أسهمت به أموال هؤلاء من نجاح كبير للبريميرليغ”.
بوابة جيدة للمشاركة في المشهد السياسي
ونطالع في صحيفة الإندبندنت أونلاين تقريرا لمراسلتها في الشرق الأوسط، بِل ترو، عن الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق.
وتجرى هذه الانتخابات قبل سبعة أشهر من موعدها، في محاولة لتهدئة المتظاهرين الغاضبين. غير أن ناخبين في مدينة الناصرية، جنوب شرقي البلاد، يرون أن الانتخابات لن تغيّر شيئا، بحسب ما نقلت عنهم بِل ترو، ومن ثم فهم يفضلون مقاطعة تلك الانتخابات.
وكان إجراء هذه الانتخابات مطلبا أساسيا تردّد في احتجاجات تشرين التي اندلعت في أكتوبر 2019. وهذه الانتخابات هي الخامسة من نوعها منذ سقوط نظام صدام حسين بعد غزو بقيادة الولايات المتحدة قبل نحو 18 عاما.
ويقسّم قانون الانتخابات الجديد العراق إلى 83 دائرة انتخابية ويحول بين الأحزاب والقوائم الموحدة. ويرى خبراء أن هذا القانون وإن كان لا يخلو من مثالب، لكنه كفيل بإرخاء قبضة الأحزاب السياسية الكبرى على المجلس التشريعي.
وفي ذلك، تنقل الكاتبة عن المحلل السياسي مهند عندنان قوله: “قانون الانتخابات الجديد يمثل بوابة جيدة للعراقيين للمشاركة في المشهد السياسي، وهو أفضل من القوانين الانتخابية السابقة التي كانت تقسّم البلاد إلى 18 دائرة انتخابية فقط، فضلاً عن تقليصه الحد الأدنى لأعمار المرشحين إلى 28 عاما”.
غير أن عدنان يستدرك، قائلا إنه يعتقد مع ذلك أن هذه الانتخابات لن تثمر أي تغيير حقيقي؛ وأن شخصيات بعينها ستظل تقبض على زمام السلطة التشريعية في العراق. ويتفق عدنان في ذلك مع المحتجين في الناصرية.
ويتوقع كثيرون انتصارات كاسحة للحركة الصدرية على غرار ما حدث في انتخابات 2018. وقال مرشحو الحركة في الناصرية للإندبندنت أونلاين إنهم يطمعون في مضاعفة مقاعدهم في البرلمان.
وتسجّل البطالة في الناصرية واحدا من أعلى معدلاتها في مدن العراق، كما أن البنية التحتية في المدينة من بين الأسوأ في البلاد.
وأعرب متظاهرون في الناصرية للصحيفة عن أملهم في أن تكون حركة مقاطعة هذه الانتخابات قوية، وأن يكون إقبال الناخبين ضعيفا بحيث لا تنجح العملية الانتخابية (رغم أن القانون العراقي لا يضع نصاب مشاركة معيّن لنجاح الانتخابات).