
«كتابٌ يوقظ فينا الحنين، وشيئاً من الأمل». هكذا وصف الأديب العالمي أمين معلوف كتاب سامي مروان مبيّض الجديد «سكّة الترامواي: طريق الحداثة مرّ بدمشق»، الذي يصدر عن «دار رياض نجيب الريّس»، في بيروت، مطلع شهر سبتمبر (أيلول).
هذا هو التعاون السادس بين مبيّض و«دار الريّس»، بعد سلسلة من المؤلفات عن تاريخ مدينة دمشق المعاصر، بدأت سنة 2015 بكتاب «تاريخ دمشق المنسي». وجاء بعدها «شرق الجامع الأموي»، ثم «غرب كنيس دمشق»، وصولاً إلى «عبد الناصر والتأميم» و«نكبة نصارى الشام»، سنة 2020.
في هذه الكتب، يركز مبيّض جهوده على كشف النقاب عن جوانب مهمة من تاريخ مدينته؛ سواء كانت غائبة أم مغيبة. وهذا ما يفعله في كتابه الجديد، حيث يطرح سؤالاً: «هل كانت دمشق مستعدة للتغيير؟ وهل قبلت به عن قناعة؟ هل كانت فعلاً مدينة كلاسيكية محافظة غارقة في إرثها التاريخي، أم مدينة متجددة ومنفتحة على كل جديد؟ وأخيراً، هل كانت دمشق مُتعصبة أم أنها كانت متسامحة مع شبابها وصباياها في الربع الأخير من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين؟».

«الحداثة»، ومعركة التغيير في المجتمع السوري من نهايات القرن التاسع عشر، ولغاية منتصف القرن العشرين، عنوانان أساسيان في الكتاب. و«معركة التغيير» شنّت على ثلاث جبهات بين ثلاثة مكونات اجتماعية: بين الشباب المتعلّم وآبائهم المحافظين، بين الرجل والمرأة، وبين العلمانيين ورجال الدين. عليه، «تنوّعت منصّات الصراع وكثرت أمكنته: في الأزقة والحارات، داخل المنازل، في المساجد، في حرم جامعة دمشق، على خشبات المسارح، في ملاعب كرة القدم، وداخل الأحزاب والأندية والصحف».
يأتي هذا الكتاب لتسليط الضوء على كل هذه التجارب، بما لها وما عليها، بنجاحاتها وفشلها، مع إشارة إلى أنها بقيت تجارب متفرقة لا تلبي رغبات بعض المتنورين بإحداث تغيير حقيقي في المجتمع، وذهبت كلها أدراج الرياح، بسبب الانقلابات العسكرية التي عصفت بسوريا منذ سنة 1949.
يقع الكتاب في 416 صفحة، فيها كثير من الصور النادرة، منضوية تحت قسمين: الأول يحكي تجربة التغيير في السياسة والمجتمع منذ عهد الملك فيصل الأول (1919 – 1920) إلى انفصال سوريا عن مصر سنة 1961. الثاني يتناول «معركة التغيير» في مجالات الفنون والثقافة منذ سبعينات القرن التاسع عشر، التي وُلدت على يد رائد التمثيل في سوريا ومؤسس مسرح «الميوزيكال»، أبي خليل القباني.
ويقول مبيّض إنه اختار «سكّة الترامواي» عنواناً لكتابه نظراً للحياة الجديدة التي وُلدت في دمشق بفضل شبكة النقل العام التي ظهرت خارج أسوار المدينة القديمة ابتداء من عام 1907. ساهمت هذه شبكة مع الكهرباء التي دخلت دمشق في نفس السنة، في إنشاء أحياء كاملة خارج أسوار دمشق القديمة، ظهرت تباعاً على طرفي خط مسير الترامواي، بالتزامن مع إنشاء عدد من المدارس والمستشفيات و«معهد الطب»، الذي شكّل نواة الجامعة السورية فيما بعد.
ترافق كل ذلك مع هجرة عدد من الشباب لدراسة الطب والهندسة والقانون في جامعات أوروبية، حيث سكنوا في عمارات طابقية، وعاشوا في مجتمعات تشرب من ينابيع مختلفة. وبعد عودتهم إلى مدينتهم، وجدوا أن بعض أبنية دمشق باتت مماثلة لما شاهدوه في المهجر. وشاهدوا، أيضاً، شبكة شوارع رئيسية تصل بينها ساحات صغيرة تليها شوارع فرعية منظمة. وفي هذه الأحياء الجديدة شيّدت أبنية طابقية على الطراز الأوروبي. «هجر» الكثير من أولاد الميسورين بيوت أهلهم في دمشق القديمة ليسكنوا في هذه الشقق الجديدة… «الأوروبية».
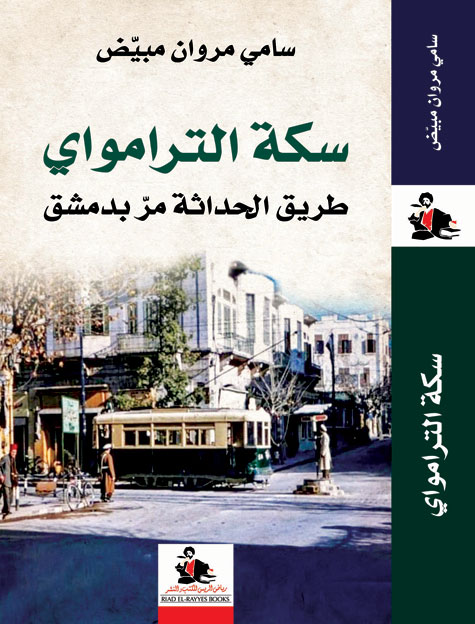
في هذه الأحياء الجميلة والحديثة والمنظمة، ظهر جيل جديد من السوريين، مختلف عن الآباء والأجداد، «متحرر» في أفكاره ولباسه وسلوكه، متأثر بطرق العيش الأوروبية، حيث عاد هؤلاء «من دراستهم الجامعية في أوروبا مرتدين القبعة بدلاً من الطربوش، والبنطال بدلاً من القمباز المقصّب». عادوا إلى مدينتهم حاملين أفكاراً أجنبية عن الدين والدولة والمجتمع، رافعين راية العلمانية في حياتهم الخاصة وفي تربية أولادهم. وقد انتقلت هذه «الأفكار التحررية» من منازلهم إلى أماكن عملهم، في دوائر الدولة وفي الجامعات ومكاتب الصحف والمحاماة، وصولاً إلى النوادي والمقاهي، ومن ثم إلى الأحزاب السياسية التي قاموا بإنشائها في مرحلة الاستقلال. إذ يقول: «لولا سفرهم واطلاعهم على تجارب الآخرين لما كان هذا التحول في حياتهم، ولولا الحداثة في العمران وطرق العيش، لما انعكست هذه الأفكار على بيوتهم وعاداتهم وتجربتهم الحياتية».
البداية إذن كانت مع «الترامواي» وكل الأحياء الحديثة التي وُلدت من حوله وبسببه، والتي أصبحت معقلاً لشباب دمشق وصباياها مع سقوط الحكم العثماني سنة 1918.
وقد عبر الكاتب أمين معلوف عن ذلك في تعريفه عن الكتاب، قائلاً: «من مآسي مشرقنا أن الحداثة الاجتماعية والفكرية، التي تبدو في يومنا هذا بعيدة المنال، بدأت تسري قبل أجيال في عروق أبنائه وبناته، بفضل رواد مبدعين كان في وسعهم أن يحوّلوا هذه البقعة من العالم إلى منارة حقيقية للتقدم والحضارة. هذا ما يرويه لنا سامي مبيّض في عمله الرائع عن دمشق».
الكتاب وثق محاولات فردية وعامة للتنوير في العاصمة السورية. بعضها كان فاشلاً وبعضها نجح في ترك البصمات. هنا الأهمية الأولى لهذا الكتاب. أهمية أخرى، تأتي من أنه يضع «معركة التغيير» في سوريا، في العقد الأخير، في سياق تاريخي، وإن كان هذا النص يركز على البعد الاجتماعي والتنويري لـ«معركة دمشق»، وليس الجوانب السياسية في «المعركة» الحالية ومآلاتها الاجتماعية والسياسية والثقافية في شوارع دمشق وباقي الأنحاء السورية.




