لاحظت مؤخراً أن بعض العقول أصبحت جافة، والقلوب ناشفة أكثر من اللزوم. ولذلك لا بد من ترطيب الأجواء عن طريق بعض القصص والأشعار. ولنتحدث عن صريع الغواني.
فمن هو هذا الشاعر غريب الشكل يا ترى؟ لقد جذبني إليه منذ البداية اسمه أو بالأحرى لقبه: «صريع الغواني»! وأعجبت بهذا الاسم أيما إعجاب. ثم غبطته عليه، بل وحسدته كل الحسد، وإن كان الحسد ليس من شيمي. على أي حال رحت أتساءل بيني وبين نفسي: كيف حظي بهذا الاسم الساحر دون سواه؟ والأنكى من ذلك أنه بعد الاطلاع المفصل على سيرته الذاتية وجدت أن الرجل كان خاشعاً وقوراً على عكس ما نتوقع. ولم يكن صريع الغواني إلى الحد الذي نتصوره. فمسلم ابن الوليد، وهذا هو اسمه الحقيقي، لم يكن أبا نواس! ومعلوم أنه كان معاصراً له وللعباس بن الأحنف وبشار بن برد وأبي العتاهية إلخ… فمن أين جاءه هذا الاسم يا ترى؟ كيف لصقت به هذه التهمة التي يُحسد عليها؟ يقال بأنه ألقى مرة قصيدة يمدح فيها الخليفة هارون الرشيد، وقد ورد فيها هذا البيت:
وما العيش إلا أن تروح مع الصبا
صريع حميَا الكأس والأعين النجل
فقال له الخليفة على الفور: أنت صريع الغواني! فذهبت مثلاً ولصقت به. وهذا يعني أن الخليفة كان ذواقة للشعر العربي. كيف لا وهو هارون الرشيد؟
ولكن يقال بأن هناك سبباً آخر لتلقيبه بذلك هو أبياته التي يقول فيها صراحة:
إن ورد الخدود والحدق النجل
وما في الثغور من أقحوان
واعوجاج الأصداغ في ظاهر الخد
وما في الصدور من رمان
تركتني بين الغواني صريعاً
فلهذا أدعى صريع الغواني
تلاحظون أن كلمة الأعين النجل وردت أكثر من مرة لديه. فما معنى ذلك يا ترى؟ معناه: الأعين الواسعة الجميلة التي تدوخ العقل. وأكاد أقول الأعين الكحلاء من دون كحل. إضافة من عندي وأنا بها فخور. وربما كانت صحيحة. ولا تسألوني عن معنى هذه العبارة الفاتنة: «واعوجاج الأصداغ في ظاهر الخد»، فهي أعلى مني ومنكم بألف مرة! كلمة اعوجاج قد تغشكم وتوهمكم أنها كانت تعاني من تشوه في ظاهر الخد، ولكن العكس هو الصحيح. «الاعوجاج» هنا قيمة جمالية من أعلى طراز.
ويقال بأنه تنسك في أواخر حياته وزهد. بل وعاش حياة عائلية مستقرة وهادئة حتى وفاة زوجته التي رثاها بكل حرارة وحرقة. وبكاها بكاءً مراً مثلما فعل جرير من قبله. فكيف يمكن لشخص عاقل ومحترم كهذا أن يدعى صريع الغواني؟
ثم هل نسيتم قصيدة جرير في زوجته وتلك الأبيات التي لا تنسى:
لولا الحياء لهاجني استعبار
ولزرت قبرك والحبيب يزار
ولهت قلبي إذ علتني كبرة
وذوو التمائم من بنيك صغار إلخ…
كم أكبرت جرير بسبب ذلك؟ كم زاد عندي قيمة وأهمية بل وعظمة. كنت أحسبه فقط هجاء ضد الفرزدق، فإذا به شخص آخر. لاحظوا كيف يتفجع عليها تفجعاً. نقول ذلك، بخاصة أنها ذهبت شابة، وخلفت وراءها أطفالاً صغاراً… تحية للأمهات اللواتي يذهبن شابات، مبكرات، قبل الأوان. ألف تحية. وبضعة آلاف من الحسرات! ولكن هذا قضاء الله وقدره. لا راد لمشيئته. ويبدو أنه كان من أوائل من تجرأوا على البكاء على الزوجة، ورثائها، لأن ذلك غير مستحب عند العرب أو غير مألوف، بل إنه مستهجن ومستنكر جداً. ماذا؟ أرجل يبكي على زوجته؟ أعوذ بالله، لا يليق. أولاً الرجال لا تبكي. وثانياً لا تبكي على النساء! عيب. فضيحة.
إذن الرجل لا يبكي على المرأة، حتى ولو كانت زوجته وأم أطفاله، بل ولا يليق به أن يزور قبرها! أما هي فتزور قبره كل يوم جمعة. لحسن الحظ، فإن الأمور تغيرت واستعادت المرأة العربية أخيراً كرامتها في عصر الحداثة والتقدم والتطور.
بالمناسبة جرير كان أيضاً صريع الغواني. أليس هو القائل:
يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به
وهن أضعف خلق الله إنسانا
في الواقع كلنا صريع الغواني بشكل أو بآخر… وبالتالي فهذا المصطلح الرفيع يخترق الشعر العربي كله من أوله إلى آخره: من امرئ القيس إلى نزار قباني.
ألم يقل امرؤ القيس:
أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل
وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
أغرك مني أن حبك قاتلي
وأنك مهما تأمري القلب يفعل
وماذا عن ابن زيدون الذي لوعته تلك اللعوب الفاتنة ولادة بنت المستكفي، وأذلته حتى مسحت به الأرض؟ لاحظ كيف يستعطفها، كيف يستجديها، كيف يبوس الأرض من تحت قدميها لكي تعود ولكن هيهات…
والله ما طلبت أهواؤنا بدلاً منكم
ولا انصرفت عنكم أمانينا
نكاد حين تناجيكم ضمائرنا
يقضي علينا الأسى لولا تأسينا
إلى آخر تلك الأبيات الخالدة..
بل وراح يطمع برؤيتها فيما وراء الضباب… راح يلاحقها إلى عالم الماورائيات الميتافيزيقية… فإذا كانت قد أفلتت منه في هذا العالم، فإنها لن تفلت في العالم الآخر:
إن كان قد عز في الدنيا اللقاء بكم
في موقف الحشر نلقاكم وتلقونا
حب حتى الموت، بل وما بعد الموت: حب أقوى من الموت!
تحية لابن زيدون وألف تحية…
ثم تضيف الروايات: صحيح أنه أقبل على اللهو واللذة والطرب في بداية شبابه. ولكنه لم ينغمس في المجون انغماس أبي نواس وبشار بن برد وابن الضحاك الخليع وسواهم. وفي أواخر حياته نهر أحدهم قائلاً: «لا تدعني صريع الغواني أرجوك: فأنا لست كذلك». وكان يلقب بهذا اللقب وكان له كارهاً. ويقال بأنه قذف بشعره السابق في البحر عندما كان يتغزل أكثر من اللزوم.
وهكذا خسرنا قسماً كبيراً من غزلياته وأشعاره الأولى. لقد أراد أن يكفر عن ذنوبه، ويفكر في آخرته بعد أن كبر وتقدم في السن. ولكن لحسن الحظ بقي منه شيء كثير ومنه هذان البيتان:
نقاتل أبطال الوغى فنبيدهم
ويقتلنا في السلم لحظُ الكواعب
وليست سيوف الهند تفني نفوسنا
ولكن سهام فُوقت بالحواجب
والغريب العجيب هو أنه لم يكن أول من لقب بصريع الغواني. فقد سبقه إلى ذلك الشاعر القطامي المتوفى سنة 747 ميلادية، أي قبل ولادته بعشر سنوات. وسبب اللقب هو أنه قال:
صريعُ غوانٍ راقهن ورقنه
لدنْ شبَ حتى شاب سودُ الذوائب
وهو بيت من قصيدة مطلعها:
نأتك بليلى نية لم تقارب
وما حب ليلى من فؤادي بذاهب
دوخناكم بالشعر! وبعض الشعر يدوخ، سامحونا! لا تنسوا: أنتم الآن في أحضان الشعر العربي وبساتينه الغناء ورياضه الفيحاء. وهي بساتين معشوشبة، مخضوضرة: المياه تسقسق، والطيور تغرد، والربيع منتشر على مد النظر.
وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فدعوني أروي لكم هذه النادرة الجميلة التي تعبر عن شخصية العرب في العمق. أولاً أطرح عليكم هذا السؤال: من قائل هذه الأبيات:
نحن قوم تذيبنا الأعينُ النجلُ
على أننا نذيب الحديدا
وترانا يوم الكريهة أحراراً
وفي السلم للغواني عبيدا
نأسر الأُسد ثم تأسرنا الغيد
المصونات أعيناً وخدودا
إنه الفارس البطل أبو فراس الحمداني. القصة وما فيها هي أنه كان يحاصر إحدى مدن الروم في بعض غزواته. فعرضت عليه فتاة باهرة الجمال نفسها مقابل أن يفك الحصار عن أهلها ومدينتها. فأرجعها إلى أهلها سالمة وفك الحصار دون أي مقابل. ولكن هناك رواية أخرى أكثر زركشة وجمالاً تقول: عندما حاصر أبو فراس المدينة كانت فيها امرأة ذات حسن وجمال.
فقالت لأهلها: أنا أكفيكم أمره. فتبرقعت وخرجت نحو العسكر، وقالت: أبلغوني الأمير. فأبلغوها إليه، فقالت: ألست أنت القائل: نحن قوم تذيبنا الأعين النجل إلخ..؟ فقال نعم: فنزعت البرقع عن وجهها، وقالت: أحُسْناً ترى أم قبحاً؟ فقال: والله لا أرى إلا الجمال. فقالت: ما حق المولى على عبده؟ فقال: السمع والطاعة. فقالت: ارحل عنا وانصرف راشداً. ففك الحصار فوراً، وأمر جنوده بالعودة إلى الوراء سر.
فقالوا له: يا أمير المدينة في أيدينا تقريباً! لماذا تريدنا أن ننصرف بعد أن أوشكنا على أخذها؟ دعنا نفتحها. فقال لهم: لا مجال للبقاء ساعة واحدة هنا. لقد أعطيت كلمتي بعد أن أفحمتني هذه الغادة الحسناء. والله لن أتراجع عن قراري.
ويبدو أنه وقع في حبها حتى الموت. ثم وصل إليها لاحقاً، وخطبها، وتزوجها، وعاش معها حتى فرق بينهما غراب البين. وعندما طلع الصباح سكتت شهرزاد عن الكلام المباح.
وفي رواية أخرى أيضاً: عندما نزعت البرقع عن وجهها، صعق فوراً، فداخ، فانهار، فوقع مغشياً عليه…
أخيراً قد تتساءلون: من هو إذن صريع الغواني الحقيقي في الآداب العربية كلها؟ بصراحة لا أرى أحداً اللهم إلا عمر بن أبي ربيعة، ولكن مع فارق أساسي: وهو أنه كان صارع الغواني لا صريعهن. نقطة على السطر! حتى في موسم الحج كان يترصد لهن. وأحياناً في أمسيات الصيف المنارة بضوء القمر كان يصطاد إحداهن فتقع المسكينة في الفخ، كما لو غصباً عنها.
يعيش الشعر العربي.
إيطاليا… «الحجر الإبداعي» مقابل «الحجر الصحي»

لدى الإيطاليين مثل يقول «الحياة مثل الضوء، إنها إشعاع وعطاء»، إلا أنهم الآن يدركون أن هذه الحياة هشّة إلى حدّ أنّ أصغر فيروس يستطيع أن يُفقدهم إيّاها. لقد كشف فيروس كورونا هشاشة الإنسان، وفقدانه لتوازنه أمام الرعب من النهاية، وعيش العزلة التي يسببها الحجر الصحي. إن لحظات الإحساس باليأس والعزلة توقظ الغرائز الأكثر بدائية عند البشر، وهذا ما يجعل الحَجر المُطلق مؤلماً جداً، وصعباً جداً، ويكاد يكون بغيضاً جداً، وهو ما يجعل الترفيه أمراً لا غنى عنه، فهو يساهم بتعديل وقت الإنسان، من وقت الموت والجنائز، إلى وقت الأمل.
وفي الوقت الذي ينتشر هذا الوباء بسرعة فائقة، ويحول مدناً بأسرها مثل ميلانو التي تعتبر مدينة الصناعة والثقافة الإيطالية إلى مدينة أشباح، ومعها عشرات المدن الشمالية، فإن إيطاليا المنكوبة تفرج عن نفسها بعناد لتتعامل مع جنون العالم ومعالجته بالفرح.
تحشد إيطاليا التي قلدتها في تجربتها، كل من فرنسا وبلجيكا وألمانيا، بتسخير كل مؤسساتها الثقافية العملاقة، وتطويعها، لتحقيق الأهداف الكبرى المتمثلة بضرورة تواصل مسيرة الحياة من خلال تسخير الإرث الثقافي والفني، السمعي والبصري، لمعظم الناس المحجورين في منازلهم، ليكونوا على تواصل مجاني مع أهم النتاجات والعروض الراقصة والموسيقية والغنائية. لقد ابتدعت إيطالياً طقوس «الحجر الإبداعي» مقابل «الحجر الصحي» الذي يفرضه فيروس كورونا على الكوكب بأسره، ويشلّ دولاً بأكملها من المطارات إلى المتاجر والمدارس والجامعات، وصولاً إلى دور العبادة والملاعب والنوادي والملاهي والمسارح ودور العروض الثقافية الفنية ودور السينما، رغم بشاعة الظروف، من أجل استعادة التواصل والتضامن. وهو واحد من الأساليب التي يقاوم عبرها البشر الذعر، بإطلاق روح السخرية، وإعادة تفكيك حالة الخواء والضعف البشريين في مواجهة عدو متغطرس وشرير.
البديل الذي سارعت إليه المراكز الفنية، التي تنتشر في جميع المدن الكبيرة والصغيرة، مثل حبات الفطر، هو الالتزام ببرامجها من خلال فتح مواقعها الإلكترونية، والقيام بعروضها بدون جمهور، لتجعل كل شيء في حياة الفن متواصلاً بإعطاء مسرة الرؤية الجميلة، وديمومة التذوق الجمالي عند الناس. ومن خلال هذه المنصات الإلكترونية الرسمية والأهلية، التي يسهل الدخول إليها بالمجان، فتخرج الناس من الانزواء والاعتزال إلى عالم يضج بالحيوية والاندهاش والمتعة الحقيقية.
الإيطاليون يعتقدون أن بلدهم ببره وبحاره، وإرثه الفني العظيم الذي يحتل نسبة تزيد على الـ40 في المائة من إرث العالم، لكل البشر، ليست لشعب دون آخر، وأن لكل إنسان نصيباً من هذا الكوكب الأزرق، ولا حق لأحد بأن يرفع جدراناً، خصوصاً في وجوه الخائفين أو الجائعين أو المرضى أو المهاجرين.
تقول لنا الروائية الإيطالية المعروفة داتشا مراييني، في اتصال تليفوني معها، إن تقدير عامة الناس ينطوي في جانب منه على مُغالطة في قراءة التاريخ، وصورة ذلك أننا قد نسينا حقيقة أنّه يمكن أن تظهر أوبئة تكون عنيفة ومعدية تجعل كل فرد يُراعي وحدته بصفتها سلاحه الأمين في الدفاع عن نفسه ضد مواطنيه، الذين يحتمل أن الوباء قد أصابهم أو قد يُصيبهم، وأنهم مؤهلون ليسكنهم، على الرغم من أن لا أعراض ظهرت عليهم، مع ذلك فقد صرنا لا نثق في بعضنا، ونشك في كل سليم معافى أنه سوف يُصاب بالفيروس ولو بعد حين».
وتضيف الروائية الإيطالية: «بعد هذه التجربة القاسية مع (كوفيد 19)، سوف تعود البشرية بعد دفن موتاها إلى ما كانت عليه، تصخب في أمكنة اللهو، والمطارات والمواصلات، ودور العرض، وأمسيات الشعر، والأفراح، والمهرجانات. إنها تشبه خلية نحل تتعرض لخطر خارجي، فتعلن حالة الطوارئ، وتختفي عن الأعين، إلى أن يزول الخطر، ليعود طنينها كما كان، ولكن هل تكون هذه التجربة الأليمة عبرة في المستقبل، للدول العظمى، كما للصغرى، وللغنية كما للفقيرة، وللأفراد والمجموعات، كما للدول، ولجميع الأعراق والديانات، وللإنسان عموماً في كل مكان؛ هذا الإنسان المتحضّر والمتفوّق جداً، الذي يضطر اليوم إلى أن يعزل نفسه رغم أنفه ليحميها من فيروس ينتشر بفعل العولمة».
آلاف المتاحف وآلاف الغاليريات والمئات من دور السينما والمسارح ودور الأوبرا خالية الآن، إلا أن العديد منها لم توقف مواعيد برامجها المثبتة، بسبب عدم وجود الجمهور، بل أصرت على ضرورة الذهاب إلى الجمهور، من أجل إبراز اللحظات الاستثنائية لجماليات الحياة، متبعة نظام التواصل الإلكتروني (أونلاين)، باعتباره نافذة مؤقتة يستكين المتلقي لعذوبة نسيمها. نحو 47 فعالية عروض فنية ضمن برنامج بلدية في مدينة روما وحدها لهذا العام، ستظل برامج افتتاحها محتفظة بمواعيده، من خلال منصة خاصة ببلدية العاصمة، جنباً إلى جنب، عشرات المسرحيات التي ستبث للجمهور مجاناً، ومعارض في مدينة ميلانو بؤرة الفيروس، مثل معرض «مي آرت» ومعرض «توت غنخ آمون»، ستفتح أبوابها على شاشات البيوت من خلال منصة وزارة الكنوز الثقافية، وافتتاح ترميم جداريات كنيسة «سانتا ماريا ديلا فالي» في مدينة ماتيرا، وكاتدرائية «كوّلاماجو» في مدينة لاكويلا. عشرات الفعاليات الموسيقية داخل الكنائس والقاعات المخصصة في عدة مدن إيطالية، التزمت بتقديم فعالياتها في مواعيدها ونقل فعالياتها مباشرة لجمهورها الإيطالي والأوروبي، جنباً إلى جنب عروض الأزياء، والقيام بنصب عشرات الشاشات السينمائية في الأحياء الفقيرة والساحات لعرض أفلام سينمائية إيطالية من أفلام الواقعية الإيطالية الجديدة. وهناك أيضاً قراءات شعرية من منازل الشعراء، ولقاءات مع كتاب ومثقفين من منازلهم مباشرة، بالإضافة إلى تقديم برامج تعليمية للأطفال في تأكيد جديد على قوة العقل البشري، والرغبة القوية في الحياة والتواصل الإنساني والحضاري، على الضد من المشككين من بعض الأحزاب السياسية الذين يستغلون أوقات المحن.
أخبار ذات صلة
يوميات كامل الشناوي… ولع بالجمال و«البحث في كل شيء»

شغلت نبوءات نهاية العالم الشاعر والكاتب المصري الراحل كامل الشناوي، في ستينيات القرن الماضي؛ تلك التي كانت تخرج نائحة كل حين، فتتساءل بلسان: «هل ينتهي الكون حسب نبوءات المنجمين في عالم يثير التنبؤ بنهاية العالم اهتماماً كاسحاً بين البشر، يستوي في ذلك الأشقياء والسعداء. فالشقي يريد أن يعيش إلى أن تتاح له السعادة، والسعيد يريد أن يعيش لأنه سعيد»، هكذا يقول في واحدة من يومياته التي نشرتها جريدة «الجمهورية» عام 1962، ووردت ضمن عشرات اليوميات التي تم جمعها في كتاب «يوميات كامل الشناوي» الصادر أخيراً عن دار «الكرمة» للنشر بالقاهرة.
يفتتح كتاب «يوميات كامل الشناوي»، الذي يقع في 548 صفحة، بوصية الشاعر الراحل كامل الشناوي إلى الكاتب الصحافي أحمد رجب، التي نشرها في جريدة «الأخبار» في أكتوبر (تشرين الأول) 1962، ويقول نصها: «أنت يا صديقي أحمد تصغرني بعشرين عاماً على الأقل، وستعيش بعدي، وعندما تحترق سيجارة حياتي، ويرشف القدر آخر نفس فيها، فاهرع إلى بيتي، وخذ ما تجده من أوراق وانشره على الناس، وما أقوله لك ليس مداعبة، ولكن وصية أسجلها هنا علناً وعلى رؤوس الأشهاد».
بعد وفاة كامل الشناوي، لم يتمكن أحمد رجب من تنفيذ وصيته، ولكنه حاول، حيث انتقل مأمون الشناوي للإقامة في بيت شقيقه بعد وفاته، وقال له إنه سيتكفل بجمع أوراقه المبعثرة التي دوّن فيها شقيقه خواطره وأشعاره، وقام مأمون بنشر عدد من الإصدارات مع «دار المعارف» تجمع بعضاً من هذه الخواطر، لكن في هذا الكتاب نقبت المُحررة رحاب خالد في جهات الأرشيف «المُهمل» عن أبواب اليوميات التي نشرها الشناوي على مدار 35 عاماً قضاها في الصحافة، والتي لم تنشر من قبل، تشمل بعض الخواطر العاطفية التي كتبها في مجلة «آخر ساعة» في الفترة من 1946 – 1948، علاوة على ما كتبه في باب «يوميات»، وهو الباب الذي واظب على كتابته ما بين أعوام 1953 – 1965، وتتضمن مشاهداته الخاصة، وتُطل فيها مصر بشوارعها وناسها وفنونها في الخمسينيات والستينيات.
يُعبر كامل الشناوي عن فهمه ومشاعره إزاء كلمة «يوميات»، بقوله: «عندما أكتب اليوميات أحس أني أخاطب صديقاً أحبه ويحبني. فأنا أبثه شكواي، وأعرض عليه مشكلاتي، وأسرد أهم ما صدفني في يومي، وأكون معه كما أنا، كما ينبغي أن أكون. فهو يراني ضاحكاً وعابساً، يحس يأسي ورجائي، يشعر بقوتي وضعفي». وفي ضوء هذا التعريف تُنشر في هذا الكتاب لأول مرة يوميات نشرها كامل الشناوي في صحف «الأخبار»، و«أخبار اليوم»، و«الجمهورية» خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.
يُخصص الكتاب فصلاً عن سيرة الشناوي (1965 – 1908)، وهي سيرة تستعرض محطات حياته تتضمن اقتباسات من انطباعاته الخاصة حول مولده وصباه وسنوات عمله الأولى في الصحافة، بداية من ولادته بقرية نوسا البحر بمحافظة الدقهلية، وتنقله بين المحافظات في سنوات طفولته المبكرة، وتأثره بالنشأة في بيئة دينية، فوالده الشيخ سيد الشناوي القاضي الشرعي، وجده لأبيه الشيخ سيد أحمد الشناوي عالم الدين، مروراً باختباره المُبكر للوحدة والعزلة، التي كان أحد أسبابها هيئته الممتلئة، وما صاحبها من سخرية أصدقائه من ضخامته، يقول: «بدأت أفضل الشارع الخالي من المارة، والدكان الخالي من الزبائن، والقهوة الخالية من الرواد. ولكن هذا النقص الذي شعرت به هو الذي دفعني إلى الرغبة في التفوق من أجل أن أتميز بشيء عن باقي الأطفال. وكانت العزلة هي فرصتي في تنمية حبي الذي ظهر نحو القراءة والأدب والشعر بوجه خاص».
غير أن سنوات الشباب بدلّت الأحوال، بعدما لاحظ رفاقه خفة ظله الشديدة وطبيعته الساخرة، وحضوره الطاغي «فشملوني بتقديرهم، ورفعوا عني الإحساس بالنقص، وجمعنا حب الفن». وكانت آراؤه في الفن والأدب والسياسة جديرة بالاهتمام ما دفعه لمراسلة الصحف في فترة متقدمة، حتى أنه بدأ حياته العملية في الصحافة في النصف الثاني من عام 1930 وكان وقتها في العشرين من عمره، بلا مؤهل دراسي. يقول الكتاب: «فقط كان قارئاً جيداً للأدب وذاكرته تحتفظ بكثير من الشعر القديم والحديث»، ولميوله الوفدية آنذاك كانت أولى محطاته مع جريدة «كوكب الشرق» ذات الاتجاه الوفدي، التي عمل فيها مصححاً أدبياً، حتى صار محرراً للصفحة الأدبية بعد ثلاثة أشهر فقط.
تتوالى الأيام، ويقرر الشناوي الاستقلال عن حزب الوفد وكل الحياة الحزبية، وظل حريصاً على استقلاله برأيه الذي لازم محطاته التصاعدية في الحياة الصحافية والفنية، وظل حريصاً على رعاية المواهب الفنية الجديدة في الشعر والأدب والكاريكاتير. يقول «ولست أتكلف ذلك، فأنا مولع بالجمال وأبحث في كل شيء. والفنان الجديد جمال جديد… وليس قليلاً أن أعثر على جديد في الجمال، وأتغنى به، وأسلط عليه الأضواء العالية».
تقترب اليوميات التي يضمها الكتاب، من فلسفة الشناوي في الحياة التي لا يمكن قراءتها بمعزل عن شاعريته، نُشاركه حواراً عابراً تُغلفه الرومانسية، يجمعه بسيدة جميلة مثقفة في قطار متجه للإسكندرية، ونتعرف من رؤيته للموت، على الزُهد، وأسئلة المصير التي تقوده كثيراً لتشاؤم يغرق في بئره طويلاً، ففي واحدة من يومياته يقول «اتهمني أصدقائي بأني إنسان متشائم، أنظر إلى الحياة من خلال منظار أسود، أرى الورد والشوك معاً، فلا أفرح بالشوك لأن له ورداً، وأحزن للورد لأن له شوكاً. والواقع أني لا أريد أن أتفاءل أو أتشاءم، ولا أن أبكي أو أغني. وإنما أردت أن أعبر عن شعوري بالحياة فأنا أحياها ولا أعرف لماذا أحياها؟ إن الحياة مشكلة لم أستطع أن أحلها ولا أن أتجاهلها، ولا أقوى على مواجهتها ولا أدري كيف أفر منها».
تُطل من يومياته وجوه لأشهر كُتاب وموسيقيي مصر في هذه الفترة، محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، وكمال الملاخ، وإحسان عبد القدوس، وعبد الحليم حافظ وغيرهم. ومن مطارح الطفولة يلتقط الشناوي الكثير من المشاهد، في سينمائية ورومانسية مقتبسة من الشوارع والطرقات، يقول في واحدة من يومياته «وما زلت حتى هذه اللحظة أرمق بعين الإعجاب والحسد شاباً كان تردد على الدكك الخشبية في ظل الأشجار الكثيفة ومعه فتاة تلتف بملاءة سوداء، وكم تمنيت وأنا طفل صغير، لو يتاح لي يوماً أن أجلس كما يجلس، وأن تكون لي مثله فتاة أتبادل معها الحديث، والذرة المشوية، والفول السوداني، واللب والترمس، وأفتح لها زجاجة كازوزة تشرب نصفها، وأشرب نصفها، ثم أتمشي معها على الكورنيش، فإذا اعترض أحد خلعت الجاكت واشتبكت معه في معركة أستعمل فيها يدي ورأسي وقدمي وأنتصر عليه، ثم أمضي ومعي فتاتي وكأن شيئاً لم يحدث».
لا ينفصل استدعاء الشناوي لفيض الطفولة، عن سائر تأملاته في فصول العمر، وصولاً للشيخوخة وأشباحها، يقول في نص بعنوان «الشتاء»: «لقد أصبح الشتاء بغيضاً إلى نفسي، أستقبله في بيتي وكل النوافذ مغلقة، وألقاه في الطريق وأنا في غاية الاحتشام، ألقاه بالبالطو، والكوفيه، والبذلة السميكة، وعلى صدري صوف، وفي قدمي صوف. وما من مرة واجهته إلا صفعني في وجهي، أو ركلني في ظهري، أو ألهب جسدي بالسياط. وأقول للطبيب ما هذه الصفعات والركلات فيقول لي: لا صفعات ولا لكمات، هذا فقط برد، وزكام، وروماتيزم، والتهاب في الأعصاب. فما الذي أغرى الشتاء بي؟ أخشى أن أقول الشيخوخة المبكرة فيقول متشائم! ولكي أكون متفائلاً فلأقل إن الشباب الذاهب هو الذي أغرى الشتاء بي. ويا ويلتي إذا تقدم بي العمر وأصبحت نهباً للشتاء، والصيف، والربيع، والخريف».
وكتب في واحدة من يومياته التي نُشرت في جريدة «أخبار اليوم»، في يونيو (حزيران) عام 1965، قبل 7 أشهر فقط من وفاته، تحت عنوان «الكلمة صارت مشكلتي»: «طال حنيني إلى التعبير عن مشاعري وأفكاري بالكلمة. فمنذ أصابني المرض في أواخر العام الماضي، وأنا أشعر بعجزي عن تسجيل انفعالاتي بالألفاظ والحروف. كم من خاطر يختلج في نفسي فأحاول أن أجعل له وجوداً بأن أعبر عنه، فإذا تعبيري ناقص وغامض. وقد أفهم التعبير برغم نقصه أو غموضه، ولكن صعوبة ليست في أن يفهم الكاتب ما يكتب، وإنما الصعوبة في أن يفهم القراء ما يعنيه الكاتب لكي يعيشوا معه أحاسيسه وخواطره. فمن غير هذه المشاركة العاطفية والفكرية بين الكاتب والقارئ، تصبح الكتابة صوتاً بلا صدى».

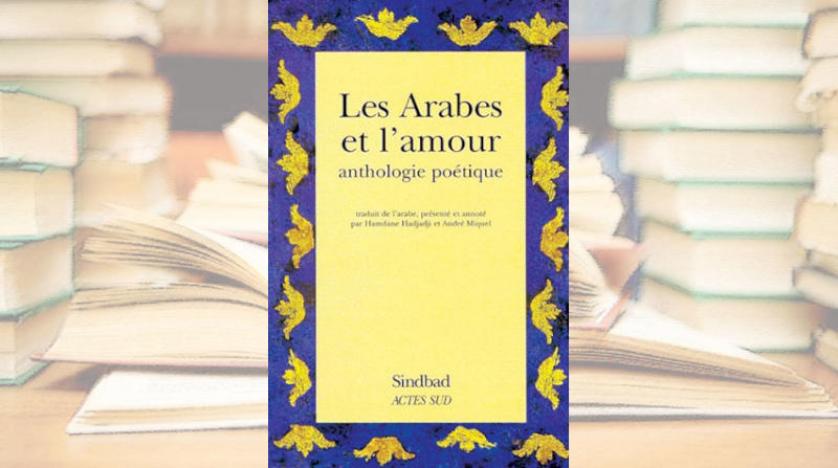









التعليقات