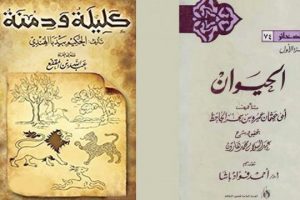كلاهما آثر في عمقه عدم اللقاء بالآخر رغم أن الأمر لم يكن متعذراً
قد تكون العلاقة التي جمعت بين مي زيادة وجبران خليل جبران، واحدة من أغرب العلاقات العاطفية التي ربطت بين كاتبين، وأكثرها التباساً ومحلاً للجدل والقراءات المختلفة. إذ ندر أن شهد التاريخ المديد للعشق، علاقة عاطفية بين طرفين اقتصرت تعبيراتها على تبادل الرسائل لفترة تقارب العقدين من الزمن، دون أن يعمد أي منهما إلى هدم العائق الجغرافي والتقدم بوصة واحدة باتجاه الآخر. لكن هذه الغرابة بالذات، هي التي جعلت منهما محل متابعة العشرات من النقاد والباحثين، بحيث وُضعت حولهما عشرات الكتب والأطروحات، ولم تُترك نأمة صغيرة من حياتيهما إلا وتمت متابعتها بالتفصيل.
وإذا كان جبران مديناً فيما حققه من مكانة وحضور إبداعيين، لأمه كاملة رحمة التي اتخذت قرارها الشجاع بترك الأب المتسلط والمدمن على الخمرة وحيداً في بشري، والهجرة مع أولادها الأربعة بطرس وجبران وسلطانة ومريانا إلى أميركا، فهو لا يخفي الدور الموازي الذي لعبته نساء أخريات في حياته القصيرة الحافلة، حيث ورد في إحدى رسائله إلى مي زيادة «أنا مدين بكل ما هو أنا للمرأة، منذ كنت طفلاً وحتى الساعة. المرأة هي من فتحت النوافذ في بصري والأبواب في روحي. ولولا المرأة الأم والمرأة الشقيقة والمرأة الصديقة، لبقيت هاجعاً مع هؤلاء النائمين الذين يشوشون سكينة العالم بغطيطهم».
إلا أن المتتبع لحياة جبران العاطفية لا بد أن يلاحظ أنه إزاء شخصين متغايرين تماماً، أحدهما يصوب باتجاه الجسد الغرائزي، والآخر باتجاه الروح والتوهج المثالي للأنوثة الكونية. وإذ يكشف ميخائيل نعيمة في كتابه عن جبران، أن هذا الأخير أقام في مراهقته علاقة جسدية محمومة مع امرأة أميركية متزوجة من تاجر جلود، كانت تتردد عليه ليرسمها، فإن نعيمة يسرد الحدث بأسلوب من الغمز المشوب بالإدانة المبطنة، علماً بأن الإنسان في الصبا لا يأبه بالمعايير الأخلاقية السائدة، بل بتحقيق ذاته وإثبات هويته الذكورية.
وكما يظهر جبران في صورة أخرى مناقضة من خلال العلاقة الرومانسية الحالمة التي أقامها أثناء إقامته في بيروت مع حلا الضاهر، التي أطلق عليها في «الأجنحة المتكسرة» اسم سلمى كرامة، ما يلبث أن يقع فريسة شغفه المشبوب بالأميركية ميشلين ذات الجمال المغوي، التي عرفته بها ماري هاسكل، قبل أن تصل علاقتهما إلى طريق مسدود، ليس فقط لأن جبران لم يرغب في الزواج منها، بل لأنه لم يكن قادراً على خيانة هاسكل، التي لم يكن من دون رعايتها ودعمها ليقف على قدميه. أما علاقته بماري فتتخذ طابعاً ملغزاً وشديد الإبهام. ففي حين يرى البعض أن جبران قد وجد في ماري، التي تكبره بعشر سنوات، أمه الرمزية البديلة، يبدو جبران في قرارته وكأنه منشطر نصفياً بين إبقاء ماري، ذات الجمال المتواضع، في خانة الصداقة والحدب الإنسانيين، وبين الزواج منها بدافع تأنيب الضمير أو التعبير عن الامتنان.
وسط البلبلة العاطفية التي عاشها جبران في فترة شبابه، كان يمكن للرسالة التي وصلته من مي زيادة عام 1912، والتي تعرب فيها عن إعجابها الشديد بقصته «مرتا البانية»، أن تكون حدثاً عابراً في حياته، كما في حياة الكاتبة اللبنانية التي تشاء المفارقات أن تدين انطلاقتها الفعلية في عالم الأدب لجبران نفسه، حيث تسبب إلقاؤها المميز لكلمته في حفل تكريم خليل مطران عام 1913، في لفت أنظار الوسط الثقافي المصري إلى نبرتها الواثقة وحضورها الآسر. فما الذي دفع الطرفين إلى الدخول في مغامرة عاطفية نظرية استمرت عقدين من الزمن، في حين كانت نساء عديدات تتنافسن على قلب جبران، وكان عشرات الكتاب المصريين والعرب يتسابقون بالمقابل للوصول إلى صالون مي الأدبي، وإلى قلبها فيما بعد؟
والواقع أن مثل هذا السؤال لم يكن ليغيب عن بال الكتاب والباحثين، الذين عاينوا العلاقة عن كثب، أو قاربوها من موقع الدرس والتمحيص والتحليل النفسي، وبينهم ميخائيل نعيمة الذي يمر بشكل عارض على الرسالة التي وصلت جبران من فتاة شرقية لم يسمّها، متحدثاً عن شعور صديقه بالزهو والغبطة إثر قراءة الرسالة، وملمحاً إلى أن جبران لم يشأ اللقاء بالفتاة، تجنباً «لإفساد ما تبقى من براءته، أو الابتلاء بالمزيد من التجارب».
وإذ يُفترض بالرسائل التي تبادلها الطرفان أن تكون المرجع الأهم في تبيان حقيقة العلاقة وطبيعتها، فإن هذه الرسائل تندرج في خانتين اثنتين، فكرية وعاطفية، مع الإشارة إلى اتسام الأولى بالجرأة النقدية والغنى المعرفي، فيما تدرجت الثانية من البوح الخفر والموارب، إلى الاعتراف بالحب والمكاشفة العاطفية الصريحة. وحيث تعمد مي إلى امتداح السرد الجبراني في «الأجنحة المتكسرة»، إلا أنها تبدي تحفظها على موقفه السلبي من الزواج، وعلى تسويغه للخيانة حتى ولو كان الحب دافعها الوحيد. وفي «دمعة وابتسامة» تأخذ مي عليه «لهجته المضطربة وأفكاره الصبيانية». وإذ تمتدح كتابيه «المواكب» و«المجنون»، لا تتوانى رغم إعجابها بالكتابين عن القول: «في كلا الكتابين أكاد أتبين تأثير نيتشه، وإن كانت بسمة التهكم الفني الدقيق التي نراها عند جبران لن تشبه أبداً ضحكة نيتشه ذات الجلبة الضخمة المزعجة». والأرجح أن تعلق جبران العاطفي بمي، هو الذي دفعه إلى أن يتقبل برحابة صدر «حديثها العلوي المتراوح بين العذوبة والتعنيف». إلا أن جبران، من جهة ثانية، لم يتردد في مكاشفة مي بما يرى فيه تعزيزاً لدورها ومكانتها الأدبيين، فيحثها على استثمار مواهبها في ما هو أبعد من النقد الأدبي والاجتماعي، قائلاً لها: «أو ليس الابتداع أبقى من البحث في المبدعين؟ ألا ترين أن نظم قصيدة أو نثرها، أفضل من رسالة في الشعر والشعراء؟».
أما الجانب العاطفي من العلاقة فهو يبدو، رغم تطوره المطرد من الصداقة الفكرية باتجاه الحب، أقرب إلى ما أطلق عليه جبران اسم «النشيد الغنائي» أو «إنشاد المنادى»، بتعبير هايدغر، أو مناجاة المثال الأفلاطوني الموزع بين المطلقيْن الأنثوي والذكوري. ففي حين يكتب جبران لمي «أستعطفك أن تكتبي إليّ بالروح المطلقة المجردة المجنحة التي تعلو فوق سبل البشر»، تكتب له من جهتها «لما كنت أجلس للكتابة كنت أنسى من أنت وأين أنت. وكثيراً ما أنسى أن هناك رجلاً أخاطبه، فأكلمك كما أكلم نفسي».
اللافت في الأمر أن رد فعل مي على عرض جبران الزواج منها، لم يختلف كثيراً عن رد فعل ماري هاسكل، حيث نظرت المرأتان إلى العرض بوصفه مجاملة أخلاقية فرضتها علاقته الوثيقة بكل منهما. ومع أن زيادة لم تقدم على الزواج من رجل آخر، كما فعلت ماري، إلا أنها كتبت له رداً على عرضه: «لقد تكاتبنا كصديقين مفكرين، ولو كنت سعيداً بالصداقة مثلي لما كنت رميت إلى أبعد من ذلك». إلا أنها ما تلبث أن تكتب لاسترضائه عام 1921: «أريد أن تساعدني وتحميني وتبعد عني الأذى ليس بالروح فقط بل بالجسد أيضاً». ثم تخلع عنها بعد ذلك رداء الخفر لتخاطب جبران بقولها: «ما معنى هذا الذي أكتبه؟ إنني لا أعرف ماذا أعني به، ولكنني أعرف أنك محبوبي وأني أنتظر الحب كثيراً، وأخاف أن لا يأتيني بكل ما أنتظر».
ومع ذلك فإن جبران الذي وعد مي بأن يزورها في القاهرة، أو يلتقي بها في أوروبا، لم يفِ بوعوده أبداً، بما جعل منسوب الرسائل بينهما يتضاءل بشكل تدريجي. والأرجح أن خيبة مي من جبران قد أسهمت في توطيد علاقتها بالعقاد، كما يكشف خالد غازي في كتابه «جنون امرأة»، مستشهداً بقولها لهذا الأخير: «إن ما تشعر به هو نفس ما شعرتُ به نحوك منذ أول رسالة كتبتها إليك». وإذ تخاطبه بمكر أنثوي لافت: «الآن عرفت لماذا لا تميل إلى جبران»، تضيف قائلة: «لا تحسب أني أتهمك بالغيرة من جبران، فهو في نيويورك لم يرني ولعله لن يراني، كما أنني لم أره إلا في الصور».
والأرجح أن كلاً من جبران ومي لم يكن يرغب في عمقه بلقاء الآخر أو الارتباط به، لأن ذينك اللقاء والارتباط كانا سيسقطان العلاقة من سدة الحلم إلى رتابة الواقع وسقمه وفساده. وكان لا بد من أن تحول قارات ومحيطات شاسعة دون عناقهما المباشر، لكي يتكفل المتخيل بالأمر، وتقوم اللغة مقام الذراعين. والأنفاس المحمومة ونبض القلب. ولعل المآل المأساوي لمصيريهما المتباعدين، هو الذي وفر لحبهما «الافتراضي» ما يلزمه من عناصر الأسطورة. فمع رحيل جبران المبكر بفعل تفاقم أمراضه، كان جسد مي النضر وعقلها المستنير يترنحان تحت مطرقة الزمن القاسي وغدر الأقارب وتخلي الأصدقاء. وحيث كان الكثيرون يرون في مي صورة المرأة الحالمة ذات الشفافية المفرطة والذكاء المتوقد، ظلت صورة جبران مثاراً للجدل والتباين والتأويلات المختلفة. وحدها الشاعرة الأميركية باربارا يونغ، رفيقة سنواته الأخيرة، ألحت على تنزيهه عن كل دنس وإلحاقه بمصاف الأولياء والقديسين، هاتفةً بعد رحيله بمحبيه الكثر:
الشاعر ينام، لكنه لا ينام
بل خرج يمشي في الفضاء
ويركض في الريح
لا تُسمّوا احتضاراً عناقه الغمامة
لا تُسموا موتاً ذهابه الى الشمس
ها هو، قاصداً نجمة الصبح
يرسم الأثير شموساً وأقماراً
ويبلغ بيته هناك، في قلب العاصفة