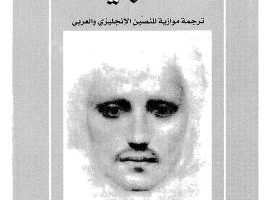يقولون إن من الحب ما قتل، لكن هل يمكن أن يكون من الأدب ما قتل؟ هل من الممكن أن يموت شخص بسبب رواية كتبها؟
يشكل هذا السؤال جوهر الحبكة الدرامية في رواية «تانجو إسطنبول» الصادرة أخيراً عن دار «العربي» بالقاهرة للروائية التركية أسمهان أيكول، ترجمة نعمة هانئ الأتربي. تدور الأحداث حول «كاتي هيرشل» التي أوقعتها نبوءة عرافة في تحقيق جديد أشعل فضولها المستمر. صحافية شابة تسقط مغشياً عليها في مقهى عام، حادث بسيط، لكن «كاتي» ترى فيه أشياء مريبة وغامضة، ويدفعها فضولها وبحثها إلى الدخول في كواليس عالم السياسة، بما فيه من تسجيلات وعمليات ابتزاز واغتيالات وعصابات. وتستمر في تتبع خيوط الجريمة لتكشف عن علاقات غرامية وخيانة زوجية وأعمال غير مشروعة.
تتدفق الرواية في سرد لاهث بحثاً عن إجابة لجريمة غامضة، وتطرح عدداً من الأسئلة. من أبرزها؛ هل هي جريمة انتقام أم استغلال أم انتحار؟ وإذا كان عدد من أقارب وأصدقاء وأحباء الضحية مشتبهاً بهم جميعاً، فمن الجاني؟
ولدت المؤلفة «أسمهان أيكول» في مدينة «أدنة» بتركيا عام 1970، ألفت كثيراً من الروايات، أشهرها سلسلة أدب الجريمة «كاتي هيرشل»، وبطلتها كاتي صاحبة مكتبة روايات الجريمة التي تحب التحقيقات. صدر لها ضمن تلك السلسلة «فندق البوسفور» و«بقشيش» و«الطلاق على الطريقة التركية». تخرجت «أيكول» في كلية الحقوق بجامعة إسطنبول، وحصلت على الماجستير في الحقوق من جامعة «هامبولت»، وهي الآن تعيش في إسطنبول وبرلين.
ومن أجواء الرواية نقرأ:
«بدأنا في الصعود إلى الطابق الرابع على سلم ضيق للغاية، تهتز جنباته كلما وطئته قدماي، وأيادينا متمسكة بالدرابزين، الذي يتأرجح وكأنه سينخلع في يدنا. ما الذي أتى بي إلى هنا؟ ضربت الجرس، فتحت الباب شابة يتدلى تحت فمها لغد كبير وترتدي (تي شيرت) كبيراً، مقاس (إكس إكس لارج). أخذت أحملق إليها لوهلة، ثم استجمعت نفسي سريعاً.
– أتينا لقراءة الفنجان، لدينا موعد.
صاحت بأعلى صوت وهي تنظر إلينا:
– أميييي هل لديك موعد؟
انتظرنا على الباب معاً قرابة ثلاثين ثانية، وعندما لم يأتِ ردّ، قالت:
اخلعا أحذيتكما وادخلا
إذا سنحت لي فرصة تغيير شيء واحد من عادات أهل الشرق، فثقوا تماماً أنها عادة خلع الأحذية عند دخول المنزل، فمنظر الناس وهم يتجولون بالجوارب غير لطيف بالمرة، أضف إلى ذلك أنه انتهاك واضح للحقوق. هل لدي رغبة في التبسط ورفع الكلفة بيننا لدرجة أن أستعرض جواربي أمامهم؟ لكن بالطبع لا أحد يهمه رأيك، لذا لم أعد أتبرم، ولكن عبس وجهي، وهذا من أجل خاطر (فوفو) فقط. ما أن وقعت عيناي على المرأة الجالسة مستندة بمرفقيها إلى طاولة الطعام بالصالة حتى نسيت كل شيء، السيدة لا هي بالقبيحة ولا المستفزة ولا المرعبة، بل كانت غريبة لدرجة أنني كنت مستعدة لدفع المال، ليس لقراءة الفنجان، وإنما خصوصاً لرؤيتها. كانت تشبه الغولة، بطلة الحكايات وقصص الخيال، شفتاها إحداهما في الأرض والأخرى في السماء، تهتزان مع كل خطوة تخطوها».
سيرة المرأة الأسطورة و«الجمال القلق»
«كنت أحس دوماً أنني جميلة، إلا إنه نوع قلق من الجمال لم يكن كافياً بحد ذاته. فالجمال يمكن أن يتحول عيباً إذا ما علقت أهمية كبيرة جداً عليه.
شوقي بزيع ا
TT
20
«كنت أحس دوماً أنني جميلة، إلا إنه نوع قلق من الجمال لم يكن كافياً بحد ذاته. فالجمال يمكن أن يتحول عيباً إذا ما علقت أهمية كبيرة جداً عليه. إنه يجعلك تحلق أعلى، ثم بغتة يدعك وشأنك فتتشقلب. إلا إن السحر هو هبة طبيعية في حقيقة الأمر. إنه شيء غامض بخلاف الجمال الجسدي، وله حسنة أنه لا يذوي مع تقدم العمر».
ليس هذا النص الذي ورد في مذكرات الممثلة الإيطالية صوفيا لورين، هو النموذج الوحيد الذي يمكن الاستشهاد به للدلالة على ما تمتلكه نجمة هوليوود الشهيرة من ثقافة واسعة، وما تختزنه في داخلها من وعي عميق بالحياة، ولكنني اخترت الاستشهاد به في مقدمة هذه المقالة؛ لأنه لا يقارب مفهوم الجمال من الزاوية التي تتعدى محدودية الشكل وأعراضه الزائلة فحسب، بل إنه يعكس في الوقت ذاته تجربة لورين نفسها، حيث الجمال ليس معطى ناجزاً لحامليه، بل هو اختراعهم اليومي والاستحقاق الصعب الذي يجب أن ندفع أبهظ الأثمان من أجل المحافظة عليه.
ولعل أكثر ما يستوقفنا في كتاب لورين، الذي نقله إلى العربية الكاتب والمترجم العراقي علي عبد الأمير صالح، هو قدرة المؤلفة على الجمع بين الصدق التعبيري والسرد الحكائي الممتع الذي يجعل من العمل شبيهاً بشريط سينمائي بالغ التشويق. كما تركز بطلة «امرأة النهر» على أن ما بلغته من نجومية لم يكن ليحجب بأي حال ذلك الجرح العاطفي التأسيسي الذي حفره في داخلها غياب الأب، ولم يعرف طريقه إلى الاندمال. أما الجانب الآخر من معاناة صوفيا، فكان متصلاً بالوضع المادي المتواضع الذي كانت واجهته العائلة في حقبة طفولتها المبكرة. ورغم أن جدَّي الطفلة وأمها قد بذلوا ما في وسعهم لكي يوفروا لها الحدود الدنيا من مستلزمات العيش الكريم، فإن ذلك لم يمنعها من القول فيما بعد: «الجوع هو الموضوع الرئيسي في طفولتي». وهي تشير في الكتاب إلى نحولها الشديد الذي جعل كثيرين يلقبونها «عود نبش الأسنان»، كما تتحدث بإسهاب عما عانته عائلتها في سنوات الحرب العالمية الثانية التي خرجت منها إيطاليا مهزومة ومحطمة، لتضيف ما حرفيته: «مع مرور الوقت لم يعد بحوزتنا مال ولا إمدادات، ولم تكن لدينا كسرة خبز واحدة لنأكلها».
غلاف المذكرات
وإذا كان تزمت جدي لورين هو الذي حرم أمها الجميلة من الوصول إلى هوليوود، فإن الأم المتنورة قد وجدت في دعمها الابنة فرصتها الملائمة للتعويض عما تم حرمانها منه، حيث لم تكد الأخيرة تفوز في إحدى مسابقات الأداء حتى غادرت العائلة إلى روما، لتتصدر صوفيا لازارو غلافات «الرومانسيات الفوتوغرافية»، التي يسرت لها سبل الانتقال من «بطة صغيرة قبيحة إلى بجعة جميلة»، وفق قولها الحرفي، وقبل أن توفر لها الأقدار طوالع أكثر إيجابية من ذي قبل.
أما النقلة الأهم في حياة صوفيا فتمثلت في تعرفها عام 1950، في أثناء اشتراكها في مسابقة «ملكة جمال إيطاليا»، إلى المنتج الإيطالي كارلو بونتي الذي كان عضواً في لجنة التحكيم. ورغم أن اللجنة اكتفت بمنحها لقب «ملكة جمال الأناقة»، فإن سحر المتسابقة السمراء ذات القوام الممشوق، ترك تأثيره البالغ على الرجل الذي سبق له أن اكتشف جينا لولو بريجيدا ولوسيا بوسي… وأخريات. وإذ أسند كارلو إلى صوفيا أدواراً بسيطة في بداية الأمر، فإنه لم يلبث أن توسط لدى صديقه المنتج غوفريدو لومباردو لكي يمنحها فرصتها الملائمة للانطلاق. ولم يكتف لومباردو بإسناد دور رئيسي إلى لورين في فيلمه «أفريقيا تحت البحار»، بل اقترح عليها اسمها الفني صوفيا لورين، الذي سيلازمها بعد ذلك على طريق الشهرة والمجد.
أما المخرج الإيطالي فيتوريو دي سيكا الذي آمن بموهبة لورين العالية عادّاً أنها تملك في داخلها كل مستلزمات العودة إلى ينابيعها الطفولية الأولية، فقد أسند إليها دوراً شديد الخصوصية في «فتيات البيتزا»، محرضاً إياها في الوقت ذاته على التمثيل «بكل أحاسيسها، وبرأسها وجلدها وأحشائها وقلبها وذكرياتها». ولم تخيب صوفيا ظن دي سيكا بها، فتقمصت روحية فتاة البيتزا وشكلها وحركاتها مندفعة برأس مرفوع وبتوثبٍ محموم نحو حقول الحياة المَوّارة بالأحلام، لتكر بعد ذلك سبحة الأفلام العظيمة والمتنوعة التي لعبت في معظمها دور البطولة.
ولم تكن أهمية الكتاب مرتبطة بالجانب الشخصي من سيرة المؤلفة فحسب؛ بل بحرصها الشديد على تقديم صورة بانورامية عن عصر السينما الذهبي، دون أن تتوانى عن إظهار الجوانب السلبية لعالم هوليوود الحافل بالمكائد والمنافسات غير الشريفة. لكنها تحرص في المقابل على إظهار الجوانب المضيئة لذلك المسرح المفتوح الذي يتنافس فوقه مبدعون خلاقون يتقاسمون الابتهاج بالظفر، ويشد بعضهم أزر بعض في أوقات الشدة.
كما تتحدث لورين بإسهاب عن المطبات التي سبقت زواجها من كارلو بونتي، لا بسبب فارق العمر الذي يتجاوز العقدين فحسب؛ بل بسبب التعقيدات التي واجهت طلب طلاقه من زوجته الأولى التي أنجبت منه طفلين اثنين، بما دفع المحاكم الإيطالية إلى اعتبار زواج الثنائي العاشق نوعاً من الزنا، وأجبرهما على مغادرة البلاد لسنوات عدة، قبل أن يُزج بصوفيا في السجن لشهر كامل لدى إصرارها على العودة إلى بلادها. إلا إن تجربة السجن على مرارتها، هي التي وفرت لها السانحة الملائمة لاكتشاف موهبتها الأدبية وصولاً إلى كتابة هذه المذكرات. ومع إقرار صوفيا باللحظات الصعبة التي شهدها زواجها من بونتي، كصفعه إياها بقسوة بسبب غيرته من غاري غرانت، إلا إن تلك العلاقة، وخلافاً لمعظم العلاقات الزوجية المماثلة بين الفنانين، استطاعت أن تصمد بثبات لعقود عدة، قبل أن يسدل موت بونتي عام 2007 الستار على فصلها الختامي.
ليست أهمية المذكرات مرتبطة بالجانب الشخصي من سيرة المؤلفة فحسب؛ بل أيضاً بحرصها الشديد على تقديم صورة بانورامية عن عصر السينما الذهبي
ومع ذلك، ورغم حرص لورين على تقديم نفسها للقارئ بقدر وافر من الجرأة والصدق، فإن المرء يشعر بأن جزءاً من السيرة قد جرى إخفاؤه والسكوت عنه، خصوصاً في الجانب العاطفي منها. وإذا كان أحد الأسباب هو تكوين صوفيا الخفر وما يحمله الإيطاليون من بعض السمات المشرقية المحافظة، فإن السبب الآخر هو، على الأرجح، عدم رغبة صوفيا في جرح مشاعر زوجها الغيور، وولديها اللذين حرصت دائماً على أن تلتزم تجاههما بصورة الأم الطافحة بالحنان والحب. ومع أن سياق السيرة يشير إلى علاقة الصداقة والإعجاب التي ربطت بين صوفيا وكل من فيلليني وهيتشكوك وشارلي شابلن وريتشارد بيرتون وعمر الشريف، أو إلى مشاعر الجفاء وعدم الارتياح التي خصت بها كلاً من غاري غرانت ومارلون براندو، فإن القراءة بين السطور تقدم إشارات دالة على أن ما ربطها بمارسيللو ماستروياني كان أمراً يتجاوز الصداقة إلى العشق والحب، وهو الذي كتبت في رثائه عند رحيله: «لم أشأ أن يختلط وجعي بأوجاع الآخرين. في يوم جنازته بعثت حشداً من أزهار الأوركيد الأرجوانية الفاتحة، فربما ترافقه نضارتها في رحلته، وتهبه الحب الذي سأضمره له إلى الأبد». والأمر نفسه ينسحب على غريغوري بك، الذي ربطتها به؛ في أغلب الظن، علاقة حميمة، بعد أن شاطرته البطولة في فيلم «أرابيسك»، حتى إذا التقته فجأة بعد سنوات من الانقطاع، كتبت بلا مواربة: «كان هناك واقفاً قبالتي كما لو أن لحظة واحدة تحولت إلى أبدية. في نظرته المدهشة، في التلعثم الطفيف الذي أظهره، لمحت عالماً من الأشياء التي كان يود الإفصاح عنها، إلا إنه لم يفعل؛ ولن يفعل أبداً».
وإذا كان الإقرار بنجومية صوفيا لورين وبأنها، إلى جانب غريتا غاربو، مثل مارلين مونرو وبريجيت باردو وأخريات، قد دمغت بجاذبيتها الأنثوية وحضورها الآسر عصراً بكامله، فإن الدلالة الأهم لكتاب مذكراتها لا تنحصر في امتلاكها ناصية السرد فحسب؛ بل في ثقافتها الواسعة وقدرتها الفائقة على التوفيق بين المرأة المتفجرة أنوثة والزوجة المتفهمة والمترعة بالحنان الأمومي. ولعل أفضل ما أختم به هذه المقالة هو ما وصفها به روبرتو بينيني في احتفال تكريمها في هوليوود عام 2011، حيث قال: «عندما أسمع اسم صوفيا لورين أقفز، وأقفز ثانية؛ لأنه انفجار الحياة… إنها إيطاليا، بقدر ما هي إيطالية بامتياز. وحين تتحرك أو تمشي، نشعر بأن إيطاليا بأسرها هي التي تمشي».