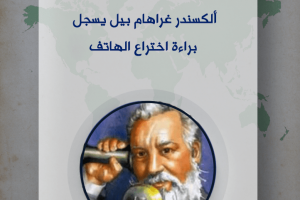طوال أكثر من سبعة عقود اعتدنا في كل عام إحياء ذكرى النكبة (15 أيار/مايو)، في حين أن تلك النكبة ما زالت تتناسل، أو ما زال الواقع يعيد إنتاجها، فلسطينياً وعربياً، في تدهور الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، في العالم العربي.
هكذا فإن الحدث الثاني المؤسّس لإسرائيل (أي حرب حزيران/يونيو 1967) أطلق عليه اسم النكسة، كأن هذا الاسم المراوغ والملتبس، يغطّي أو يحجب أو يخفّف وقع نكبة أخرى، كانت أطاحت بمكانة وادعاءات عديد من الأنظمة العربية مرة واحدة. أيضاً ماذا يمكن أن نسمي تدهور أوضاع العراق، بعد الغزو الأمريكي (2003)، وبعد هيمنة إيران عليه؟ وماذا عن التصدع الدولتي والمجتمعي، في بلدان المشرق العربي، لاسيما سوريا والعراق؟ وماذا عن ضعف قيام الدولة في العالم العربي، وتعثر إيجاد نوع من التكامل أو التعاضد بين الوحدات التي تشكل النظام العربي، إلى الحد الذي أضحت به الجامعة العربية كياناً فائضاً عن الحاجة أو مجرد ديكور؟
ثمة فكرتان مؤسستان هنا: الأولى أن ثمة نكبات جديدة، ربما أكثر هولاً وعمقاً وتخريباً من النكبة الأولى. والثانية أن إدراك معنى النكبة الأولى، التي ما زالت تعيد إنتاج نفسها، يمكن أن يعزز إدراكاتنا لآلية تجدد واقع النكبة، وتجاوزها.
ولعل الذكرى 72 لإقامة، وليس قيام، إسرائيل يمكن أن تشكل مناسبة لذلك. فتلك الدولة لم تنشأ، كغيرها من الدول، أي بنتيجة التطوّر التاريخي الطبيعي، في المجتمع والاقتصاد والثقافة والسياسة، إذ إن الحركة الصهيونية، التي كانت بمثابة جنين لهذه الدولة، نشأت أصلاً قبل وجود مجتمعها الخاص وخارج إقليمها الجغرافي المفترض!
وكانت المنظمة الصهيونية العالمية استطاعت إقامة إسرائيل بعد نصف قرن بالضبط على إنشائها (1897)، ولو أنها أتت على شكل مشروع، وبطريقة مصطنعة، ومن نقطة الصفر في العلاقة مع البلاد، وذلك بفضل تنظيمها وإدارتها وتفوّق نخبها والفكرة التي أطلقتها عند اليهود، رغم زيفها ولا مشروعيتها، وأيضاً بفضل دعم القوى الاستعمارية لها.
اللافت أن تلك الدولة التي بدأت من نقطة الصفر، كمشروع سياسي واقتصادي ووظيفي، وكمجرد دولة مصطنعة، استطاعت أن تحقّق نجاحات نوعية وكبيرة بالقياس مع البلدان المحيطة بها، رغم مساحتها المحدودة وقلّة عدد سكانها وندرة مواردها الطبيعية، وأيضاً رغم الحروب التي خاضتها ورغم وجودها في بيئة معادية لها.
وحقاً إنها لمفارقة، فالدولة، التي لا نعترف بها، أو نعتبرها بمثابة دولة مشروع، أو دولة مصطنعة (وهي كذلك)، تبدو أكثر قوّة وتلاحماً واستقراراً من كثير من دول المنطقة، رغم إنها تشكّلت من مهاجرين/مستوطنين قدموا من بلدان وثقافات وهويات عديدة، ورغم أن المستوطنين فيها لا جامع بينهم لا لغوي ولا تاريخي ولا سياق اجتماعي أو سياسي، وأن ما حصل فيما بعد نتيجة جهود تلك الدولة، التي أقيمت، وشكلت ما يسمى وتقة الصهر لليهود القادمين المستوطنين.
العامل الأول، الذي يميز، أو يقوّي، إسرائيل المصطنعة واللاشرعية لا يتأتى من تفوّقها فقط من قوتها العسكرية، أو من العلاقات الوطيدة التي تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي، إذ هو يتأتى أيضاً من طبيعة نظامها السياسي، المتأسّس على الديمقراطية الليبرالية، نسبة لمواطنيها من اليهود، والذي يضمن لهم المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتنظيم، وحل خلافاتهم وتبايناتهم وتحديد أولوياتهم في مؤسسات شرعية، وبالوسائل القانونية والسلمية، وعبر الاحتكام لصندوق الاقتراع، هذا عامل أول.
العامل الثاني، الذي مكّن إسرائيل يتمثّل في النظرة إلى الفرد (اليهودي) باعتباره قيمة عليا، ما يترتّب عليه إتاحة تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، وإعلاء شأن التعليم وتنمية الموارد البشرية والاستمرار بتأهيل الأفراد في السياسة والاقتصاد والثقافة والفنون والعلوم والتكنولوجيا. هذا ما يعكس نفسه جلياً في عدد الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث والدراسات والمحاضرات والندوات والصحف ودور النشر وغير ذلك.
أما العامل الثالث، الذي ضمن لإسرائيل استقرارها وتطورها وتفوّقها، فيتمثّل في توافق كل التيارات والكيانات السياسية فيها على عدم استفراد طرف بفرض أجندته ورؤيته على الدولة والمجتمع من دون وجود إجماع مناسب.
في كل ذلك فقد نجحت إسرائيل المصطنعة، والمشروع، في إقامة الدولة والمجتمع والمواطن/الفرد، وهو ما أخفقت فيه معظم البلدان الشرق أوسطية، والتي تغوّلت فيها السلطة على الدولة، وفتّتت المجتمع، وهمّشت الفرد، ما يفسّر تفوّق إسرائيل واستقرارها وتقدمها في مجالات التنمية الاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا ونمط الحياة.
والحال، وعلى رغم أن الدول العربية تقوم على مساحات واسعة، وتحوز موارد طبيعية هائلة، وفيها كتلة بشرية كبيرة، فإن إسرائيل المحدودة والصغيرة، بات ناتجها السنوي 300 مليار دولار (2019)، وبات متوسط دخل الفرد فيها 43 ألف دولار في السنة (2019)، وهي من الدول الأولى في الإنفاق على البحث العلمي، ومن أهم مراكز صناعة “الهاي تيك”، علماً أنها تستدعي رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، وهو الشخص الذي قضى في منصبه أكثر من أي رئيس وزراء آخر، بمن فيهم بن جوريون، للمثول أمام القضاء للمساءلة والمحاكمة، لتهم فساد واستغلال السلطة ورشى تقدر بـ200 ألف دولار.
طبعاً، المقصد هنا تصوير الواقع، وإدراكه، ومع ذلك فلا يعني ذلك أن صورة إسرائيل وردية، حتى للإسرائيليين أنفسهم، فتلك تعيش في خضم تناقضات ومشكلات وتشقّقات وتصدّعات جمة قد تقوّض وجودها. فإسرائيل لم ترسّم حدودها الجغرافية بعد، وتفتقد إلى دستور، وهي في حيرة بحدودها البشرية، بين كونها دولة لليهود الإسرائيليين فيها أم ليهود العالم. فوق ذلك فهي دائماً في مواجهة أسئلة من نوع، هل هي دولة ديمقراطية لمواطنيها أم هي دولة يهودية وعنصرية (إزاء أهل الأرض الأصليين/”الأغيار”)؟ أهي دولة علمانية أم دينية؟ هل هي لليهود الشرقيين أم للغربيين أم لليهود الروس؟ هل هي جزء من الشرق الأوسط أم امتداد للغرب في المنطقة؟ هل هي دولة عادية تخضع للمواثيق والقرارات الدولية، أم فوق كل ذلك؟ أيضاً، إلى متى ستعيش هذه الدولة على تغطية الولايات المتحدة لسياساتها؟ وإلى متى ستتغذى أو تتغطى من “المحرقة” لاستدرار التعاطف معها؟ وأخيراً ماذا في شأن الفلسطينيين من مواطنيها وفي الأراضي المحتلة؟ وإلى متى يمكنها العيش مع كونها دولة ثنائية القومية ومع كونها دولة استعمارية وعنصرية؟
ثمة أسئلة كثيرة يمكن طرحها على الواقع الإسرائيلي، لكن ثمة مشكلتان هنا: الأولى أن الواقع العربي غاية في التدهور بالقياس لوضع إسرائيل المستقرة والتي تتطور اقتصادياً. والثانية أنه مهما كان وضع إسرائيل سيئاً فلا توجد حالة في العالم العربي يمكن أن تستثمر في تناقضات إسرائيل أو تشتغل على تعزيز أوراق ضعفها.