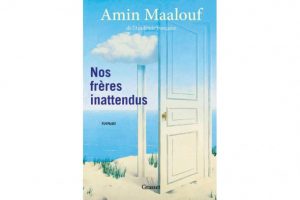تقول لويز غليك التي فازت بجائزة «نوبل» في الأدب: «أفترض أن كفاحي ومباهجي ليست فريدة من نوعها. لا يهمني أن أجعل الضوء يسلط عليَّ وعلى حياتي بحد ذاتها، وإنما أن يسلط على كفاحي ومباهجي، على البشر الذين يولدون ثم يجبرون على الخروج».
«أنا امرأة اجتماعية جداً. حقيقة أنني أكره الحوارات الصحافية لا تعني أنني منعزلة»: ذلك ما قالته لويس غليك في بداية حوارنا.
وُضعت غليك في موضع غير مريح. فازت بجائزة «نوبل» للأدب صباح الخميس، فاصطف الصحافيون في الشارع أمام بيتها في كيمبرغ، ماساشوستس. لم يتوقف هاتفها عن الرنين من 7 صباحاً؛ هجمة من الاهتمام وصفته بأنه «كابوسي».
يفترض الآن أن تكون غليك معتادة على الإشادة. في مسيرة تجاوزت الخمسة عقود، نشرت اثنتي عشرة مجموعة شعرية وحصلت على كل الجوائز الأدبية تقريباً: «جائزة الكتاب الوطني»، و«جائزة البوليتزر»، و«جائزة مجموعة نقاد الكتاب الوطنية» و«ميدالية الإنسانيات»، وغيرها.
يقول صديقها ومحرر أعمالها منذ فترة طويلة، جوناثان غالاسي، رئيس دار «فارار، ستروس وجيرو»: «أعمالها مثل حديث داخلي. ربما تحدث نفسها، أو ربما تحدثنا. ثمة مفارقة في ذلك. شيء واحد ثابت في أعمالها هو ذلك الصوت الداخلي. إنها تقيّم التجربة باستمرار في مقابل مثال ما لا تستطيع التجربة مساواته».
كانت الأشهر الأخيرة مرهقة لغليك، التي تعيش لوحدها بعد الطلاق، وكانت قبل الجائحة معتادة على تناول العشاء خارج البيت مع أصدقائها ست ليال في الأسبوع. كانت لعدة أشهر أثناء الربيع تبذل جهداً كبيراً لكي تكتب. ثم في نهاية هذا الصيف بدأت تكتب القصائد مرة أخرى، وأنهت مجموعة جديدة عنوانها «وصفات شتائية من المجموع» التي تخطط دار «فارار وجيرو» لإصدارها العام المقبل.
تقول هي: «الأمل هو أنك إن اجتزت الشتاء حياً فستجد فناً على الجهة المقابلة».
> كيف سمعت الخبر؟
– جاءني اتصال هذا الصباح حوالي السابعة إلا ربعاً. كنت قد صحوت للتو. عرّف رجل نفسه بأنه سكرتير الأكاديمية السويدية، وقال: «إنني أتصل لأخبرك أنك فزت بجائزة نوبل». لا أذكر ما الذي قلت، لكن كان فيما قلت شيء من الشك.
أعتقد أنني لم أكن مهيئة.
> كيف كان شعورك حين استوعبت أن الأمر حقيقي؟
– في غاية الدهشة أنهم اختاروا شاعرة غنائية أميركية بيضاء. كان من غير المعقول. الآن شارعي مغطى بالصحافيين. ويخبرني الناس كم أنا متواضعة. لكني فكرت بأنني أنتمي لبلد ليس محبوباً هذه الأيام، وأنني بيضاء، وأننا حصلنا على كل الجوائز. ولذا فقد بدا أن من المستبعد جداً أن حدثاً مثل هذا يمكن أن أضطر للتعامل معه في حياتي.
> كيف كانت حياتك في هذه الأشهر المتوترة والعازلة أثناء الجائحة؟ هل كنت قادرة على الكتابة؟
– لا بد لي أن أكتب لكن على غير انتظام، ولذا فهي ليست التزاماً ثابتاً. أعمل على كتاب منذ أربع سنوات، وقد عذبني. لكني فجأة في نهاية يوليو (تموز) وأغسطس (آب) كتبت بعض القصائد، وفجأة رأيت كيف يمكنني تشكيل هذه الخطاطة والانتهاء منها. كانت معجزة. الشعور بالفرح الغامر والراحة لم يستمرا بسبب «كوفيد»، لأنه كان عليّ أن أدخل في معركة مع رعبي اليومي والقيود الضرورية على حياتي اليومية.
> ما هو محور المجموعة الجديدة؟
– التشظي. ثمة انتحاب كثير في الكتاب. وفيه أيضاً الكثير من الكوميديا، والقصائد سوريالية بكثافة. كنت أكتب عن الموت منذ استطعت الكتابة. على وجه التحديد منذ كنت في العاشرة وأنا أكتب عن الموت. صحيح أنني كنت فتاة حيوية. الشيخوخة أكثر تعقيداً. وليس الأمر أنك ببساطة أقرب إلى موتك، إنها قدراتك العقلية التي تعتمد عليها – تناسقك الجسدي وقوتك ونباهتك الذهنية – هذه أشياء تتعرض للخلل أو التهديد. إنه موضوع من الطرافة التفكير فيه والكتابة عنه.
> يتكئ الكثير من أعمالك على الميثولوجيا الكلاسيكية، وينسج نماذج أسطورية عليا مع أشعار معاصرة حميمة حول الترابط والصلات العائلية. ما الذي يجتذبك نحو تلك الشخوص الأسطورية، وكيف تثري تلك الحكايات ما تسعين للتعبير عنه وتوصيله عبر شعرك؟
– كل من يكتب يستمد قوته ووقوده من أكثر الذكريات قدماً، ومن الأشياء التي غيرتك أو لمستك أو أثارتك في طفولتك. قرأ والداي عليّ برؤيتهما العميقة الأساطير الإغريقية، وحين استطعت القراءة بنفسي واصلت قراءتها. شخوص الآلهة والأبطال كانت أكثر حيويةً بالنسبة لي مما كانت للأطفال الصغار الآخرين في الحي في «لونغ آيلاند». ولم يكن الأمر كما لو أنني أتكئ على شيء تملكته في مرحلة متأخرة من حياتي لإضفاء نوع من التلميع المعرفي لأعمالي. كانت هذه هي حكايات النوم في صغري.
ومن تلك الحكايات ما استمر يرن في الذاكرة، لا سيما حكاية «بيرسيفوني»، وقد أمضيت حوالي خمسين عاماً أكتب عنها من وقت لآخر. وأظنني إلى حد كبير متورطة في صراع مع أمي، كما هن الفتيات الطموحات غالباً. أظن أن تلك الأسطورة بصفة خاصة هي التي منحت تلك الصراعات وجهاً جديداً. لا أعني أنها كانت مفيدة في حياتي اليومية. حين كتبت كان يمكنني أن أشكو «ديميتر» بدلاً من أن أشكو أمي.
> قارن البعض بين أعمالك وأعمال سيلفيا بلاث، ووصفوا شعرك بأنه اعترافي وحميم. إلى أي حد اعتمدت على تجربتك الخاصة في أعمالك، وإلى أي حد تستكشفين الموضوعات الإنسانية الكونية؟
– إنك تعتمد على تجربتك الخاصة دائماً لأنها مادة حياتك، ابتداءً بطفولتك. ولكني أبحث عن تجارب النماذج العليا، وأفترض أن صراعاتي ومباهجي ليست فريدة من نوعها. تبدو فريدة حين تعيشها، لكني لست حريصة على جذب الأضواء إلى نفسي وحياتي الخاصة، وإنما إلى صراعات ومباهج البشر، أولئك الذين يولدون ثم يجبرون على الخروج. أظنني أكتب عن قابليتي للفناء لأن من الصدمات المزعجة في الطفولة أن تكتشف أنك لن تمتلك هذا إلى الأبد.
> لقد جربتِ أشكالاً مختلفة أثناء مسيرتك، مع أن صوتك ظل مميزاً. هل كانت تلك محاولة متعمدة وواعية لدفع نفسك بتجريب عدة أشكال؟
– نعم، طوال الوقت. إنك تكتب لكي تكون مغامراً. أود أن أُحمل إلى أماكن لا أعرف عنها شيئاً. أود أن أكون غريبة في المكان. من الأشياء الطيبة القليلة التي يمكن قولها عن الشيخوخة أنك تعيش تجربة جديدة. ليس الانكماش البهجة المتوقعة لدى كل إنسان، لكن ثمة ما يقال عن هذه الحال. وذلك ثمين لشاعر أو كاتب. أعتقد أن عليك دائماً أن تندهش وأن تبدأ من جديد، على نحو ما، وإلا فسأصاب بالملل إلى حد البكاء. وقد مررت بأوقات ظننت أنني كتبت تلك القصيدة. إنها قصيدة جميلة، ولكنك كتبتها من قبل.
> ما هي الطرق التي تشعرين أن الشيخوخة قادتك بها إلى استكشاف مناطق جديدة؟
– تكتشف أنك فقدت اسماً (لغوياً) في مكان ما، وجملتك تنمي هذه الفجوات الواسعة في المنتصف، وأنت إما عليك أن تعيد بناء الجملة أو تتخلى عنها. لكن الأهم هو أنك ترى ذلك وأنه لم يحدث من قبل. ومع أن ذلك كئيب ومزعج ويعد بالأسوأ، فإنه على الرغم من ذلك، من زاوية الفنان، مثير وجديد.
> لقد وُصف أسلوبك غالباً بأنه متقشف ومشذب. هل ذلك الصوت الذي يأتي إليك أثناء الكتابة طبيعي، أم أنه شيء طورته وصقلته؟
– هو مشذب أحياناً، نعم. أحياناً أكتب على نحو حواري. إنك لا تصنع صوتاً. تجد الجملة طريقة للتحدث بنفسها. ويبدو هذا قريباً من نبوآت ديلفاي (في الأسطورة اليونانية). إنه أمر تصعب مناقشته، هو صوت. وأظنني مفتونة ببنية الجملة وأشعر دائماً بقوتها، والقصائد التي أثرت في بقوة لم تكن الأكثر امتلاءً بالكلمات. كانوا شعراء مثل بليك وملتون، الذين كانت بنية جملهم مذهلة، طريقة توظيفهم لأماكن التركيز.
> تدرّسين في ييل وتحدثت عن كيف ساعدك التدريس على اجتياز صعوبات واجهتك في كتابتك أنت. كيف شكلك التدريس من حيث كونك كاتبة؟
– إنك غارق دائماً في غير المتوقع والجديد. عليك أن ترتب أفكارك لكي تستطيع أن تستخرج من طلابك ما يثيرهم. يدهشني طلابي. مع أنني لا أستطيع الكتابة دائماً، فبإمكاني قراءة ما يكتبه الآخرون.
> شكراً جزيلاً لوقتك. هل هناك ما تودين إضافته؟
– لو تأملت حقيقة أنني في البداية لم أرد قول شيء ثم قلت كل شيء، لا ليس هناك ما أود إضافته. معظم ما أود قوله مما له أهمية خاصة يخرج في القصائد، وما يتبقى ليس سوى تسلية.
– خدمة «نيويورك تايمز»
الى ذلك وتحت عنوان مرض أدبي اسمه الجوائز
كلما أعلن عن الفائز بجائزة نوبل، ارتفع الصراخ العربي، الذي قلما نسمعه في أي مكان من العالم، وكأن ظلماً عظيماً قد ألحق بنا. إننا نتوهم أن هناك أسماء عربية معينة مرشحة للجائزة، وتبقى في حالة ترقب قصوى، بل حالة حمى. وحين لا يتحقق هذا الوهم تتضاعف خيبتنا كل عام، وتنهال اتهاماتنا على الأكاديمية السويدية التي تناصب العداء لكل ما هو عربي. وكأننا، من حيث لا ندري، نريد اعترافاً بنا وبأدبنا، نابعاً من شعور يفضح نفسه، رغم كل قناع: شعور بالدونية لا ينتهي إلا باعتراف الآخر بنا. وربما لهذا السبب، تزدحم السير الذاتية لكتابنا بـ«ترجماتهم» إلى اللغات «العالمية» التي لا تعد، سعياً لاكتسب لقب «الكاتب العالمي»، وهو لقب لا يوجد في كل لغات الأرض، إلا في اللغة العربية. كم من كتابنا، إذا استثنينا نجيب محفوظ، قد ترجمت أعماله فعلاً إلى اللغات الأخرى، وخاصة الإنجليزية التي تعتمد عليها لجنة نوبل في خياراتها، ما عدا رواية أو اثنتين، وقصائد متفرقة هنا وهناك؟
جائزة نوبل، هي مثل أي جائزة أخرى، رغم صيتها المجلّل. صحيح، أنها قد تمثل نوعاً من الاعتراف بأهمية كاتب ما، ولكن ليس دائماً. فلقد منحت عبر تاريخها الطويل لكتاب سيئين، وهم كثر، كما تقول لويس غليك نفسها في الحوار المنشور معها في هذه الصفحة.
فالأكاديمية السويدية تبقى في النهاية مثل أي لجنة تحكيم أخرى، محكومة بذوق وتقديرات أعضائها، وثقافاتهم أيضاً. أحكامها ليست «أحكام قيمة»، وأعضاؤها ليسوا «آلهة الأولمب». ولو تغير أعضاؤها سنوياً، بل إن تستمر عضويتهم مدى الحياة، لتغيرت قوائم جوائزها إلى حدٍ كبير. ونحن نذكر أن الجائزة، التي تأسست عام 1910. لم تمنح لكاتب مثل ليو تولستوي، الذي ما زالت البشرية كلها، في الشرق والغرب، تواصل قراءته، بينما منحت آنذاك لكتاب انطفأوا مع الزمن ولم يعد أحد يقرأ لهم، أو حتى يذكرهم مثل رينه سولي برودوم وثيودور مومسن وبيور نسيتارنه بيورنسون وآخرين.
والحبل على الجرار. فلم يفز بها العملاق بورخيس، وهي لا تهمه أساساً. ولم تذهب، مثلاً، لشاعر عملاق مثل راينر ماريا ريلكه، ولا إلى روائي مثل جيمس جويس، الذي ما يزال منذ بداية القرن العشرين ولحد الآن مالئ الدنيا وشاغل الناس. كما لم تمنح مثلاً لأزرا باوند، عراب الشعر الحديث، وأستاذ تي. إس. إليوت، كما نالها عام 1995 شاعر مثل شيموس هيني، بسبب القضية الآيرلندية أساساً، وهو بكل المقاييس لا يرقى لمستوى معاصره تيد هيوز، ومعلمه أيضاً.
كم كانت حيية لويز غويك، حين لمحت أنها تشعر بالحرج لمنح الجائزة لـ«شاعرة بيضاء»، في زمن التمييز العنصري المتصاعد في بلدها، ولعل في ذهنها كانت الشاعرة الأميركية السوداء ريتا دوف، التي تتخطاها الجائزة منذ أعوام طويلة.
الكتّاب، كما كتبنا مرة، ليسوا خيولاً في حلبة سباق، أيهم يفوز فيه فهو الأفضل، وليست هناك منافسة، كما قال إليوت مرة، في مملكة الإبداع.
سألوا مرة الشاعر الفرنسي لويس أراغون في أواخر حياته، وهو من هو، لماذا لم يمنحوك جائزة نوبل لحد الآن، فأجاب ببساطة: لأن شعري لم يترجم إلى الإنجليزية!
خذوا الأمر ببساطة. لا تستحق الجوائز كل هذا النواح، حتى لو كانت جائزة نوبل!
ما يستحق البكاء عليه حقاً في الغرف المعتمة هو: الإبداع.
هذا ما يفعله كل المبدعين الحقيقيين عبر التاريخ سواء أفازوا بنوبل أم لا.